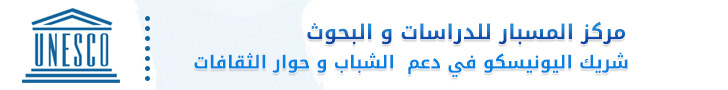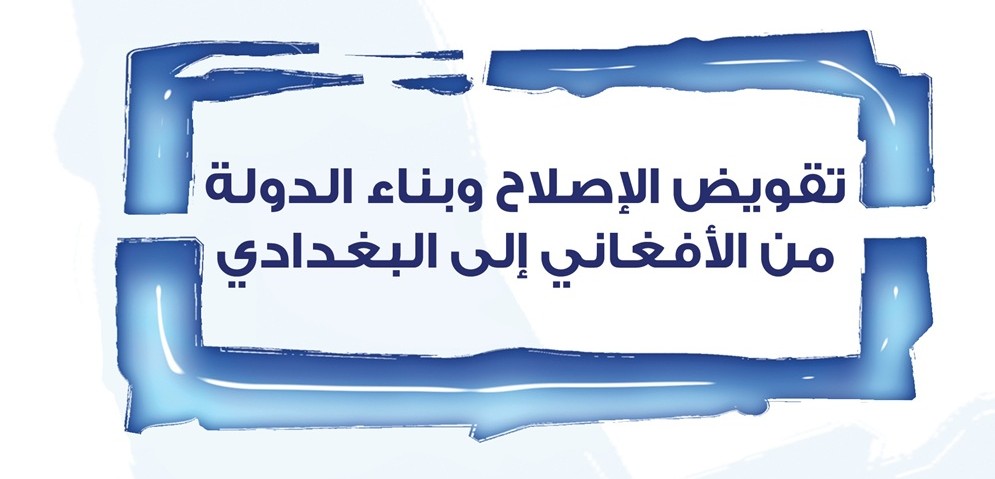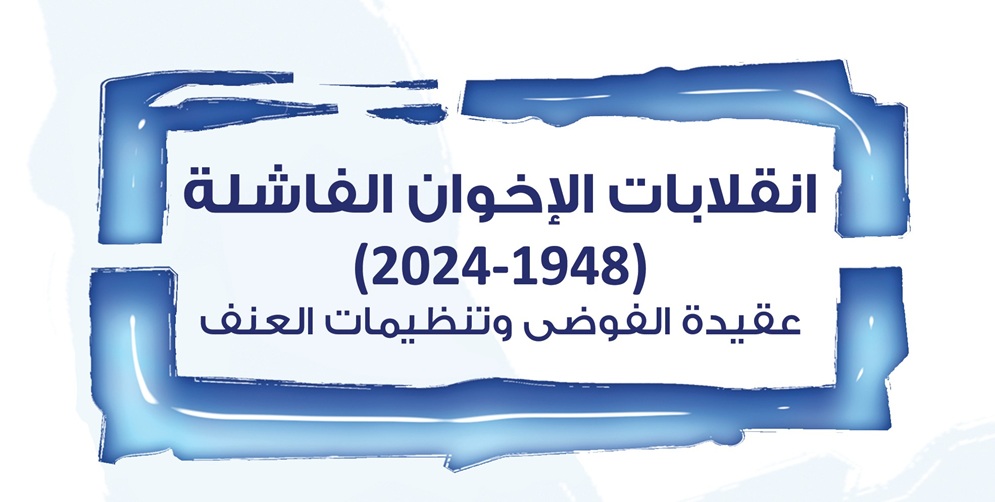تقديم
تقديم
يتناول مركز المسبار للدراسات والبحوث في كتابه «تقويض الإصلاح وبناء الدولة: من الأفغاني إلى البغدادي» (الكتاب العشرون بعد المئتين، أبريل (نيسان) 2025)؛ سجالات المفكرين العرب، حول تعثرات تأسيس الدولة، ومفاهيم معالجة الوعي الديني، من الإصلاح إلى التجديد، ويبدأ من لحظة محمد علي باشا (1769-1849) مؤسس الدولة الحديثة في مصر، وعهد حمودة باشا (1805–1814)، الذي حاول إنتاج صيغة تعالج التحديث المتدرّج. ويركز الكتاب على بروز الأفغاني، وتلاميذه، ودخول المعطى الثوري الحركي بسرّيته وغموضه لتغيير نهج الإصلاح، إلى لحظة ظهور الفكرة القومية، وتحولها إلى أحزاب متصارعة؛ على ضفاف تمددت فيها التيارات الإسلاموية؛ التي أعادت تعريف فكرة الإصلاح، ونسبتها لرموزها بأثر رجعي.
فاتحة دراسات الكتاب قدمها الباحث والأكاديمي خلدون النبواني تطرق فيها إلى ما يسميه «تداعيات الصدمة الحضارية» إثر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، زاعمًا أنها لحظة اكتشاف التفاوت الحضاري بين العرب وأوروبا. ثم قرأ إرهاصات الإصلاح في مصر انطلاقًا من تجربة محمد علي في بناء الدولة القوية القائمة على أساس غير قومي، والتي آلت إلى تبلور الوطنية المصرية في القرن التاسع عشر، وتأسيس الأحزاب الوطنية. يجزم الباحث بأن الوعي بالدولة مَتَح من متن مشروع محمد علي، الذي صنع جسرًا موصولاً بأوروبا؛ من خلال دعم الترجمة والطباعة والصحافة، وبعث رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873)؛ الذي نقل صورةً للفكر السياسي الفرنسي، وُظِّف ليعزز تطلعات النهضة، ويشكل الفكر القومي. يستعرض الكاتب تطور الفكر القومي العربي ويمر على التجربة الناصرية في مصر، التي يعالجها بنقد؛ ويتطرق إلى نشأة الفكر القومي في سوريا، وصولًا إلى تأسيس حزب البعث العربي وتوليه السلطة في كل من العراق وسوريا. ويبيّن كيف انتهت تلك المشاريع القومية إلى أنظمة شمولية، مسلطًا الضوء على خلل بنيوي صاحب فكر حزب البعث، تمثل في الارتهان لمن وصفهم بالعسكريين، مقابل معاداة الديمقراطية والنخب الأرستقراطية والمجتمع المدني في كل من مصر والعراق وسوريا.
تطرقت الباحثة والأكاديمية التونسية صبرين الجلاصي إلى الحركة الإصلاحية في تونس في القرن التاسع عشر، والتي بدأت في عهد حمودة باشا وأحمد باي، لا سيما قرار الأخير بإلغاء الرق عام 1846، وصولاً إلى الحماية الفرنسية عام 1881. بوَبت الدراسة للإجراءات على مرحلتين: الأولى ما قبل إعلان الحماية الفرنسية، والثانية في الفترة اللاحقة لها، وقد تجلى جانبها الإصلاحي في ورشة الإصلاح في جامع الزيتونة منذ عهد محمود قابادو (1812-1871). ثم تركز على النتائج المترتبة على عملية تحديث الدولة ومؤسساتها والمجتمع ومكوناته، والتي سمحت -إلى حد كبير- بتطوير وعي النخب التونسية بضرورة تبني هوية حديثة مدنية أكثر انفتاحًا.
بدوره ناقش الباحث المغربي محمد زكّاي في دراسته الكيفية التي شكل فيها جمال الدين الأفغاني (1838-1897)؛ بعدًا جديدًا مربكًا في خلط نقاش الإصلاح بالثورية السياسية وتخوين الحكام والسخط من العلماء التقليديين. حاول الأفغاني وتلاميذه استنساخ تجربة الحركة البروتستانتية المسيحية، في إطار بحثهم عن أدوات تنفيذ مماثلة؛ ووقعوا على الدرس العقائدي فاستعادوا تأويلات عقائدية أفضت إلى نتيجة عكسية، أكثر تشددًا، أدخلت العمل السياسي في صلب معطى الإيمان العقائدي، لا مجرد التسليم القلبي، أو العمل العام؛ بل انتهى إلى تخصيص سياسي يتبلور بعد سنوات لاحقة ليكون في أصول الاعتقاد بعد عقدين من رحيل الأفغاني.
ثمة آراء متشائمة ترى أنّ مصادر توثيق التحولات الفكرية في القرن الماضي، أخفت الجهود المؤسسية للدولة، ومحت دورها في بناء منهج الإصلاح الديني والدستوري والاجتماعي، وركزت هذه المصادر؛ التي تنتمي غالبًا إلى الحركات الإسلاموية، على جهود السياسيين التنظيميين؛ ورواد العمل السري، وأضافوه إلى هالاتهم، ما حرّف فكرة الإصلاح واسمه؛ ليكون ضمن حلقات إحيائية أصولية، تستغل التفكير لصالح تضخيم التنظيم، لا لغرض التنوير. بينما أتت آراء أقل تشاؤمًا؛ تزعم أنّ محاولة الأفغاني ومحمد عبده، انحرفت على يد رشيد رضا، وأدى السجال الحجاجي، إلى تحولها لمادة وظفتها الحركات الإسلاموية في تنظيماتها السياسية، وأما التيار المتفائل الذي يحرص على انتزاع الإصلاح من الإسلاموية، فيحرص على الفصل البات بينهما.
في ضوء هذا السجال، درس الباحث المصري كريم شفيق، محاولات الأفغاني وحراكه السياسي، التي تأثرت بمذاهب انشقاقية تاريخية من أديان شتى؛ لكنها عوضًا عن أن تؤدي إلى فكرة متسامحة، أفضت إلى حركة انشقاقية انغلاقية تنفي المجتمع والدولة وتكفرهما؛ فتقصى الباحث تأثيرات الأفغاني الفكرية والحركية؛ في فكر الحركيين الإسلامويين، بدءًا من البنا، مرورًا بسيد قطب ومنظري الجهادوية المقاتلة. يتناول الباحث ما يسميه مأزق الانسلاخ لدى الأفغاني، أي معضلته في التوفيق بين الحداثة والتراث وهويته بين الشرق والغرب. ويكشف كيف تحولت أحلامه الليبرالية إلى أيديولوجيا تراثية لدى البعض، حيث أُعيد توظيف التراث الإسلامي كإطار أيديولوجي جامد. وبهذا يوضح أن إرث الأفغاني كان مفصليًا ومزدوجًا، وأيًّا كانت منطلقاته فقد أفضت نتائجه إلى إنتاج أصوليات، ضيّقت تعريف المجتمع، ثم سعت لاستعادة الماضي على حساب التجديد العميق، ولمصلحتها السياسية الضيّقة.
بدوره حاول الباحث المصري سامح إسماعيل التفريق بين محمد عبده السياسي، ومحمد عبده الذي تعوّذ من ساس ويسوس، فأسس لفكرة تحولاته الفكرية زمنيًّا. يرى الباحث أن التجديد الذي طرحه عبده عبارة عن مقاربة معرفية سعت إلى التوفيق بين المفاهيم التراثية والواقع المعاصر، الذي تحرفه وتوظفه الحركات الإسلاموية ومنظروها.
كانت صورة الأفغاني، وصولاً إلى حسن البنا، وسيد قطب، صورةً رمزيّة، أكثر من كونها متصلة بالنصوص التي ينتجونها، وإصرار الإسلاموية على استحضارها، ظلّ باقيًّا وكثيفًا، والتقط الأديب المصري، نجيب محفوظ هذا الخيط، في لحظة تشكله، فأفرد في رواياته، الأدبية، ظاهرة تشكّل المثقف الذي يحاول المزج بين الإصلاح والتمدن والنضال والتكفير والبراغماتية السياسية، فكتب الباحث المصري، أحمد الشوربجي، لحضور طيف هذه الشخصيات في رواية نجيب محفوظ «القاهرة الجديدة» الصادرة عام 1945، وفيها قدّم نقدًا مستترًا وعميقًا للفكر الإخواني، والتقط بحسّ روائي ثاقب مسار تحوّل بعض المثقفين إلى التطرف الديني الذي يسوّق نفسه بأساليب نضالية، ولكنها تسقط في وحل السياسة، وتؤدي إلى صدام مع المجتمع وقيم التعددية. واستكمل البحث سامح فايز، الذي تناول حضور الشخصيات ذاتها، في رواية «المرايا» التي كتبت بعد ثلاثة عقود من القاهرة الجديدة، وفيها تتجلى الصدامات الرمزية، والتحولات الكاملة. يركّز فايز على شخصيات بعينها مثل الحاج زهران حسونة وعباس فوزي (الشيخ الذي يتحول إلى ملحد) وغيرها. كما يشير إلى أحداث مثل نكسة 1967 كنقطة تحول في السرد، حيث تعيد تلك الشخصيات النظر في قناعاتها، ولكنها تغلف ضعفها بالهالة السياسية والصوت العالي، وما تكتسبه من مشروعية، لا يعدو أن يكون حالةً عاطفية مرتبطة بالكفاح والنضال والمفاهيم التسخيطية أو الثورية.
واتساقًا مع سجالات الثمانينيات، تناولت الباحثة والأكاديمية اللبنانية نايلة أبي نادر مصطلح «أيديولوجيا الكفاح» في رؤية المفكر محمد أركون، وفيها تشير إلى أن هذه «الأيديولوجيا الكفاحية أصبحت لدى عددٍ من المفكرين العرب نوعًا من الذريعة التي تُستخدم من أجل تغطية الضعف المنهجي، وفقر المضمون المعرفي الذي يتمّ إنتاجه»، «مما أدى إلى تعطيل حركة الفكر والاستعادة النقدية للمشاكل العديدة التي بقيت في دائرة المستحيل التفكير فيه، أو اللامفكر فيه داخل الفكر العربي والإسلامي» بحسب وصف أركون، الذي سعى لتقديم قراءة وفيّة للدين، بأدوات حديثة، توظف الفلسفة والمناهج الجديدة في معالجة النصوص.
بدوره تناول الباحث والفيلسوف السعودي فهد الشقيران، العلاقة المعقدة بين الفكر الأصولي والفلسفة. مبرزًا حالة التحايل والتسخير المبتسر، فيدرس شخصيات جمعت بين النزعة الأصولية ومحاولة التنظير الفلسفي؛ ثم يوضح كيف تنظر التيارات الأصولية عمومًا بعين الشك إلى الفلسفة والفكر الحديث، إذ ترى فيه تهديدًا لقناعاتها المطلقة، مما أدى تاريخيًا إلى معاداة أي فكر تجديدي أو تأويلي. ومع ذلك، يشير الشقيران إلى عودة ظاهرية لـ«التفلسف الأصولي» في بعض الأوساط، حيث يحاول بعض منظّري التشدد تبني مصطلحات فلسفية أو إعادة قراءة تراثهم العقائدي بشكل عقلي – لكن غالبًا ضمن إطار مغلق يخدم أيديولوجيتهم. ويلمح إلى أن توظيف الفلسفة لم يغيّر من جوهر الفكر الأصولي الرافض للمغامرة العقلية الحرة، فهو يستخدمها بوصفها استراتيجية دفاعية أمام ضغط الحداثة.
بدورها قدمت الباحثة والأكاديمية التونسية ناجية الوريمي مقاربة نقدية حللت فيها البنى الفكرية العربية وأسباب التصاقها بالماضوية. تستعرض الوريمي خطاب رواد النهضة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، مبينةً كيف تشكّل وعي العرب بذاتهم في ظل الصدمة الحضارية مع الغرب؛ إذ سعى خطاب النهضة المبكر إلى إبراز مزايا الذات العربية والإسلامية في مواجهة التفوق العلمي والصناعي الغربي، مؤكدًا إمكانية اللحاق بالركب عبر الإصلاح والتعليم، لكنه في الوقت ذاته وقع أحيانًا في فخ مقارنة ذات/آخر مُبسّطة، تُظهر العربي فاضلًا متى تمسك بالجماعة المنظمة؛ في مقابل غرب مادي متفوق تقنيًا لكنه «منحل أخلاقيًا» بحسب ذلك الخطاب. تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى تحليل الخطاب العربي الحداثوي في النصف الثاني من القرن العشرين، وتناقش كيفية إعادة إنتاج وعي الذات والآخر ضمن سياق الدول الوطنية وخطابات القومية والتحديث. تشير الوريمي إلى أن كثيرًا من المفكرين العرب أعادوا إنتاج ثنائية التفوق والنقصان، فاعتبروا أن للذات العربية خصوصية حضارية وروحية تتفوق بها على الآخر الغربي، حتى مع تبنيهم مفاهيم حداثية في الظاهر. كما تتناول الدراسة ظاهرة «أسلمة» المفاهيم الحداثية، وترى الوريمي أن هذه المقاربات –على الرغم من نواياها التوفيقية– وفّرت أرضية خصبة لنمو الأصوليات الدينية؛ إذ استغل التيار الأصولي فكرة تفوق الذات المطلقة وشيطنة الآخر لتبرير انغلاقه ورفضه للقيم العالمية. وتخلص الدراسة إلى أن تطور خطاب الذات والآخر في الفكر العربي حمل معه إشكاليات مستمرة عطّلت اندماج الفكر العربي في الحداثة الكونية، وأن تجاوز هذه العقبة يستوجب تفكيك ثنائية «نحن مقابل هم» السائدة في الذهنية الثقافية، واستبدالها برؤية نقدية للذات منفتحة على الآخر الإنساني؛ باعتباره شريكًا في الحضارة الإنسانية لا نقيضًا مطلقًا.
ولاختبار هذا التكوين، اختتم الكتاب بقراءة، قدمها الباحث التونسي، أحمد نظيف لكتاب بالفرنسية عن تعليم الإسلام وتكوين المدربين المتعلمين عليها، يشرح حالة المعاهد الفرنسية، الخاصة، التي تُعنى بتكوين الأئمة والدعاة وتدريس العلوم الشرعية للمسلمين الفرنسيين خارج إطار التعليم الرسمي. يتناول الباحث ديناميات نشأة هذه المعاهد وأسباب ازدهارها، معتبرًا أنها جاءت لسد فراغ تركته المؤسسات الرسمية في تلبية حاجة الجاليات المسلمة إلى تعليم ديني منظم ومتاح. ويستعرض هيكلة هذه المعاهد ومناهجها، موضحًا كيف يتم «التكوين على الإسلام» فيها من حيث المحتوى التعليمي وأساليب التأطير، بالإضافة إلى الخلفيات المتنوعة لطلابها ومدرّسيها. تُبرز القراءة ازدواجية النظرة إلى هذه المعاهد: فهي من جهة تُساهم في تكوين أئمة مثقفين يفهمون السياق الفرنسي ويمكن أن يعززوا اندماج المسلمين، ومن جهة أخرى يُنظر إليها بحذر؛ تخوفًا من أن تكون بمعزل عن الرقابة فتخرّج أئمة يحملون رؤى منغلقة.
في الختام، يتوجه مركز المسبار للدراسات والبحوث بالشكر للباحثين المشاركين في الكتاب والعاملين على خروجه للنور، ويخصّ بالذكر كريم شفيق، منسق العدد، ونأمل أنْ يسد ثغرة في المكتبة العربية.
رئيس التحرير
عمر البشير الترابي
أبريل (نيسان) 2025