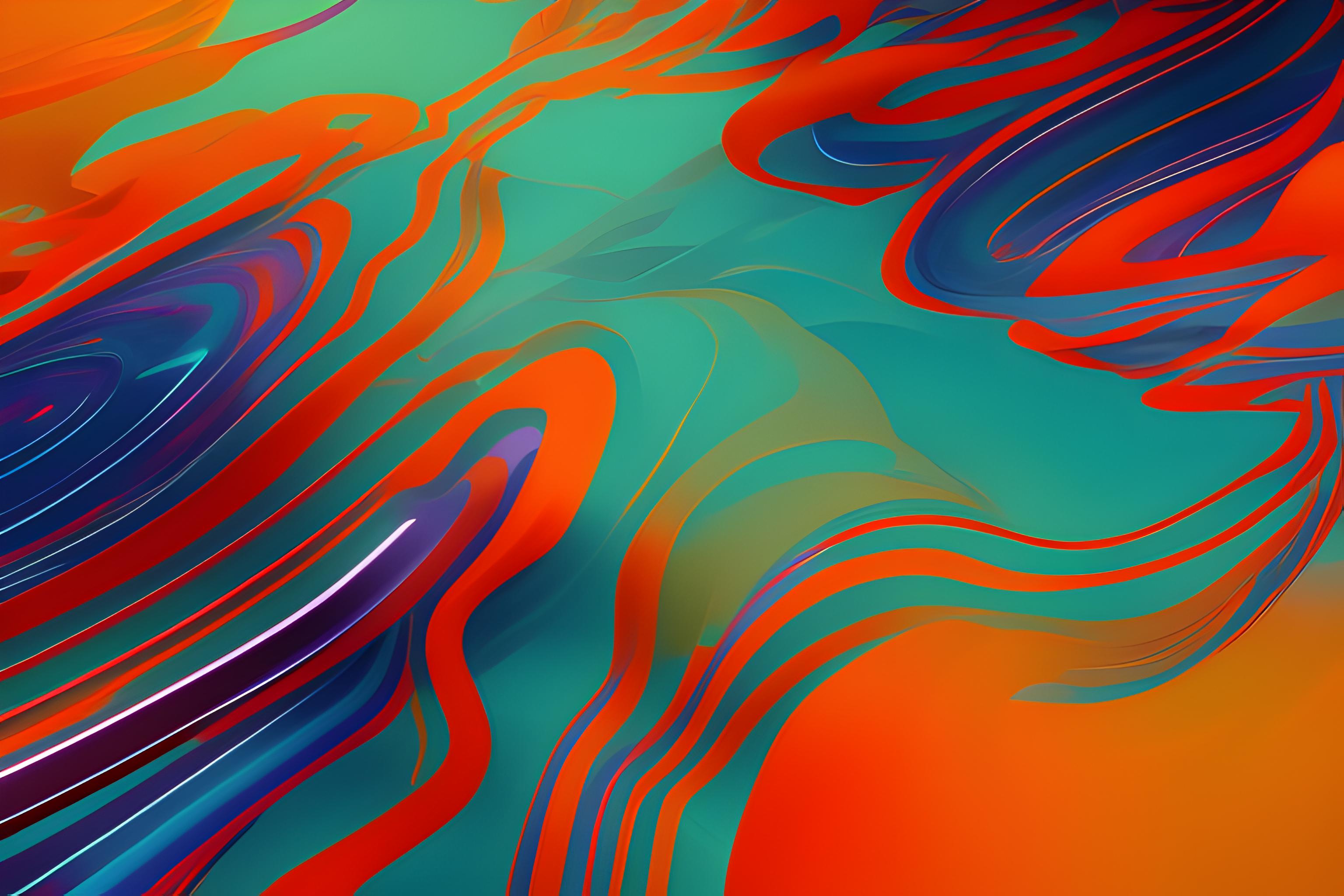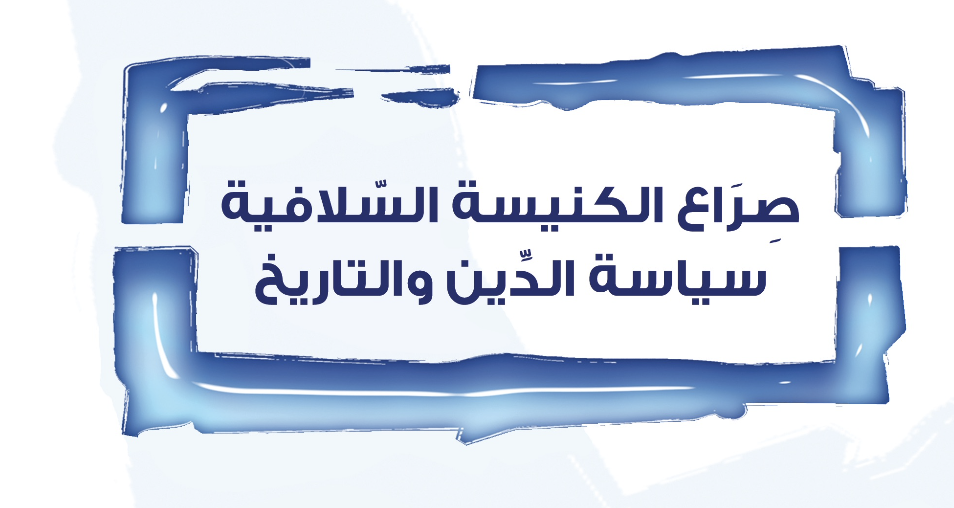دروس الحرب الأميركية في أفغانستان: نصوص مختارة [1]
تعرض هذه المادة اقتباسات مطولة من ثلاث مقالات لمتخصصين في الحرب الأميركية على الإرهاب في أفغانستان، نشرت في مجلة «فورين أفيرز» (Foreign Affairs) عام 2021، تعكس الاتجاه الجديد السائد في الولايات المتحدة في دراسات الإرهاب، الذي اتخذ مسارين: الأول: يزعم أن الحرب على الإرهاب استوفت دورها وشروطها، ولا بد من التوجه إلى الصين القوة العالمية الصاعدة للحد من نفوذها؛ والثاني: يروج لمقولة تعلم التعايش مع الإرهاب دون إدراك المخاطر. تقدم المادة عرضاً موجزاً لمقال رابع نشر عام 2010 في المجلة نفسها، تطرق إلى أبرز الإصدارات الإنجليزية حول أفغانستان التي غطت جزءاً مهماً من التقاطعات بين القبيلة والتمرد والإرهاب وهشاشة مركزية الدولة في الأنموذج الأفغاني، مما يساعد على فهم أعمق لما يجري اليوم.
أولاً: هم ونحن.. كيف تسمح أميركا لأعدائها باختطاف سياستها الخارجية؟[2]
رأى الكاتب الأميركي بين رودس (Ben Rhodes) أن الحرب على الإرهاب كانت أكبر مشروع في فترة الهيمنة الأميركية التي بدأت عندما انتهت الحرب الباردة، وهي الفترة التي وصلت الآن إلى مرحلة الأفول. على مدار عشرين عامًا، كانت مكافحة الإرهاب هي الأولوية الرئيسة لسياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. لقد أطر بوش لمكافحة الإرهاب كحرب تعريفية متعددة الأجيال، وشكلًا فعالًا للقيادة بعد مأساة وطنية غير مسبوقة، لكن هذا النهج أدى إلى تجاوزات وعواقب غير مقصودة؛ حيث سرعان ما أساءت الحكومة الأميركية استخدام سلطاتها في المراقبة والاحتجاز والاستجواب.
يشير رودس إلى أن:
«الانتصارات التي وعد بها بوش وإدارته -والتي تنبأت بها وسائل الإعلام المحافظة بلا هوادة- لم تتحقق أبدًا، مما أدى إلى إضعاف ثقة الأميركيين في الحكومة وإثارة البحث عن كبش فداء داخلي. لقد تحولت القومية الشوفينية في حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) مباشرةً إلى مزيج من الخوف وكراهية الأجانب، أدى في النهاية إلى ظهور الرئيس دونالد ترمب، الذي ألح بهذا الوضع للمناداة على إنهاء الحروب في الخارج، وأعاد توجيه خطاب الحرب على الإرهاب لمهاجمة مجموعة متغيرة من الأعداء الافتراضيين في الداخل. لدى الولايات المتحدة الآن رئيس أكثر التزامًا بصدق بإنهاء «الحروب الأبدية» في البلاد. يتضح تصميم الرئيس جو بايدن على القيام بذلك من خلال قراره بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، وبشكل أكثر وضوحًا من خلال الأجندة العالمية لإدارته. مع ذلك، لا تزال البنية التحتية الواسعة للحرب على الإرهاب قائمة، ولا تزال صلاحياتها تؤثر على تنظيم الحكومة الأميركية، ونشر الجيش الأميركي، وعمليات مجتمع الاستخبارات الأميركية، ودعم واشنطن للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط»[3].
يلفت رودس إلى أن: «تحديد هدف الولايات المتحدة في العالم وإعادة تشكيل الهوية الأميركية في الداخل يكون في التركيز على المنافسة مع الحزب الشيوعي الصيني».
هذا التنافس هو أحد الشواغل الرئيسة في السياسة الأميركية الذي يثير اتفاقًا واسعًا بين الحزبين، وهناك أسباب وجيهة للقلق بشأن الحزب الشيوعي الصيني. على عكس تنظيم القاعدة، للحزب وجهة نظر بديلة عن الحكم والمجتمع والقدرة على إعادة تشكيل الكثير من دول العالم بما يتناسب مع أغراضه الخاصة. من المفارقات، أن صعود نفوذ الصين العالمي تسارع بشكل أكبر بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، حيث كانت الولايات المتحدة في كثير من الأحيان مستنزفة بتركيزها على الإرهاب والشرق الأوسط. من حيث التأثير الجيوسياسي كان الحزب الشيوعي الصيني المستفيد الأكبر من الحرب على الإرهاب. مع ذلك هناك أيضًا أسباب وجيهة للقلق من الكيفية التي قد تحدث بها المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. إن تحديد هدف الولايات المتحدة في العالم، واستعادة روح الهوية الأميركية من خلال بناء جديد، عبر شعار «نحن ضدهم» يخاطر بتكرار بعض أسوأ أخطاء الحرب على الإرهاب[4].
يتطرق الكاتب إلى الخطوات التي اتخذتها واشنطن لمواجهة الصين، حيث:
«يستثمر الكونغرس موارد كبيرة في العلوم والتكنولوجيا لمواكبة الابتكار الصيني. ويقترح البيت الأبيض سياسات صناعية من شأنها أن تحابي صناعات أميركية معينة، وتكرير أنظمة مراقبة الصادرات لفصل سلاسل التوريد الهامة التي تربط الولايات المتحدة والصين. يتشكل الإنفاق الدفاعي الأميركي بشكل متزايد من خلال حالات الطوارئ المستقبلية التي يشارك فيها جيش التحرير الشعبي. أعطت وزارة الخارجية الأولوية لتقوية التحالفات الأميركية في آسيا وعززت الاتصالات مع تايوان. أصبحت واشنطن تنتقد بشكل متزايد انتهاكات حقوق الإنسان الصينية في أماكن مثل هونغ كونغ وشينجيانغ. فيما يتعلق بالتجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء ومن خلال المنظمات متعددة الأطراف، مثل مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي، لتشكيل أقوى جبهة موحدة ممكنة ضد الصين. ستخلق هذه الجهود حوافزهم وضغوطهم السياسية الخاصة؛ كما أنها ستخلق زخمًا لتوسيع الموارد وعرض النطاق الترددي داخل حكومة الولايات المتحدة. بالفعل، يمكن للمرء أن يشعر بتعديل مسار عابرة المحيط الأميركية»[5].
يخلص رودس إلى أنه:
«على الرغم من أن كلاً من هذه المبادرات لها مبرراتها الخاصة، سيكون من الخطأ التركيز ببساطة على «هم» -وهو الدافع الجديد الذي يمكن أن يسهل موجة أخرى من الاستبداد القومي من النوع الذي سمم السياسة الأميركية على مدار العشرين عامًا الماضية. من الأفضل التركيز أكثر على «نحن» -ديمقراطية مرنة بما يكفي لتحمل منافسة طويلة الأمد مع نموذج سياسي منافس، وتكوين إجماع بين الديمقراطيات في العالم، وتقديم مثال أفضل له»[6].
ثانياً: عقيدة جيدة بما فيه الكفاية.. تعلم التعايش مع الإرهاب[7]
يحدد الكاتب الأميركي دانيال بايمان (Daniel Byman) في مقالته النجاحات والإخفاقات الأميركية في الحرب على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، ملاحظاً أنه مع تراجع خطر الإرهاب، لم تعد مواجهته الخارجية الآن ذات أولوية أميركية فورية، فقد حوّل الرئيس بايدن تركيز واشنطن نحو الصين، وتغير المناخ، وقضايا أخرى؛ وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، يعد جزءاً من محاولة إنهاء ما يسمى بالحروب الأبدية[8].
يجزم بايمان بأن:
«العديد من جهود السياسة الخارجية الأكثر طموحًا للولايات المتحدة، والتي بُذلت باسم مكافحة الإرهاب منذ 11 سبتمبر (أيلول)، مثل إحداث تغيير في نظام الشرق الأوسط، وكسب ود المسلمين في جميع أنحاء العالم، قد فشلت. بل وحتى جاءت بنتائج عكسية. على الرغم من أن القاعدة وداعش أضعف بكثير مما كانت عليه في ذروتهما، إلا أنهما استمرا في مواجهة ضغوط هائلة، ولم ينمُ انتشارهما وإن حدث في بعض الأحيان، فقد كان لبعض الوقت، وأكثر طموحًا من فرض قبضتهما. اليوم، تواجه دول أخرى تهديدات إرهابية من القاعدة وداعش، ومختلف فروعهم وحلفائهم، كما لا تزال الحروب الأهلية نشطة في جميع أنحاء العالم. بدلاً من السعي لتحقيق نصر حاسم، يبدو أن الولايات المتحدة قد اكتفت بشيء أقل طموحًا: «شيء جيد بما فيه الكفاية»[9].
يرى بايمان أنه على الرغم من تفاقم المخاطر الناجمة عن الإرهاب استقرت الولايات المتحدة:
«بعد سنوات من الخطط الكبيرة ذات الأهداف الطموحة، على مجموعة من السياسات المصممة لإضعاف «الجهاديين» الأجانب مع حماية الوطن الأميركي. ربما تكون الحملة الاستخباراتية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعات الإرهابية، هي أهم هذه السياسات ولكن الأقل تقديرًا لها. بعد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، طورت الولايات المتحدة أو وسعت شراكات أمنية مع أكثر من (100) دولة. تتمتع وكالات الاستخبارات المحلية بالقوى العاملة والسلطة القانونية والمهارات اللغوية والموارد الحيوية الأخرى لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم وتعطيلهم واعتقالهم»[10].
يلاحظ بايمان أنه:
«بعد عشرين عامًا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أصبحت السياسة الأميركية عالقة، ولكن ليس بالضرورة بطريقة سيئة. أدى مزيج من التعاون الاستخباراتي والضغط العسكري على الجماعات في ملاذاتهم، وتحسين الأمن الداخلي إلى عزل الولايات المتحدة -إلى حد كبير- عن العنف الإرهابي. ومع ذلك، فشلت واشنطن في حل المشكلة بشكل دائم. اليوم، لا تزال الولايات المتحدة تقصف وتهاجم «الأحفاد الأيديولوجيين» لمخططي الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الأصليين. ليست هناك نهاية في الأفق، وما زالت الجماعات مثل القاعدة ملتزمة بمهاجمة الولايات المتحدة. مع ذلك فإن الضغط المستمر يبقي هذه المنظمات ضعيفة، ونتيجة لذلك، فإنها ستشن هجمات أقل وأقل فتكًا لن يختفي «الإرهاب الجهادي»، لكن تأثيره الأكبر محسوس بشكل رئيس في أجزاء أخرى من العالم، حيث المصالح الأميركية محدودة. لذلك يجب على واشنطن أن تفكر مليًا في الأماكن التي تنشر فيها مواردها الخاصة بمكافحة الإرهاب. على الرغم من أن العنف في تشاد أو اليمن كارثي بالنسبة لتلك البلدان، إلا أن تأثيره على أمن الولايات المتحدة ضئيل. قد تكون الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية أو تحسين الحكم ذات قيمة لأسباب أخرى، لكنها غير ضرورية لدرء التهديدات الإرهابية المحتملة في بعض الحالات، قد تؤدي هذه الجهود في الواقع إلى جعل الوضع أسوأ. تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد لإدارة السياسات المحلية لمكافحة الإرهاب»[11].
يقترح بايمان أنه يجب على:
«القادة المحليين، بمن في ذلك مسؤولو الشرطة، التواصل مع مجتمعاتهم المسلمة لإظهار الدعم والحذر من أي أعمال عنف انتقامية. لسوء الحظ، أظهرت السنوات العشرون الماضية أن السياسيين يستغلون الخوف بشكل موثوق، حتى عندما يكون التهديد الفعلي محدودًا. مثل هذا السلوك لا يساعد سوى الجماعات الإرهابية في سعيها للبقاء على صلة»[12].
ثالثاً: الحرب على الإرهاب استحوذت على قوة الدولة[13]
يرى الكاتب النرويجي توماس هيغهامر (Thomas Hegghammer) أنه:
«على الرغم من أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 كانت نتائجها مرعبة، فإنها عكس ما كان يخشى كثيرون، لم تشر إلى أن المنظمات الإرهابية الكبيرة والقوية قد رسخت جذورها في الغرب وهددت أسس نظامه الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن الخوف المستمر من تلك النتيجة -والذي لم يكن مرجحًا على الإطلاق- قد أعمى الكثيرين عن اتجاه معاكس: «القوة القسرية المتزايدة باطراد للدولة التكنوقراطية، مع ترسيخ الذكاء الاصطناعي لهذه الميزة بالفعل، يؤدي لأن يكون التهديد بأي تمرد مسلح كبير في البلدان المتقدمة على الأقل، شبه معدوم (…) لقد نمت الإسلاموية المتشددة بالفعل في التسعينيات، ورفعت القاعدة المعايير -إلى حد كبير- من حيث إظهار مقدار الضرر الذي يمكن أن يلحقه اللاعبون غير الحكوميين بدولة قوية. في ذلك الوقت، كانت أجهزة الأمن القومي في معظم الدول الغربية أصغر مما هي عليه اليوم، ولأن تلك الأجهزة لم تكن تفهم جيدًا الجهات الفاعلة التي تواجهها، فقد كان من السهل فضح السيناريوهات الأسوأ. ومع ذلك، من الواضح عند استعادة الأحداث الماضية أن أهوال الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أخافت الكثيرين ودفعتهم إلى التشاؤم المفرط»[14].
يحدد هيغهامر حربين خاضتهما الدول الغربية على الإرهاب:
«واحدة ضد القاعدة في العقد الأول من هذا القرن، والأخرى ضد داعش في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين». في كل حالة، نمت منظمة جديدة دون أن يلاحظ أحد في منطقة صراع مختلفة، قبل أن تفاجئ المجتمع الدولي بهجوم عابر للحدود، ليتم هزيمتها من خلال جهد فوضوي لمكافحة الإرهاب[15].
يضيف هيغهامر أنه:
«بحلول عام 2011، أصبح المزاج السائد في دوائر مكافحة الإرهاب الغربية متفائلًا بحذر. لقد وعدت موجة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي التي بدأت في أواخر عام 2010، وأصبحت تعرف باسم الربيع العربي، بإنهاء الاستبداد الذي اعتبره الكثيرون السبب الجذري للجهاد. عندما قتلت البحرية الأميركية أسامة بن لادن في أبوت آباد، باكستان، في 2 مايو (أيار) 2011، كان من الممكن التفكير في أن الحرب على الإرهاب على وشك الانتهاء. بمعنى ما، كان هذا صحيحًا وخطأ. بالنظر إلى الماضي، كان عام 2011 بمثابة نهاية لحرب القاعدة على الغرب. تعيش الجماعة الآن كمجموعة من الميليشيات الإقليمية ذات الأجندات المحلية في أماكن مثل الصومال، لكنها لم تنجح في شن هجوم خطير على الغرب منذ ما يقرب من عقد من الزمان. في غضون ذلك، تولت منظمة أخرى زمام القيادة وحققت نجاحًا أكبر»[16].
بعد تحديد العوامل السياسية العامة لظهور تنظيم داعش وسيطرته على مناطق في سوريا والعراق عام 2014، وما واكبه من استغلال الإرهابيين للفورة التكنولوجية في سبيل التحريض على الإرهاب من خلال منتديات «الجهاد» والتجنيد وغيرهما من الوسائل:
«تُرجم هذا إلى واحدة من أخطر موجات العنف الإرهابي في تاريخ أوروبا الحديث. في غضون ثلاث سنوات، من 2015 إلى 2017، قتل الجهاديون في أوروبا ما يقرب من (350) شخصًا، وهو ما يزيد عن عدد الذين قُتلوا في الهجمات الجهادية في أوروبا خلال العشرين عامًا الماضية، وأكثر من إجمالي عدد القتلى على أيدي المتطرفين اليمينيين في أوروبا بين عامي 1990 و2020»[17].
لكن الدولة:
«انتصرت بحلول عام 2018، فانخفض عدد المخططات والهجمات الجهادية في أوروبا إلى النصف مقارنة بعام 2016، وجف تدفق المقاتلين الأجانب تمامًا. والأمر الأكثر لفتًا للنظر هو أن كل هجوم جهادي في أوروبا منذ عام 2017 قام به شخص وحيد، مما يشير إلى أنه أصبح من الصعب للغاية التخطيط لهجمات جماعية. وبالمثل، لم تتضمن أي ضربة إرهابية منذ عام 2017 متفجرات: «بدلاً من ذلك استخدم المهاجمون أسلحة أبسط، مثل البنادق والسكاكين والمركبات. كانت هناك بعض المؤامرات المعقدة والطموحة، لكن الشرطة أحبطتها جميعًا. هذا لا يعني استبعاد التهديد الحالي، الذي لا يزال خطيرًا. لكن هجوم داعش في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تراجع بحزم»[18].
يلاحظ هيغهامر أنه:
«بالنظر إلى المزايا الهائلة التي تتمتع بها البلدان المتقدمة الغنية، فمن اللافت للنظر أن الإرهاب الجهادي تمكن من الاستمرار في مثل هذه الأماكن حتى على مستويات منخفضة. أحد الأسباب هو أن قدرات الدول تتضاءل بعد حدودها والحركة الجهادية عابرة للحدود بشكل غير عادي. لعقود من الزمان، كان الجهاديون في الغرب قادرين على السفر إلى مناطق الصراع في العالم الإسلامي للتدريب، وبالتالي يتمتعون بنوع من العمق الاستراتيجي الذي لا يتمتع به المتطرفون الآخرون في الغرب، مثل أولئك الذين ينتمون إلى أقصى اليمين. سبب آخر هو أن الأيديولوجية الجهادية تعزز ثقافة التضحية بالنفس. يعرف كل من يفكر في الإرهاب في الغرب أنه لن يكون حاضراً للتمتع بالثمار السياسية الافتراضية لجهوده، لأنه إما سيموت أو يُقبض عليه في هذه العملية. مع ذلك، ومع الوعد بالمكافآت في الآخرة، تمكنت الحركة الجهادية من إنتاج مئات المتطوعين لمثل هذه الهجمات لمرة واحدة، مما سمح لها بمواجهة العدو بعناصر يمكن التخلص منها. إن معدل إنتاج هؤلاء المتطوعين أعلى بكثير بين الجهاديين منه في حركات التمرد الأخرى، بحيث يجب أن تكون الأيديولوجيا جزءًا من التفسير»[19].
يراهن هيغهامر على التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الإرهاب في البلدان المتقدمة التي ستصبح:
«رقمية أكثر من أي وقتٍ مضى، وسيصبح إخفاء هوية المرء والخروج من الشبكة أمرًا أكثر صعوبة. سيكون متمردو المستقبل قد عاشوا حياتهم بأكملها على الإنترنت، تاركين آثارًا رقمية على طول الطريق، وستكون هذه المعلومات في متناول الدول. قد توفر التقنيات الجديدة فرصة رقمية للجهات الفاعلة غير الحكومية، ولكن من المرجح أن يكون التأثير مؤقتًا. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تسريع مسيرة الدول نحو الهيمنة التكنولوجية. حتى الآن لم تتمكن الدول من استغلال جميع البيانات المتاحة لها. العمل الآلي قد يغير ذلك. من المحتمل أن تؤدي هذه التطورات التكنولوجية أيضًا إلى جعل العنف السياسي موزعًا بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء العالم. الدول ذات الموارد الجيدة ستكون قادرة على تحمل التكلفة للتحكم في النظام، في حين أن الدول الأضعف لن تفعل ذلك»[20].
رابعاً: الفوز القبيح: كلفة الحرب الأميركية على الإرهاب؟[21]
يتساءل الضابط السابق في البحرية والمخابرات الأميركية إليوت أكيرمان (Elliot Ackerman) قائلاً:
«هل يمكن أن يتعايش النجاح والفشل في ساحة المعركة نفسها؟ هل يمكن للولايات المتحدة أن تدعي أنها انتصرت في الحرب على الإرهاب، بينما خسرت في الوقت نفسه الحربين في أفغانستان والعراق؟ تتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة، تحليل المعارك العديدة التي خاضتها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وفهم تأثيرها على النفسية الأميركية».
يوضح أكيرمان أن «كل حرب خاضتها الولايات المتحدة، بدءًا من الثورة الأميركية، تتطلب أنموذجًا اقتصاديًا لدعمها بأجساد وأموال كافية. الحرب الأهلية على سبيل المثال، استمرت مع أول وثيقة وأول ضريبة دخل على الإطلاق. شهدت الحرب العالمية الثانية تعبئة وطنية، بما في ذلك وثيقة أخرى، والمزيد من الضرائب، وبيع سندات الحرب. كانت إحدى الخصائص الرئيسة لحرب فيتنام هي التجنيد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، والذي ولّد حركة مناهضة للحرب أدت إلى تسريع نهاية هذا الصراع. مثل سابقاتها، جاءت الحرب على الإرهاب بنموذجها الخاص: «خاضت الولايات المتحدة، الحرب عبر جيش من المتطوعين بالكامل، وتم دفع تكاليفها -إلى حد كبير- من خلال الإنفاق بالعجز من الميزانية». لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن هذا النموذج الذي تم تصميمه بطريقة خدرت غالبية الأميركيين عن تكاليف الصراع، قدّم لهم أطول حرب. في خطابه يوم 20 سبتمبر (أيلول) 2001، عندما وصف كيف يمكن أن يدعم الأميركيون المجهود الحربي، قال بوش: «أطلب منك أن تعيش حياتك وتعانق أطفالك»[22].
يرى أكيرمان:
«أن تمويل الحرب من خلال الإنفاق بالعجز سمح لها بالتفاقم من خلال الإدارات المتعاقبة مع عدم ذكر سياسي واحد لفكرة ضريبة الحرب. وفي الوقت نفسه، فإن أشكال الإنفاق الأخرى -من عمليات الإنقاذ المالية إلى الرعاية الصحية، وأخيرًا حزمة تحفيز التعافي من الأوبئة- تولد نقاشًا محتدمًا. إذا كان الإنفاق بالعجز قد خدّر الشعب الأميركي مقابل التكلفة المالية للحرب على الإرهاب، فإن التغييرات التكنولوجية والاجتماعية قد خدرتهم لتكلفتها البشرية. سهّل استخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من منصات الأتمتة المتزايدة القتال، مما سمح للجيش الأميركي بالقتل عن بُعد. أدى هذا التطور إلى إبعاد الأميركيين عن التكاليف البائسة للحرب، سواء كانت وفيات القوات الأميركية أو المدنيين الأجانب»[23].
يشدد أكيرمان على أن الجيش الأميركي:
«لا يزال أحد أكثر المؤسسات الموثوقة في الولايات المتحدة، وواحدًا من المؤسسات القليلة التي يرى الجمهور أنها لا تملك تحيزًا سياسيًا علنيًا. إلى متى ستستمر هذه الثقة في ظل الظروف السياسية القائمة؟ نظرًا لأن الحزبية تلوث كل جوانب الحياة الأميركية، فقد يبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن تنتشر العدوى إلى الجيش الأميركي. لكن، وماذا بعد؟ من قيصر روما إلى فرنسا في عهد نابليون، يُظهر التاريخ أنه عندما تقترن جمهورية ما بجيش كبير قائم بذاته مع سياسات داخلية مختلة، فإن الديمقراطية لا تدوم طويلاً. تستوفي الولايات المتحدة اليوم كلا الشرطين. تاريخياً، أدى هذا النوع من الأزمات السياسية إلى التورط العسكري (أو حتى التدخل) في السياسة الداخلية. الانقسام الواسع بين الجيش والمواطنين الذين يخدمهم هو إرث آخر من الحرب على الإرهاب»[24].
لا يرى أكيرمان جدوى:
«من فصل الحربين في أفغانستان والعراق عن الحرب على الإرهاب، الجدير بالذكر أنه بعد 11 سبتمبر (أيلول) مباشرةً، لم يكن الغزو والاحتلال الشامل لأي من البلدين أمرًا واقعًا. ليس من الصعب تخيل حملة مكافحة إرهاب أكثر محدودية في أفغانستان، والتي من الممكن أن تقدم بن لادن إلى العدالة أو استراتيجية لاحتواء عراق صدام حسين، التي لم تكن لتتضمن غزوًا أميركيًا واسع النطاق. كانت حملات مكافحة التمرد الطويلة والمكلفة التي أعقبت ذلك في كل بلد حروبًا مختارة. أثبت كلاهما أنهما خطوات خاطئة كبيرة عندما تعلق الأمر بتحقيق الهدفين التوأمين المتمثلين في تقديم مرتكبي 11 سبتمبر (أيلول) إلى العدالة وتأمين الوطن. في الواقع في لحظات عديدة خلال العقدين الماضيين، أعاقت الحروب تلك الأهداف. وكان ذلك بالتحديد هو الحال في الفترة التي أعقبت وفاة بن لادن في مايو (أيار) 2011»[25].
في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة غارقة في مكافحة الإرهاب على مدار العقدين الماضيين «كانت بكين منشغلة في بناء جيش لمحاربة وهزيمة منافس على مستوى الأقران». يضيف أكيرمان: «اليوم، البحرية الصينية هي الأكبر في العالم، وتضم (350) سفينة حربية تم تكليفها بمواجهة حوالي (290) سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية. على الرغم من أن السفن الأميركية تتفوق بشكل عام على نظيراتها الصينية، لكن يبدو الآن أنه من المحتم أن يصل جيشا البلدين إلى التكافؤ في يوم من الأيام. أمضت الصين (20) عامًا في بناء سلسلة من الجزر الاصطناعية في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي، والتي يمكن أن تعمل بشكل فعال كخط دفاعي لحاملات الطائرات غير القابلة للغرق. من الناحية الثقافية، أصبحت الصين أكثر عسكرية، حيث أنتجت محتوى قومياً مفرطاً مثل أفلام الحركة الذئب المحارب (Wolf Warrior). الذي يلعب فيه جندي البحرية الأميركية السابق دور الشرير (Archvillain). أصبح الفيلم، الذي تم إصداره عام 2017، الفيلم الأكثر ربحًا في تاريخ شباك التذاكر الصيني. من الواضح أن بكين ليست لديها أي مخاوف بشأن تصوير واشنطن كخصم»[26].
يعتبر أكيرمان أن:
«الصين ليست الدولة الوحيدة التي أفادت من انشغال الولايات المتحدة. في العقدين الماضيين، وسعت روسيا أراضيها إلى شبه جزيرة القرم، ودعمت الانفصاليين في أوكرانيا؛ دعمت إيران وكلاء لها في أفغانستان والعراق وسوريا. وحصلت كوريا الشمالية على أسلحة نووية. بعد أن افتتحت أحداث سبتمبر (أيلول) القرن الحادي والعشرين، سادت الحكمة التقليدية أن الجهات الفاعلة غير الحكومية ستثبت أنها أكبر تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة. لقد تحقق ذلك، ولكن ليس بالطريقة التي توقعها معظم الناس. عرّضت الجهات الفاعلة غير الحكومية الأمن القومي للخطر ليس من خلال مهاجمة الولايات المتحدة، ولكن من خلال تحويل انتباهها بعيدًا عن الجهات الحكومية. هؤلاء الخصوم الكلاسيكيون: (الصين، وإيران، وكوريا الشمالية، وروسيا) هم الذين وسعوا قدراتهم ونفوذهم في مواجهة الولايات المتحدة المشتتة»[27].
يتساءل أكيرمان:
ما مدى التهديد الوشيك من هذه الدول؟ فيجيب قائلاً: «عندما يتعلق الأمر بالمنصات العسكرية القديمة: (حاملات الطائرات، والدبابات، والطائرات المقاتلة) تواصل الولايات المتحدة التمتع بهيمنة تكنولوجية صحية على منافسيها القريبين. لكن قد لا تكون منصاتها المفضلة هي المنصات المناسبة. يمكن لصواريخ كروز الأرضية بعيدة المدى أن تجعل حاملات الطائرات الكبيرة شيئاً عفّى عليه الزمن. قد يؤدي التقدم في مجال الجرائم الإلكترونية إلى جعل الطائرات المقاتلة التي تعتمد على التكنولوجيا فاقدة لقدراتها. لقد حولت أخيراً أعظم العقول في الجيش الأميركي انتباهها إلى هذه المخاوف، مع قيام سلاح مشاة البحرية الأميركي -على سبيل المثال- بتحويل تركيزه الاستراتيجي بالكامل إلى صراع محتمل مع الصين، ولكن قد يكون ذلك متأخرا جدًا»[28].
لكن الولايات المتحدة -بحسب الكاتب- «تعاني من إجهاد الحرب. على الرغم من أن جميع أفراد الجيش من المتطوعين، وعدم وجود ضريبة حرب قد أعفى معظم الأميركيين من تحمل أعبائها، إلا أن هذا الإرهاق لا يزال واضحاً. تحت قيادة أربعة رؤساء احتفل الشعب الأميركي في البداية، ثم عانى من حروب لا نهاية لها تلعب في حياتهم. تدريجيًا، توتر المزاج الوطني، وقد لاحظ الخصوم ذلك. لقد أدى إجهاد الأميركيين -وإدراك الدول المنافسة لهذا الوضع- إلى الحد من الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة. نتيجة لذلك، تبنى الرؤساء سياسات التقاعس، وتآكلت المصداقية الأميركية. ظهرت هذه الدينامية بشكل صارخ في سوريا»[29].
يضيف أكيرمان:
«يبدو التعب وكأنه تكلفة «ناعمة» للحرب على الإرهاب، لكنه مسؤولية استراتيجية صارخة. تواجه الأمة التي أنهكتها الحرب وقتًا عصيبًا في تشكيل تهديد ردع موثوق به لخصومها. ثبت أن هذا صحيح خلال الحرب الباردة، عندما كنا في ذروة حرب فيتنام عام 1968، غزا السوفيت تشيكوسلوفاكيا، وفي أعقاب الحرب عام 1979، غزا السوفيت أفغانستان. ولأنها كانت متورطة بالحرب في الحالة الأولى وترنحت في الحالة الثانية، لم تستطع الولايات المتحدة ردع العدوان العسكري السوفيتي بشكل موثوق. الولايات المتحدة في وضع مماثل اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالصين. عندما سُئل الأميركيون في استطلاع حديث عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تدافع عن تايوان إذا واجهت غزوًا من قبل الصين، قال (55%) من المشاركين في الاستطلاع: إنه لا ينبغي على أميركا القيام بذلك. ومن الواضح أنه إذا قام الصينيون بمثل هذا الإجراء، خصوصاً إذا قُتل أميركيون أو مواطنو دول حليفة في هذه العملية، فقد يتغير الرأي العام بسرعة؛ ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى ارتفاع عتبة استخدام القوة بين الأميركيين. يدرك أعداء الولايات المتحدة هذا الأمر جيدًا. ليس من قبيل المصادفة أن الصين -على سبيل المثال- شعرت بالقدرة على التعدي على الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور. عندما تنحسر القوة الأميركية، تملأ دول أخرى الفراغ»[30].
يصل أكيرمان في تحليله إلى نتيجتين:
غيرت الحرب على الإرهاب رؤية الولايات المتحدة لنفسها، وكيف ينظر إليها بقية العالم؛ تضاءلت شهية الأميركيين لتصدير مُثُلهم إلى الخارج، لا سيما أنهم يكافحون من أجل دعم تلك المثل العليا في الداخل، سواء في أعمال العنف حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أو الاضطرابات المدنية في صيف 2020، أو حتى الطريقة التي أدت بها الحرب على الإرهاب إلى تهديد البلاد. من خلال الفضائح من سجن أبو غريب إلى تسريبات إدوارد سنودن. الولايات المتحدة التي تتمتع فيها فرقة الإخوة بجاذبية شبه عالمية قد باتت اليوم ذكرى بعيدة[31].
خامساً: الاستحواذ على القرى… التغييرات الحاصلة في أفغانستان من الأسفل[32]
يشرح مقال أستاذ العلوم السياسية الأميركي سيث جونز (Seth Jones)، المنشور في مجلة فورين أفيرز عدد مايو (أيار) 2010، فكرتين: تنامي فكرة الديمقراطيين «نحن لا نفهم أفغانستان»، وترويجهم لنظرية إعادة تفسير أفغانستان وطالبان، على أنها تقاطعات قبلية، ترفض الحكم المركزي، واستخدام صيغة تجعل التجاوزات الطالبانية مفهومة في سياق: «التمرد، والقبيلة».
يتساءل جونز: «منذ متى كانت أميركا في أفغانستان؟ وما مقدار ما يعرفه الأميركيون عن أفغانستان وشعبها؟ هل يفهمون ثقافتها وقبائلها وسكانها؟ أخشى أنهم يعرفون القليل جدًا عن كل ذلك».
يستند جونز على ثلاثة كتب صدرت عام 2010 قدمت تحليلات مهمة عن تلك البيئة. الأول هو (حياتي مع طالبان) (My Life With the Taliban)، الذي كتبه عبدالسلام ضعيف، والذي يعتبر بمثابة رد على الكثير مما كُتب عن أفغانستان منذ عام 1979، قدم فيه لمحة نادرة لما يدور في أذهان أحد كبار قادة طالبان، الذي لا يزال متعاطفًا مع الحركة. الكتابان الآخران تم تحريرهما وكتابتهما، من قبل الباحث أنطونيو جيوستوتزي (Antonio Giustozzi)، وهو زميل باحث في كلية لندن للاقتصاد، قضى عقوداً عدة في العمل في أفغانستان. في الكتاب الأول «فك رموز حركة طالبان الجديدة: رؤى من الميدان الأفغاني» (Decoding the New Taliban: Insights from the Afghan Field)، يجمع جيوستوتزي مقالات من صحفيين ومسؤولين حكوميين سابقين، وعمال إغاثة وأكاديميين لفحص طبيعة التمرد الحاصل. قدمت فصول الكتاب رؤى جديدة ثاقبة، لا سيما تلك التي تتناول ولاية هلمند في جنوب البلاد، وإقليم أوروزغان في الوسط، ومشاكل شرق أفغانستان. بعض فصول الكتاب الأخرى، مثل الفصل الخاص بقندهار، لا يضيف سوى القليل على ما تم نشره بالفعل. في كتابه الثاني «إمبراطوريات الطين: الحروب وأمراء الحرب في أفغانستان» (Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan)، يقيّم جيوستوتزي ديناميات أمراء الحرب، يركز على عبدالرشيد دوستم في الشمال، ومحمد إسماعيل خان في الغرب، وأحمد شاه مسعود في وادي بنجشير[33].
يرى جونز أن الكتب الثلاثة تقدم نظرة دقيقة على المستوى الجزئي للبلد. والأهم من ذلك، أنها توفر تكهناً مخيفاً لأولئك الذين يعتقدون أن الحل لتحقيق الاستقرار في أفغانستان لن يأتي إلا من الأعلى إلى الأسفل -من خلال بناء مؤسسات حكومية مركزية قوية. على الرغم من أن إنشاء دولة مركزية قوية -بافتراض إمكانية حدوث ذلك في أي وقت مما قد يساعد في ضمان استقرار طويل الأمد، إلا أنه ليس كافيًا في بلد مثل أفغانستان. في أفغانستان، يجب أن تتم جهود بناء الدولة الحالية من أعلى إلى أسفل، وجهود مكافحة التمرد جنبًا إلى جنب مع البرامج التصاعدية، مثل الوصول إلى القادة المحليين الشرعيين لتجنيدهم لأجل توفير الأمن والخدمات على مستوى القرية والمقاطعة. وإلا فإن الحكومة الأفغانية ستخسر الحرب»[34].
تحت عنوان فرعي «التأسيس غير الممكن للمركزية» يشير جونز إلى انقسام «خبراء بناء الدولة ومكافحة التمرد في أفغانستان إلى معسكرين متنافسين. يعتقد الأول أن أفغانستان لن تكون مستقرة وآمنة أبدًا بدون حكومة مركزية قوية؛ قادرة على تقديم الخدمات للأفغان في جميع أنحاء البلاد. بينما يصر الثاني على أن أفغانستان كانت وستظل دائمًا مجتمعًا لامركزيًا في جوهره، مما يجعل من الضروري بناء مؤسسات محلية لخلق الأمن والاستقرار. منذ اتفاقية بون في ديسمبر (كانون الأول) 2001 -التي أسست حكومة مؤقتة ولجنة لصياغة دستور جديد- ركزت الجهود الدولية في أفغانستان للأسف على المبادرات الموجهة للحكومة المركزية لإرساء الأمن والاستقرار. على الجبهة السياسية، كان التركيز على دعم حكومة حامد كرزاي وتعزيز المؤسسات في كابول. على الجبهة الأمنية، بنى المجتمع الدولي الشرطة الوطنية الأفغانية والجيش الوطني الأفغاني كحصن ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة مع ذلك، لم ينجح هذا الجهد: «هناك عدد قليل جدًا من قوات الأمن الوطني لحماية السكان، وقصص فساد الشرطة وعدم كفاءتها مذهلة، والعديد من المجتمعات الريفية لا تريد وجود حكومة مركزية قوية»[35].
يلاحظ جيوستوتزي أن:
«الجهود الدولية الحالية لإرساء الأمن والاستقرار في المركز تستند إلى سوء فهم أساسي لثقافة أفغانستان وبنيتها الاجتماعية. بالإضافة لكل ذلك، قلة هم من المدنيين غير الأفغان؛ الذين يقضون وقتًا في مناطق العنف في شرق وجنوب وغرب أفغانستان. كما تمنع المخاوف الأمنية عددًا كبيرًا جدًا من مسؤولي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من السفر خارج قواعدهم أو مناطقهم الحضرية. وبالمثل، لا يستطيع معظم الأكاديميين الوصول إلى المناطق الريفية المركزية للتمرد لأن هذه المناطق بمثابة مقبرة للغربيين. ومع ذلك، فإن هذا التمرد في الأساس تمرد ريفي. إن الحجم المتزايد للقواعد الدولية في باغرام وكابول وقندهار ومناطق أخرى دليل على هذا النفور من المخاطرة، الذي يمنع الأجانب من فهم المناطق الريفية في أفغانستان وسكانها. مثل هذا الوضع ضار للغاية، لأن بناء الدولة ومكافحة التمرد تميل إلى أن تكون مرتبطة بالسياق العام؛ التاريخ والثقافة والبنية الاجتماعية مهمة، للقيام بهذه العملية»[36].
يجادل جيوستوتزي بأنّ المؤيدين ذوي النوايا الحسنة الداعين لبناء الدولة من أعلى إلى أسفل قد نجوا لفترة طويلة جدًا، معتمدين فقط على الطريقة المثالية لنهج جون لوك وإيمانويل كانط. لقد قال في كتابه، إمبراطوريات الطين: «هدفي من هذا الكتاب هو القيام بحقن أمين لهذا المزيج؛ عبر ما أشار إليه كلٌّ من هوبز ومكيافيللي وابن خلدون»؛ وهذا الأخير إشارة إلى مؤرخ شمال أفريقيا والمعلق الاجتماعي في القرن الرابع عشر الذي طور النظريات حول القبلية والصراع الاجتماعي. إن المسؤولين الغربيين الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان سيفعلون خيرًا إذا أخذوا بنصيحة جيوستوتزي. يجب أن يبدؤوا بقبول عدم وجود شكل أمثل لتنظيم الدولة، وأن الظروف لا تتيح دائمًا «أفضل الممارسات» الواضحة، لحل مشاكل الإدارة العامة. على الرغم من أن بعض المهام مثل إصلاح البنوك المركزية تتناسب مع الترقيع التكنوقراطي من قبل جهات خارجية، فإن مهام أخرى مثل الإصلاح القانوني، قد تكون أكثر صعوبة. التحدي الذي يواجه واشنطن -إذن- هو الجمع بين معرفتها بالممارسات الإدارية، والفهم الأعمق للظروف المحلية»[37].
يستشهد جونز بتعليق ديفيد كيلكولين (David Kilcullen) -الذي شغل منصب كبير مستشاري مكافحة التمرد في العراق- على كتاب «فك رموز طالبان الجديدة» حيث قال:
«إن الهيكل الاجتماعي في مناطق البشتون بأفغانستان يقوم على ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا نظام القرابة المجزأ: ينقسم الناس إلى قبائل وعشائر، والعشائر إلى أقسام فرعية أخرى بناءً على نسبهم من الأسلاف الذكور المشتركين». وكما يقول ضعيف، فإن هوية الأفغان: «تكمن في قبيلتهم وعشيرتهم وعائلاتهم وأقاربهم». إنه شعور محلي واضح للتعبير عن الهوية. وكرر توم كـوكلن (Tom Coghlan)، مراسل صحيفة التايمز في لندن وذي إيكونوميست، الفكرة نفسها، في أحد فصول كتاب جيوستوتزي، مشيرًا إلى أن بنية العلاقات الاجتماعية في مقاطعة هلمند تقوم على الكلمة العربية (قوم) «جماعة من الناس تربطهم بعضهم ببعض وحدة اللغة والثقافة والمصالح المشتركة»، والتي عبرها يمكن أن تميز -تقريبًا- أي مجموعة اجتماعية من قبيلة كبيرة إلى قرية صغيرة معزولة، وتُستخدم للتمييز بين «نحن» و«هم». قد تكون القبيلة أو القبيلة الفرعية في منطقة ما مختلفة تمامًا في هيكلها وميولها السياسية عن القبيلة نفسها أو القبيلة الفرعية في منطقة أخرى»[38].
يلاحظ جونز في قراءته للكتاب أنه:
«على الرغم من هذه الاختلافات الإقليمية، تميل القوة إلى أن تظل محلية في مناطق البشتون، حيث يدور فيها التمرد إلى حد كبير. قد يتعرف البشتون مع قبيلتهم أو قبيلتهم الفرعية أو عشيرتهم أو قومهم أو أسرتهم أو قريتهم بناءً على مكان وجودهم في ذلك الوقت، ومع من يتفاعلون، والحدث المحدد. يشكل «البشتونوالي» (Pashtunwali) (نمط الحياة التقليدي لشعب البشتون)، مدونة أحكام لسلوكهم وحياتهم اليومية من خلال التزامات الشرف والضيافة والانتقام وتوفير الملجأ أو الملاذ الآمن. لا تزال مجالس (الجيركة) والشورى -وهي مجالس صنع القرار- فعالة على المستوى المحلي، حيث تكاد المؤسسات القانونية للدولة تكون غير موجودة»[39].
كتبت المستشارة السياسية للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان مارتين فان بيليرت (Martine van Bijlert) –وفقاً للعرض المقدم من جونز- أنه من بين البشتون في أوروزغان:
«تظل القبيلة الفرعية التي يمكن أن يتفاوت حجمها من بضع مئات إلى آلاف الأشخاص، هي مجموعة التضامن الرئيسة لتحديد أنماط الولاء والصراع والتزامات الحماية».
وتابعت قائلة:
إن الانتماءات القبلية: «أصبحت أكثر أهمية منذ عام 2001 بسبب غياب مؤسسات الحكومة المركزية». تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة آسيا إلى أن الأفغان يواصلون اللجوء إلى قادة المجتمع المحلي التقليدي، وليس المسؤولين في كابول، لحل مشاكلهم[40].
في ظل غياب مؤسسات حكومية قوية، فإن المجموعات التي تشكلت على أساس النسب من سلف مشترك تساعد البشتون؛ على تنظيم الإنتاج الاقتصادي والحفاظ على النظام السياسي والدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات الخارجية. تميل هذه الروابط إلى أن تكون أضعف في المناطق الحضرية، حيث تكون سيطرة الحكومة المركزية أقوى، ويمكن للأفراد التعريف على أنفسهم من خلال مدينتهم بدلاً من قبيلتهم. تتجلى هذه الظاهرة بوضوح من خلال العدد المتزايد للأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم «كابوليون» لأنهم يعيشون في العاصمة الأفغانية غير المتجانسة عرقيًا وقبليًا. (على عكس البشتون، تميل الهوية القبلية إلى أن تكون أضعف أو غير موجودة بين العديد من الجماعات العرقية الأفغانية الأخرى، مثل الطاجيك والأوزبك والهزارة)[41].
يشير جونز إلى أنه «في مناطق البشتون، تظل العلاقات القبلية وشبه القبلية قوية، مع ذلك، فإنها لا تعتبر القوة الوحيدة التي تحكم السياسة المحلية. حيث تطورت الهياكل الاجتماعية الإضافية على مدى العقود العديدة الماضية بسبب الحرب والجفاف والهجرة والتوطين وعوامل أخرى. نتيجة لذلك، يمكن لمجموعة من الهويات الأخرى أن تتجاوز الهياكل القبلية، مثل الهويات القائمة على السمعة المكتسبة من خلال الجهاد ضد السوڨيت، أو ملكية الأراضي، أو الثروة المكتسبة عبر أنشطة مشروعة أو غير مشروعة (مثل ضرائب الطرق أو تجارة المخدرات). في مثل هذه البيئة، يكون للأجانب -وخاصة الجنود منهم- قدرة محدودة على تشكيل السياسات المحلية. وتستغل القوى المتمردة هذا الوضع جيدًا، حيث تتألف من مزيج فضفاض من الجماعات، مثل طالبان والقبائل والعشائر الفرعية المتحالفة معها، وتجار المخدرات، والمجرمين الآخرين، وسماسرة النفوذ المحليين، والجهات التي ترعاها دول إقليمية مثل إيران وباكستان. مع الأخذ في الاعتبار اختلاف كيفية تجمع وتحالف هذه المجموعات بشكل كبير من قرية إلى أخرى. في أجزاء من محافظة خوست -على سبيل المثال- يشمل التمرد أعضاء من شبكة حقاني، وعشائر زدران الفرعية، وتجار الأخشاب، ونشطاء من تنظيم القاعدة»[42].
يكشف جونز أن طالبان:
«ليست الجماعة المتمردة الوحيدة التي تستخدم الشبكات المحلية بشكل فعال لصالحها، فكذلك الأمر تفعله شبكة حقاني، التي أسسها قائد المجاهدين الأسطوري وحليف وكالة المخابرات المركزية السابق جلال الدين حقاني، والتي تعمل الآن في شرق أفغانستان»[43].
في السياق ينقل جونز عن توماس روتيغ (Thomas Ruttig)، ملاحظته في كتابه «فك رموز حركة طالبان الجديدة»، أن «إحدى أقوى قواعد الدعم لشبكة حقاني هي عشيرة مازي الفرعية من قبيلة زادران التي تعيش على طول الحدود الأفغانية- الباكستانية. اختارت شبكة حقاني أيضًا مجموعة من كوچى، وهم رعاة بدو في باكتيا وخوست، وأقامت علاقة وثيقة مع قبائل الأحمدائي الفرعية عبر الحدود في باكستان. وهناك خيط مشترك في العديد من هذه الروايات: «لقد أدركت حركة طالبان والجماعات المتمردة الأخرى الطبيعة المحلية للسياسة في أفغانستان ووضعت استراتيجية محلية -تجمع بين القسوة والدبلوماسية الماكرة». في غضون ذلك، كانت الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية وقوات الناتو تفتقد -إلى حد كبير- كل تلك المعارف والعلاقات على المستوى المحلي[44].
يعود جونز بالقارئ إلى التجارب الأفغانية السابقة المرتبطة بالمجالات الأمنية خلال أحدث فترة استقرار في أفغانستان «وهي فترة الحكم الملكي للسلالة البركزاية (1929- 1978)، حيث استخدم الحكام الأفغان محمد نادر شاه، ومحمد ظاهر شاه، والرئيس محمد داود خان، الذي أسس جمهورية عام 1973، مزيجًا من الاستراتيجيات المركزية واللامركزية التي تستحق المحاكاة. اليوم، أقامت القوات الوطنية الأمن في المناطق الحضرية وعلى طول الطرق الرئيسة، وبسطت المجتمعات المحلية الأمن في المناطق الريفية بمباركة ومساعدة كابول. في مناطق البشتون، استخدم السكان المحليون قوات «الشرطة التقليدية» مثل أربكاي، وقوات شرطة صغيرة أخرى على مستوى القرية تحت سيطرة المؤسسات المحلية المعترف بها مثل الجيركة أو مجالس الشورى. لم تكن هذه ميليشيات بمعنى القوات الهجومية الكبيرة تحت قيادة أمراء الحرب، والتي تميل إلى استخدامها اليوم في المناطق الطاجيكية والأوزبكية في شمال وغرب أفغانستان»[45].
يضيف جونز «في ذلك الوقت، لم تنشئ الحكومة المركزية وجودًا أمنيًا دائمًا في العديد من المناطق الريفية وخاصة مناطق البشتون، ولم يرغب السكان المحليون عمومًا في أن تلعب الحكومة هذا الدور. أثناء سفري عبر مناطق البشتون الريفية خلال العام الماضي (2009)، اكتشفت أن العديد من مؤسسات الشرطة التقليدية هذه لا تزال موجودة، على الرغم من أن طالبان قد استولت على بعضها. إذا استفادت الحكومة الأفغانية من ذلك النهج، فيمكن أن تساعد في إطلاق ثورة ضد طالبان في المناطق الريفية. يتطلب هذا تحديد تلك المجتمعات المحلية التي تقاوم بالفعل طالبان، وتوفير التدريب والمراقبة والمعدات لتسهيل مقاومتهم؛ ثم محاولة قلب الآخرين تباعًا ضد طالبان».
[1] انتقيت المواد من مستلة رصدية مترجمة، وظِّفت لحلقة نقاشية قدمتها في هذه الورقة ريتا فرج، الباحثة اللبنانية في علم الاجتماع ودراسات المرأة، وعضو هيئة التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث.
[2] Ben Rhodes, Them and Us, How America Lets Its Enemies Hijack Its Foreign Policy
Foreign Affairs September/October 2021, at:
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-24/foreign-policy-them-and-us
[3] المرجع نفسه.
[4] المرجع نفسه.
[5] المرجع نفسه.
[6] المرجع نفسه.
[7] Daniel Byman -The Good Enough Doctrine Learning to Live with Terrorism, Foreign Affairs, September/October 2021,at:
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-08-24/good-enough-doctrine
[8] المرجع نفسه.
[9] المرجع نفسه.
[10] المرجع نفسه.
[11] المرجع نفسه.
[12] المرجع نفسه.
[13] Thomas Hegghammer, Resistance Is Futile, The War on Terror Supercharged State PowerForeign Affairs, September/October 2021, at:
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-08-24/resistance-futile
[14] المرجع نفسه.
[15] المرجع نفسه.
[16] المرجع نفسه.
[17] المرجع نفسه.
[18] المرجع نفسه.
[19] المرجع نفسه.
[20] المرجع نفسه.
[21] Elliot Ackerman, What the War on Terror Cost America, Foreign Affairs September/October 2021, at:
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-08-24/winning-ugly
[22] المرجع نفسه.
[23] المرجع نفسه.
[24] المرجع نفسه.
[25] المرجع نفسه.
[26] المرجع نفسه.
[27] المرجع نفسه.
[28] المرجع نفسه.
[29] المرجع نفسه.
[30] المرجع نفسه.
[31] المرجع نفسه.
[32] Seth G. Jones Foreign Affairs It Takes the Villages Bringing Change from Below in Afghanistan, Foreign Affairs, May/June 2010, at:
https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2010-05-01/it-takes-villages
[33] المرجع نفسه.
[34] المرجع نفسه.
[35] المرجع نفسه.
[36] المرجع نفسه.
[37] المرجع نفسه.
[38] المرجع نفسه.
[39] المرجع نفسه.
[40] المرجع نفسه.
[41] المرجع نفسه.
[42] المرجع نفسه.
[43] المرجع نفسه.
[44] المرجع نفسه.
[45] المرجع نفسه.