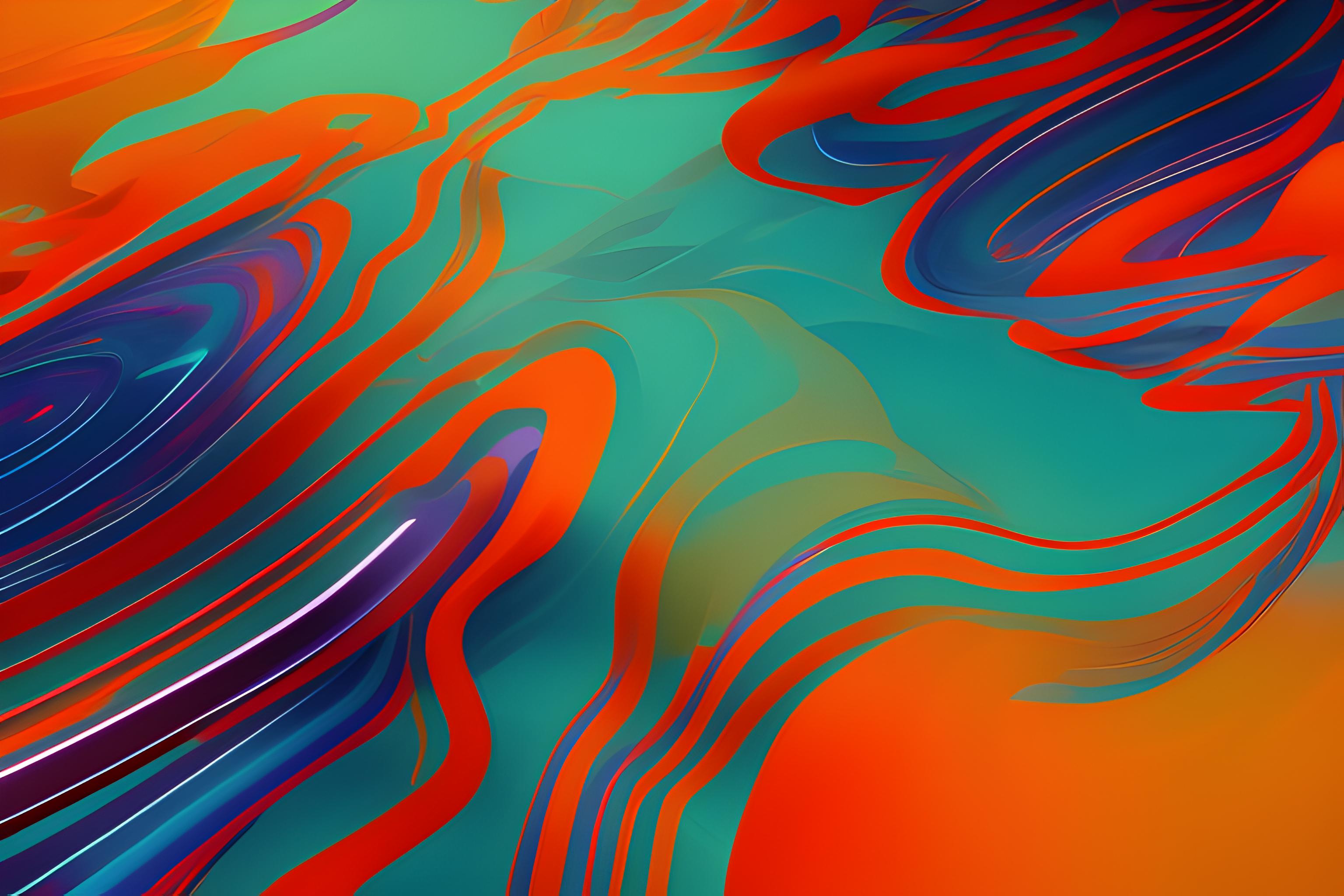ما عادت الكتابة عن رؤية الاستشراق للإسلام سهلة، لأنه ما عادت هناك رؤيةٌ أو اثنتان أو ثلاثة… إلخ. وذلك لأنّ الاستشراق ما عاد تخصصاً أو مجالاً معرفياً يمكن تحديده والكتابة فيه. وهذا إلاّ إذا اعتبرنا أنّ كل كاتبٍ أوروبي أو أميركي عن العرب والإسلام والمسلمين مستشرق! ويضاف لذلك أمرٌ آخر أو ثالث هو أنه عندما كان إدوارد سعيد يُصدرُ كتابه عن الاستشراق (1978)، كان الاستشراق الذي قصده في طريقه للنهاية.
ما عادت الكتابة عن رؤية الاستشراق للإسلام سهلة، لأنه ما عادت هناك رؤيةٌ أو اثنتان أو ثلاثة… إلخ. وذلك لأنّ الاستشراق ما عاد تخصصاً أو مجالاً معرفياً يمكن تحديده والكتابة فيه. وهذا إلاّ إذا اعتبرنا أنّ كل كاتبٍ أوروبي أو أميركي عن العرب والإسلام والمسلمين مستشرق! ويضاف لذلك أمرٌ آخر أو ثالث هو أنه عندما كان إدوارد سعيد يُصدرُ كتابه عن الاستشراق (1978)، كان الاستشراق الذي قصده في طريقه للنهاية.
وقد احترنا ماذا نسمّي الذين جاؤوا منذ السبعينيات من القرن الماضي من الدارسين الغربيين؛ لينقضوا كلَّ أعمال ومناهج أسلافهم بشأن التاريخ الديني والاجتماعي والثقافي للإسلام. سمينا خطاب سعيد وزملاءه: نقداً للخطاب الاستعماري، أما الناقدون الناقضون فقد سميناهم تارةً مستشرقين جدداً، وطوراً سميناهم مراجعين جُدُداً (Neo-Revisionists) وبالنظر لهذه الاعتبارات كلها فإنني سأُوجزُ النظرة في ظهور «الاستشراق العلمي» بالمقاييس الأوروبية، في معناه ودلالاته وتطوراته. ثم أقوم بمراجعة نقديةٍ لظواهر العقود الثلاثة الأخيرة؛ وأختم بمحاولاتٍ استشرافيةٍ لتخصص الدراسات الإسلامية، ورؤى العرب والإسلام في الغرب، بالحاضر والمستقبل.
ظهور الاستشراق «العلمي» وتطوراته (1844 – 1950)
إنّ أولى مشكلات الاستشراق أو أعمال الغربيين في التراث الإسلامي وعنه، أنه لم يظهر باعتباره جزءًا من علم التاريخ (الذي كان علمَ العلوم عند الغربيين). وذلك لأنّ هؤلاء العلماء وقد كان معظمهم من دارسي العهدين، اعتبروا الإسلام ديناً يملك نصاً مقدساً هو القرآن، وإذا أمكن تحديد طبيعته أمكن الحكم على الإسلام. وهكذا ما نظروا إلى الإسلام باعتباره ديناً وحضارةً مثل حضارات الهند والصين واليابان. ولذلك كانت مصادرهم لقراءة هذا الدين وفهمه، اللغة أو الفيلولوجيا، والذهاب من الفيلولوجيا لكتابة التاريخ، وليس تاريخ الأمة أو الحضارة بل تاريخ النصّ أصولاً ومصادر وتركيباً وعلائق.
إذ إنْ كان النصّ هو الأصل، فيمكن فهم الدين كلّه إذا عرفنا نصَّه المقدس معرفةً جيدة. ولذلك اشتهر كتابان باعتبارهما مؤسِّسين لدراسات الإسلام العلمية: كتاب العالم اليهودي الليبرالي أبراهام غايغر (A. Geiger) «ماذا أخذ القرآن عن اليهودية» (1833)، ثم كتاب المستشرق الألماني ثيودور نولدكه (Theodor Nöldeke) «تاريخ القرآن» (1857-1859)[2]. وفيما بين العام 1844 تاريخ إصدار مجلة جمعية المستشرقين الألمان- و1901 عام صدور كتاب المستشرق الألماني يوليوس فلهاوزن (Julius Wellhausen) ذي النوعية المختلفة: «تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلي نهاية الدولة الأموية»، صدرت عشرات الدراسات الطويلة والقصيرة عن القرآن والنبي، ليس لدى الألمان وحسب، بل ولدى البريطانيين والهولنديين والفرنسيين والإيطاليين. معظم هؤلاء في الأصل من علماء العهدين القديم والجديد واللغات السامية، وقد اهتموا بتجربة حظّهم مع القرآن من أجل فهمه وفهم نبوة النبي في ضوء دراساتهم النقدية والمرجعية للعهدين[3].
هل كانت هذه الدراسات مفيدة، ولماذا اعتُبرت علمية؟ اعتُبرت علمية لأنها اعتمدت على الفيلولوجيا(العلوم اللغوية). فقد كان هؤلاء يعرفون اللغات السريانية- الآرامية، والعبرية، والعربية. وقالوا: إنهم سلكوا مع القرآن، كما سلكوا مع العهدين القديم والجديد في التفكيك الفيلولوجي. ومعنى هذا أنهم لم يراعوا أنّ النصّ نصٌ ديني، وأنه ربما كان من الضروري لفهمه جيداً ملاحظة أنّ هذه النصوص صارت نصوصاً مقدسةً، إن لم تكن كذلك من البداية. ثم إنّ نقلها وتدوينها وتاريخها شديد الاختلاف. إنما كما قلنا فإنّ الاحتكام جرى إلى اللغة بغض النظر عن طبيعة النصّ. فهل كانت مفيدة؟ كانت الفائدة ضئيلةً لأنهم بالمنهج المقارن الذي اتبعوه أحالوا القسم الأعظم من النصّ القرآني إلى أصولٍ سريانيةٍ وعبرانية وحبشية يهودية أو مسيحية. وما حصل ذلك في المفردات فقط، بل في العقائد والشعائر وقصص الأنبياء وحتى وصف الطبيعة وخلق الإنسان وتصورات الغيب واليوم الآخر. وقد تطورت هذه النزعة إلى أبعادٍ كبرى لدى عددٍ من أهل المقاربة الفيلولوجية، والصورة المسبقة عن تبعية القرآن للكتب المقدسة في اليهودية والمسيحية، وذلك من مثل كتاب المستشرق الأسترالي آرثر جفري (Arthur Jeffery): «معجم المفردات الأجنبية في القرآن». وصحيح أنّ العناية بتقسيمات المكي والمدني بدت مُفيدة، لكنّ هذه الصورة المسبقة عمّا هو القرآن، حالت دون قراءته حتى باعتباره نصاً، وليس مقتطفات واقتباسات من هنا وهناك[4]. وتبقى المفارقة في شبه القطيعة التي أقامتها هذه القراءات بين القرآن والإسلام في صورته التاريخية التي نعرفها.
أما البحوث عن النبي، فصارت إلى دراسة السيرة بطريقتين متوازيتين: قراءة أحداث السيرة استناداً إلى كتب السيرة النبوية وخصوصاً ابن إسحاق- وفصل أحداث السيرة عن القرآن، باعتبار أنّ النبيَّ محمداً كان يريد التشبه بموسى، بل وإنّ فكرة النبوة ذاتها مأخوذة عن صُوَر أنبياء بني إسرائيل في العهد القديم. في حين قال مستشرقو تلك الفترة: إن تصوير القرآن للمسيح ولإبراهيم فيهما غموض شديدٌ وتناقضات. ومنذ تلك الفترة ظهرت النقائض والخلافات بين المستشرقين في اعتبار بعضهم من جهة أنّ النبيَّ ما كان أمياً، وكان يعرف المسيحية واليهودية جيداً من خلال رحلاته، ومعرفته بمسيحيين ويهود في الجزيرة وخارجها- ومن جهةٍ ثانيةٍ أكد البعض الآخر وجود تناقضات في تصوير القرآن لليهودية والمسيحية لا يمكن اعتبارها ظاهرية[5]. وهكذا وحتى الثلاثينيات من القرن العشرين، ظلَّ القرآن، وظلَّ النبي (صلى الله عليه وسلّم) في أسر أو رهان هذه الرؤى الاختزالية: فالمستشرقون الكاثوليك وبعض البروتستانت يجعلونهما انشقاقات وفصاميات مسيحية مشرقية سريانية- والمستشرقون اليهود وبعض البروتستانت يجعلونهما مواريث يهودية.
لكنّ الفيلولوجيا التاريخانية هذه ظهر وتبلور فيها اتجاهٌ آخر عملاق، كانت له فوائد كبيرة، ودفع باتجاهاتٍ كبيرةٍ أيضاً. إنّ البداية ذات العمق الفيلولوجي في التاريخانية، والتي تتضمن نشر النصوص العربية، والاستناد إليها في التأليف، بادر إليها الفرنسي سلفستر دي ساسي (Silvestre de Sacy) (1758-1838) الذي تولى إدارة مدرسة اللغات الشرقية الحية التي أنشأتها الثورة الفرنسية في باريس عام 1795. وهو كان رائداً في مجالات عدة. في المجال الأول عمد إلى كتابةِ نصٍ مدرسيٍّ في النحو العربي. وكان المدرّسون للغة العربية لا يزالون يعتمدون على كتاب المستشرق الهولندي توماس إربنيوس (Thomas Erpenius) (1584-1624) من مطلع القرن السابع عشر. وقد ذكر الألماني أوغست فِشَر (August Fischer) في مختاراته للقراءة العربية (1886) أن الرائد في هذا المجال هو دي ساسي أستاذ معلِّمه هاينرش فلايشر (Heinrich Fleischer) الذي قصده مع آخرين من الألمان والهولنديين والإيطاليين والتونسيين والمصريين للتعلم على يديه. وإلى ذلك فهو رائدٌ في تحقيق النصوص، إذ حقق كتاب كليلة ودمنة عام 1817 على ست مخطوطات تعود أقدمها إلى القرن السابع الهجري، وهي المخطوطة التي اتخذها أصلاً[6].
إنّ أشهـر الذين تعلمـوا لدى دي ساسـي، إلى جانـب رفاعـة رافع الطهطاوي المصري (1801-1873)، وكانوا ذوي اهتماماتٍ تاريخانية وإنسانوية أوسع، ثلاثةٌ من الألمان وهم: فلهلم فرايتاغ (Freytag) (1788-1861)، وهاينرش فلايشر (1801-1888)، وغوستاف فليغل (Flügel Gustav) (1802-1870). وقد اهتم فرايتاغ بكتب الأمثال العربية، وألّف المعجم العربي- اللاتيني الذي اعتمد في جمع مفرداته على المعاجم العربية المخطوطة. في حين قام فليغل بنشر طبعةٍ من القرآن الكريم ظلَّ المستشرقون يستخدمونها حتى ظهرت الطبعة المصرية عام 1923. ونشر فليغل أيضاً صحيح البخاري، كما نشر «الفهرست» لابن النديم، وكشف الظنون لحاجي خليفة. أما فلايشر والذي ألّف مثل أُستاذه دي ساسي في النحو العربي والمنتخبات، واستدرك على معجم دوزي المسمَّى «تذييل على القواميس العربية»؛ فإنه بدأ مشروعاً هائل الضخامة تحت اسم: «المعجم التاريخي للغة العربية»، وكان طموحه أن يأتي مثل المعاجم المُشابهة في اللغات والحضارات الكلاسيكية الكبرى. وقد اتخذ المعجم صيغته النهائية على يد تلميذه أوغست فِشَر، ويستمر العمل به على تقطُّعٍ حتى الزمن الحاضر. وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين قام تعاوُنٌ بينه وبين مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والذي كان قد بدأ بوضع المعجم الكبير[7].
وفيما بين أعوام 1845 و1925 تفجر طوفانٌ من نشرات النصوص في كل مجالات التراث العربي، في ألمانيا وهولندا والنمسا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وروسيا. وبالطبع فإنّ بعض النصوص تُرجمت ودُرست لحاجة بعض الإدارات الاستعمارية إليها؛ لكنّ معظم تلك النصوص نُشرت محقَّقةً بسبب إدراك الدارسين لأهميتها الذاتية الثقافية والسياسية والحضارية، وموقعها على خريطة التراث العربي والإسلامي. فبالإضافة إلى ما ذكرناه وللقيمة الذاتية قام المستشرق الألماني فرديناند فستنفلد (Ferdinand Wüstenfeld) (1808-1899) بنشر السيرة النبوية لابن هشام وتواريخ مكة للأزرقي، ومعجم البلدان لياقوت. وانطلق الهولندي ميخائيل دي غويه (Michael Jan de Goeje) (1836-1909) تلميذ دوزي الذي كتب في تاريخ المسلمين في إسبانيا- انطلق من النصوص الفيلولوجية إلى النصوص التاريخية والجغرافية، فنشر فتوح البلدان للبلاذري، ثم «المكتبة الجغرافية العربية» في عشرة أجزاء.
بيد أنّ إنجاز دي غويه الأهمّ يظلُّ إشرافه وتنظيمه ومشاركته في نشر تاريخ الطبري في خمسة عشر مجلداً على مدى ثلاثين عاماً. وقد شاركه في ذلك زملاء كبار مثل نولدكه وفلهاوزن، لكنه ما اطمأنّ إلى عمل أيٍ منهم إلا بعد مُراجعةٍ دقيقة. وكل نشرات الطبري اللاحقة بمصر ولبنان خلال قرن، مستنسخات من هذه النشرة. ثم إنّ كارل إدوارد ساخاو (Carl Eduard Sachau) (1845-1930) قام بنشر طبقات ابن سعد مع تلامذته. وقد شاع في العقود الأخيرة عن المستشرقين أنهم على الرغم من نزوعهم الفيلولوجي، ليسوا بارعين في نشر المخطوطات الشعرية والأدبية. لكنّ هذا الحكم أو الانطباع لا يسري على كبارهم مثل الوارت ولايَل وغاير، الذين نشروا عشرات الدواوين الشعرية. ولا ينطبق على الآخرين الذين نشروا المعاجم والمؤلفات اللغوية والأدبية مثل الكامل للمبرد، والاشتقاق لابن دريد، والأغاني، والرسائل القديمة في مسائل لغوية. وما نشروا الكثير من المؤلفات الفقهية؛ لكنّ ما نشروه منها كانت نشراته دقيقةً وواضحةً في التكشيف والفهرسة ودراسة سائر المخطوطات، والتدقيق في طرائق القراءة والتحقيق. وإذا كانت نشراتهم للنصوص الفقهية قليلة نسبياً؛ فإنهم اهتموا كثيراً بنشر النصوص الفلسفية ودرسوها باعتبارها دليلاً على التواصل الإسلامي مع الحضارة اليونانية والأخذ عنها، وهو الأمر الذي يقع في أصل النهوض الإسلامي القديم! وليس المقصود هنا إحصاء ما نشر أو ذِكْر الناشرين. إذ إنهم نشروا مئات المخطوطات بالفعل، والآلاف من الدراسات والمقالات عنها[8].
من الفيلولوجيا إلى التاريخ الثقافي والدولة والحضارة
ما كانت هذه النشرات الكثيفة من جانب المستشرقين لذخائر التراث العربي، والتي تأسست عليها دراساتٌ وبحوثٌ واسعة، مصادفةً أو اندفاعاً غير واعٍ. فالتاريخانية (Historism) (بالألمانية Historismus) كانت منهج المناهج في العلوم الإنسانية، وهي تقوم على الفيلولوجيا والتاريخ المستند إلى تحليل وتركيب النصوص الفيلولوجية. وقد داخلتها الإنسانويات منذ عصر النهضة في القرن السادس عشر من جهة، ومسألة هوية أوروبا المتفرعة على الزمنين اليوناني والروماني. والمعروف أنّ الدرس الكلاسيكي للمعارف والعلوم يقوم على علوم اللغة وفقهها (النحو والبلاغة والشعر والمنطق)؛ وهكذا أقبل الغربيون أو الأوروبيون وقتَها وفي زمني النهضة والأنوار على تتبع دثائر حضارتيهم الكلاسيكيتين -والباقي منهما قليل- بالاكتشاف والتحقيق العلمي والنشر. ولذلك وعندما انفتحوا على الحضارات الأُخرى سلكوا المنهج نفسه، فأقبلوا على اللغات اليابانية والصينية والهندية لاكتشاف حضاراتها، كما أقبلوا على الدثائر العربية، والتي كانت حاضرةً عندهم في المكتبات الوطنية في باريس وبرلين ولندن ولايدن وميلانو وروما. وكما سلكوا مع مخطوطاتهم ودثائرهم القليلة الباقية من أيام اليونان والرومان، بالجمع والفهرسة والتكشيف وتقدير قيمة التراث المخطوط، تمهيداً للنشر؛ كذلك أقبلوا على إنشاء المكتبات ووضع الفهارس للمخطوطات العربية بأوروبا ثم بحيدرأباد والقاهرة… إلخ. وتبعاً للنهج التاريخاني نشروا المؤلفات اللغوية والأدبية أولاً، ثم التاريخية والجغرافية، ثم الفلسفية. ولا ينبغي أن يغيبَ عن البال أنّ المؤلفات العربية في الطب والفلك والرياضيات والكيمياء، كانت معروفةً لديهم منذ القرن الثالث عشر وما بعد، وقد استخدموها في جامعاتهم حتى القرن السابع عشر. ولذلك، وفي مرحلة الاستشراق «العلمي» والتي تحدثنا عنها، وفي أقلّ من خمسين عاماً حدثت تطورات عدة بارزة[9].
أول تلك التطورات اكتشاف أنّ الحضارة الإسلامية بلغاتها الرئيسة: العربية والفارسية والتركية، هي أغزر الحضارات على الإطلاق في الدثائر المكتوبة. ولذلك ولكي يمكن فهمها وتشخيصها لا بد من نشر دثائرها الكبرى، والتي أفْضت إلى الاقتناع بسرعةٍ بأنها حضارةٌ كبرى مكتملة العناصر، ولا بد من كتابة تاريخٍ ثقافي وآخر ديني وثالث سياسي لتلك الحضارة. والتطور الثاني أنه لا بد في التعامل مع هذه الحضارة من الخروج من إسار العهدين القديم والجديد من جهة، ومن الربط بينها وبين الحضارات الآسيوية القديمة في البحث والتقميش من جهةٍ ثانية[10]. وقد كتب أستاذنا جوزف فان إس (Josef van Ess) دراسةً بعنوان: «من فلهاوزن إلى بيكر: ظهور اتجاه التاريخ الثقافي»[11]. والذي أراه أنه فيما بين فلهاوزن وبيكر هناك ألفرد فون كريمر الذي كتب في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر عن الأفكار السائدة في الإسلام الكلاسيكي، وعن المؤسسات التاريخية في الدولة الإسلامية. كما كتب مارغليوث في تاريخ العرب الأدبي[12]. إنما البارز عند فلهاوزن هو أنه كتب دراسةً عن الجماعة الإسلامية الأولى بالمدينة (1889)، ثم نشر عام 1901 كتابه: «تاريخ الدولة العربية وسقوطها». كان فلهاوزن إصلاحياً بروتستانتياً، واعتنق فكرة الدولة القومية الألمانية في زمن بسمارك. وقارن بين التاريخ القومي الألماني، والتاريخ القومي العربي إذ اعتبر النبي محمداً (صلى الله عليه وسلم) مؤسساً للدولة العربية، كما اعتبر الأُمويين مكملين لهذه المهمة. وفي العقد الثاني من القرن العشرين، ونتيجة هذه التطورات كلها دعا المستشرق الألماني كارل هاينرش بيكر (Carl Heinrich Becker) إلى إنشاء علم الإسلام الذي يستوعب المسألتين: الثقافية- الحضارية، والسياسية. وكما كان فلهاوزن هو رسول الدولة القومية في كتابه عنها؛ فإنّ تلميذاً لألفرد فون كريمر هو آدم متز (A. Metz) نشر عام 1922 أُطروحته بعنوان: «نهضة الإسلام»، وكان قد كتبها قبل عقدٍ على ذلك. وقد قام محمد عبدالهادي أبو ريدة بترجمتها في الأربعينيات إلى العربية بعنوان: «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»[13].
اعتنق النهضويون العرب أفكار التقدم والاستنارة من مصدرين: الثورة الفرنسية، والتفكير الفرنسي في القرن التاسع عشر من جهة، والتاريخانية والعمل العلمي من أجل النهوض على طريقة المستشرقين من جهةٍ ثانية. وقد التقى هذان الاتجاهان كما هو معروف في فكر وعمل الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873)، الذي درس عند سلفستر دي ساسي (1826-1831)، وكتب مذكراته المشهورة: «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، وترجم الدستور الفرنسي من جهة، وتعلم من دي ساسي الرجوع الكثيف للتراث من أجل النهوض الذاتي، كما نهض الأوروبيون على نوستالجيا وإنتلجنسيا اليونان والرومان وزمن النهضة والأنوار. ونحن نعرف أنّ محمد عبده (1849-1905) تبنّى هذه التوجهات وشجّع نشر المعاجم والنصوص الأدبية، وأسس جمعيةً لبناء جامعة أهلية في مصر أُنشئت بالفعل بعد وفاته عام 1908. وقد تغير اسمها مراراً إلى أن تبنتها الدولة فصار اسمها جامعة فؤاد الأول، وهي منذ الخمسينيات جامعة القاهرة. وقد بدأ المصريون ثم الهنود والشوام يحضرون مؤتمرات المستشرقين منذ العام 1895، واستعانوا بهم بكثافةٍ في الجامعة المصرية لتدريس مواد الحضارة والتاريخ الإسلامي بطرائق المستشرقين. وقد أفادوا منهم في طرائق نشر المخطوطات وطوروها. وفي العام 1932 جاء لتدريس طرائق نشر المخطوطات المستشرق الألماني برغشتراسّر. في حين كان المصريون وبعض الشوام قد بدؤوا نشر المخطوطات العربية الأدبية والتاريخية منذ الربع الأول من القرن العشرين، وبشكلٍ مستقلٍ تارةً، أو ضمن قسم نشر التراث بدار الكتب المصرية، أو على أيدي الأساتذة والمثقفين القريبين من كلية الآداب أو دار الكتب. وإلى جانب النشرات الفاخرة لدثائر التراث بدأت مشروعات التاريخ الثقافي والتاريخ الحضاري بتعاونٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ مع المستشرقين. فكتب مصطفى صادق الرافعي في تاريخ الآداب العربية، وكتب جرجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي. وتلاقى طه حسين وأحمد أمين وعبدالحميد العبادي عام 1926 على كتابة التواريخ الفكرية والأدبية والسياسية للإسلام، ونفّذ أحمد أمين حصته من المشروع في «فجر الإسلام»، و«ضحى الإسلام»، وقام شوقي ضيف تلميذ طه حسين بإنفاذ القسم الأدبي – وأنجز حسن إبراهيم حسن تلميذ العبادي التاريخ السياسي للإسلام. وقد ذكرنا من قبل مشروع «المعجم الكبير في مجمع اللغة العربية»، وقد تعاون معهم فيه الألمان والذين كانوا يحاولون كتابة معجم تاريخي للغة العربية أيضاً. أما في دمشق فقد ظهر المجمع العلمي العربي الذي ترأسه محمد كرد علي، وقد اشترع المنهج النهضوي نفسه: نشر التراث، والكتابة في التاريخ الثقافي للعرب والإسلام، والعلاقات الوثيقة مع المستشرقين والتبادل الثقافي معهم[14].
على أنّ هذه الاندفاعة وهذا التلاقح والتبادل بين الأدبيات الاستشراقية والأدبيات العربية، كانت لهما حدودهما أيضاً. فلنلاحظ أنّ قرن ازدهار الحضارة الإسلامية في أعمال المستشرقين هو القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ويرجع ذلك إلى الاستمداد من الحضارة العقلانية اليونانية. ومن وجهة نظر معظمهم فإنه عندما تراجع تأثير الحضارة اليونانية والترجمات بعد القرن الخامس الهجري؛ ونتيجة ظهور تيارات متشددة ضد «علوم القدماء»؛ فإنّ الجمود سرى إلى جسد الحضارة الإسلامية بالتدريج، ثم كان الانحطاط بعد القرن الرابع عشر الميلادي. لقد كان الزمان في حقبة ما بين الحربين وما بعدهما هو زمن البحث عن النهوض الذاتي وعن الأصالة، ومكافحة تأثير الغريب لدى شعوب العالم الثالث. ولذلك فإنه في مقابل التعظيم من شأن الحضارة الكلاسيكية اليونانية وضرورة الاستناد إليها في عمليات النهوض القومية والوطنية الجديدة؛ فإنّ النهضويين المصريين والعرب (باستثناء طه حسين وبعض تلامذته) هجموا على هذه النزعة التي كان يقودها بالقاهرة باول كراوس وماكس مايرهوف، وعمل الشيخ مصطفى عبدالرازق (- 1947) خُطاطةً مختلفةً للإبداع الإسلامي وضع فيها الفلاسفة المسلمين في آخر القائمة[15]: علماء أصول الفقه فعلماء الكلام فالصوفية فالفلاسفة المسلمون. وبالطبع ما كانت نزعة بعض المستشرقين صحيحة، ولا كان الأصاليون محقّين. فالمستشرقون نقلوا مقولة «العصور الوسطى» المظلمة عن مثيلتها الأوروبية. فما بين القرن الخامس للميلاد والقرن الخامس عشر، حدث انحطاط أوروبي للانقطاع عن مواريث اليونان والرومان، بسبب سيطرة الإقطاع والمسيحية. وكذلك حدث عند المسلمين، فعندما تراجع تأثير الفلسفة الكلاسيكية دخلت «العصور الوسطى» الإسلامية!
لقد عملت مدرسة الحوليات الفرنسية منذ الثلاثينيات من القرن العشرين على نقض مقولة انحطاط العصور الوسطى الأوروبية. ومنذ عقودٍ عدة ما عاد أحدٌ معتبرٌ يقول بها في أوساط كبار المؤرخين[16]. وهناك تيارٌ قويٌّ في أوساط الدارسين الغربيين اليوم يذهب باتجاه نقض مقولة العصور الوسطى الإسلامية، أبرز مفكريه الأستاذ توماس باور من جامعة مونستر (Münster) وقد أصدر عام 2018 كتاباً بعنوان: «لماذا لم تكن في الإسلام عصورٌ وسطى؟»[17] وهو مهتمٌّ بنقض مقولة الانحطاط الإسلامي خلال ألف عام[18].
كلُّ ذلك لم يكن معروفاً ولا واضحاً في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. وكان تيار الأصالة مزيجاً من القومي والوطني والإسلامي، وظهر الصراع حتى وسط طلاب الشيخ مصطفى عبدالرازق. ثم تسلّم زمامه الإسلاميون حزبيين وغير حزبيين فما بقي أحدٌ إلاّ وكتب في إدانة الاستشراق والمستشرقين. وقبل أن يتسلّم زمام قيادة اتجاه الأصالة اليساريون ونقّاد الخطاب الاستعماري (إدوارد سعيد)، كتب أُستاذنا الدكتور محمد البهي مؤلفه الشهير: «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» (1957-1959)، ووضع له ملخصاً عنونَ له: «المستشرقون والمبشرون المعادون للإسلام»؛ ذكر فيه زُهاء مئةٍ منهم. وقد أزعج ذلك الأستاذ فرتز شتبّات المستشرق الذي كان يعمل بالملحقية الثقافية بالسفارة الألمانية بالقاهرة، وكان محمد البهي صديقاً له -كما أزعج ذلك الأستاذ رودي باريت (Rudi Paret) كما أخبرني بعد ذلك في السبعينيات عندما ذهبت للدراسة بألمانيا- وظلَّ شتبات يذكر ذلك «الجرح العميق» الذي لا يستحقه المستشرقون، إلى أن أصدر كتابه عام 2004: «الإسلام شريكاً»[19]!
فيما بين الخمسينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ومع تزايُد القطيعة بين المستشرقين والعرب والمسلمين[20]، مرةً لاتهامهم بالتبشير، ومرة لاتهامهم بمخامرة الاستعمار؛ كان الاستشراق بمعناه الكلاسيكي الذي تحدثنا عن تطوراته خلال أكثر من قرن، يشهد آخِر نهضاته: ظهرت دراسات جديدة عن النبي وعن القرآن انفكّت من إسار تبعيتهما للعهدين ولأنبياء بني إسرائيل من مثل كتب مونتغومري وات ورودنسون وبل وباريت. وظهرت دراسة لويس ماسينيون العظيمة عن الحلاّج وبحوثه الأُخرى، وكتب هلموت ريتر (ناشر مقالات الإسلاميين للأشعري) كتابه الزاخر: بحر الروح عن فريد الدين العطار. وكتب فرتز ماير كتبه التحليلية الدقيقة عن التصوف. وكتب هنري لاووست وتلميذه جورج مقدسي دراساتهما الرائعة عن الحنبلية. وظهرت دراسات لابيدوس عن المدن الإسلامية، ودراسة أندريه ريمون الكبرى عن القاهرة، ودراسة أليسييف عن نور الدين وصلاح الدين، ودراسة مارشال هودجسون العظيمة: «تجربة الإسلام: الوعي والتاريخ في حضارةٍ عالميةٍ» (1972)، ودراسة هاملتون غب وبوون عن السلطنة العثمانية، ودراسات جيماريه عن المعتزلة والأشعرية. ودراسات فرانك عن الأشعرية. ودراسات جورج مقدسي عن الجامعات الإسلامية وإنسانويات الفكر الإسلامي.
وكان العام 1978 حاسماً بالفعل. فبالمصادفة ظهرت فيه ثلاثة كتب: «الاستشراق» لإدوارد سعيد، و«دراسات قرآنية» لوانسبورو، و«الهاجرية» لباتريشيا كرون ومايكل كوك. اهتمّ إدوارد سعيد بنقد ونقض خطاب الاستشراق باعتباره خطاباً استعمارياً. وذهب وانسبورو إلى أنّ القرآن ما كان موجوداً خلال القرن ونصف القرن بعد ظهور الإسلام. وقالت كرون وقال كوك: إنّ الرواية الإسلامية التقليدية عن ظهور الإسلام وعن القرآن غير صحيحةٍ على الإطلاق، لأنّ الوثائق المكتوبة تأخرت لقرنين؛ ولذلك لا بد من الاعتماد على الكتابات السريانية والعبرية والأرمنية والبيزنطية من القرنين السابع والثامن، والتي تشير إلى أنّ الإسلام كان في أول عهده فرقةً يهودية!
المراجعون الجدد والإسلاميون الجدد
شهد عقد الستينيات والسبعينيات متغيرات بارزة، خيمت ظلالها على الملفّ الإسلامي كله، ومن ضمنه الدراسات الإسلامية في الغرب. فالحرب الباردة الثقافية كانت لا تزال مستعرة. وفي الحرب الباردة الفعلية تقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل (بخاصة بعد العام 1967). والإسلاميون على اختلاف فرقهم صاروا أحزاباً وحركاتٍ شعبية مضت من خلال الحاكمية إلى الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة. وفي الفترة نفسها كانت علوم نقد النصّ والعلوم الاجتماعية والإنسانية تشهد ثوراتٍ لجهات البنيوية والتأويل والبحوث الميدانية والحملات على الأيديولوجي، ومن جهةٍ أُخرى استخدام تلك التوجهات الجديدة في نقد الخطاب الاستعماري، وقضايا المعرفة والسلطة. وأذكر أنه في العام 1974 انعقدت ندوةٌ بالكويت موضوعها الأزمة الحضارية في العالم العربي، شارك فيها كبار المثقفين العرب، وقد أجمعوا على أنّ الموروث الإسلامي هو العقبة الكأداء في وجه دخول العرب في الحداثة.
وهكذا فإنّ هذا الموروث بحمولاته الدينية والفكرية والثقافية، واجهته جبهات عدة: جبهة الإسلاميين التأصيلية، التي تريد القفز من الكتاب والسنة إلى الأزمنة الحاضرة لرؤيةٍ جديدةٍ وأصيلة. والتقى معهم المفكرون العرب دون أن يشعروا لإحساسهم -كما قالوا- بوطأة التاريخ وانحطاط الألف عام. وجاء إدوارد سعيد ليسدّ الحيِّز الضيق الذي كان كلاسيكيو المستشرقين لا يزالون يمثلونه. وقد هجم سعيد على برنارد لويس وما مثّله من استشراقٍ سياسيٍّ صهيوني فاقع على الرغم من ضخامة إنجازاته قديماً في مجال الدراسات الإسلامية. لكنْ كان هناك آخرون كثيرون شعروا بالظلم الشديد. وقد استمروا في الإنتاج (مثل جيماريه وفان إس ومادلونغ)، كما كان هناك دارسون شبان وكهول انصرفوا لمصارعة المراجعين الجدد، دون أن يكونوا مع سعيد أو ضدّه. وكانت وجهة نظري منذ العام 1979 أنه تأتي محطات في العلاقات بين الحضارات، تتطلب كشف حسابٍ ومراجعة[21]، وربما كان في عمل إدوارد سعيد شيءٌ من ذلك. بيد أنّ المستشرقين ليسوا مسؤولين بالفعل عن رؤية أو رؤى الإسلام في الغرب، ويبدو لي أننا نحن دارسي الإسلام أفدنا من أعمالهم أكثر مما أفاد منها الغربيون. وكانت هناك انتقادات محقة لإدوارد سعيد، من مثل أنّ كثيرين ممن ذكرهم ليسوا مستشرقين وكانوا موظفين في الإدارات الاستعمارية، وأنّ آخرين ممن ذكرهم متهماً، ما كان لهم دورٌ حقيقيٌّ في إنشاء الدراسات الإسلامية أو تطويرها. وانزعج بعض الألمان لأنّ سعيداً لم يذكرهم ويتذكر إنجازاتهم، وخصوصاً أنهم ما كانوا من أنصار الإمبريالية لأن دولتهم لم تكن كذلك. لكنّ المؤرخة الأمريكية سوزان مارشاند (Suzanne Marchand) في كتابها: «الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية» (2009) [22] ذكرت أنهم لا يختلفون كثيراً عن مستشرقي الدول الأوروبية الأُخرى. وعلى أي حال فإنّ آخرين ذهبوا إلى أنّ المشكلة مع غرب الدولة الحديثة والاستشراق[23] (إن لم يوسَّع معناه)، ضئيل القيمة في ذلك.
على أنّ مشكلة إدوارد سعيد شيء، ومشكلة المراجعين الجدد شيءٌ آخر. فقد أراد هؤلاء العودة إلى نقطة الصفر، كأنما الدراسات الإسلامية تبدأ الآن. والمقولة السائدة لديهم أنه عند ظهور الإسلام وإلى قيام الإمبراطورية الإسلامية، ما كانت هناك وثائق مكتوبة. ولذلك لا بد من الاعتماد على كتابات الأمم الأخرى من ذلك الزمان، على الرغم من الشحّ وعدم الاهتمام. حتى إذا بدأت الكتابة في الدين والتاريخ عند المسلمين بعد منتصف القرن الثاني الهجري؛ فإنّ هؤلاء رأوا أن الطرفين اشتركا: العلماء والأُمراء في اصطناع صورةٍ أو صُوَرٍ للنبوة والقرآن والإسلام الأول. ولذلك ينبغي النقد والتفكيك. بل إنّ البعض منهم ما قبلوا أن تكون كتب مثل الأم للشافعي والخراج لأبي يوسف والأموال لأبي عُبيد من أواخر القرن الثاني، وأنها كانت مسوّدات أنجز تلامذتهم مبيضاتها في القرن الثالث وما بعد!
وعلى أي حال، ولأنّ نزعة المراجعة الراديكالية هذه بدأت بالقرآن إثباتاً لعدم وجوده، وربما عدم وجود النبي في مرحلة ظهور الإسلام، فسنعرض لذلك بإيجازٍ بقدر الإمكان:
قاد الراديكالية الأولى ضد القرآن الدارس البريطاني جون وانسبرو (John Wansbrough) في كتابيه: «دراسات قرآنية» (1977)، و«بيئات متشرذمة» (1978). وهو يرى أن النبي لم يدون شيئاً، فبقيت قِطَعٌ من القرآن في ذاكرة وصحف أصحابه والتابعين. وتعرضت تلك القطع للتقليل والتكثير والتحرير والحذف والإثبات، وما استقر النص القرآني وصار ثابتاً وقانونياً إلا في القرن الثالث الهجري[24]!
وفضلاً عن أنّ لدينا في العقدين الأخيرين عشرات الرقوق والألواح والأخشاب والآيات المثبتة على المسجد الأقصى والجُدُر، وكلها من القرن الأول؛ فإنّ الإجماع على النص القرآني واعتباره قانونياً (Codification) ما كان يمكن أن يتم لا أيام الأمويين ولا أيام العباسيين لتعذُّر الإجماع على ذلك بعد انقسام الأمة. فلا بد أن يكونَ جمع القرآن وتقنينه قد حصل أيام النبي[25]، أو أيام عثمان بحسب الرواية المعتمدة[26].
أما التفكيكية الراديكالية[27] الثانية فقد ذهب إليها اللاهوت الألماني غانتر لولنغ (Günter Lüling)، وهو يرى أنّ النبي ربما كان مسيحياً أبيونياً وفي بيئة ورقة بن نوفل، وترجم أناشيد دينية قبطية أو حبشية صارت بعد إعادة صوغها هي القرآن! ودليله على ذلك وجود ألفاظ حبشية كثيرة في القرآن، وأنه يمكن الكشف عن تلك العناصر تحت الطبقة العربية اللاحقة.
أما كريستوف لوكسنبرغ (Christoph Luxenberg) (وهو مسيحي لبناني سرياني اتخذ اسماً مستعاراً) فقد قال بالأصول السريانية المباشرة للقرآن، وأن النبي تعاون مع كُتّاب مسيحيين، وكان سيصبح كاهناً للمسيحية الأبيونية لولا هجرته إلى المدينة. والأبيونية صيغة يهودية- مسيحية من القرون الأولى للمسيحية عندما كانت لا تزال مختلطة باليهودية.
أما فرضية وانسبرو فهي جديدة نسبياً، وتتّسم بعدم الوضوح. في حين تعود الفرضيات الأُخرى إلى إسار القرن التاسع عشر ذاته، أي الأصول اليهودية أو المسيحية للقرآن. وفي حين تقول الأمريكية باتريشيا كرون (Patricia Crone) بالأصل اليهودي للقرآن، يظلُّ معظم الآخرين الذين ذكرناهم مع الأصل المسيحي، وهي مسيحيةٌ خاصةٌ يقال إنها كانت موجودة بالجزيرة. وما كان القرآن غير ترجمة في الأصل ثم جاءت التغييرات وجُهلت المعاني، وظهرت الطبقة العليا للنصّ وعليه.
وهذه الأمور بالطبع أَوهام، وقد تخلّى عنها كثيرون بعد الثمانينيات والتسعينيات. لكنها كانت شديدة الضرر لسببين: الأول، تنشئة عشرات الشبان الدارسين عليها، بحيث ألحقت أضراراً كبيرةً بالدراسات القرآنية، وقد بدا ذلك في «موسوعة القرآن» (2001-2014) والتي تعرض مواد ومقالات لأهل نزعة النفي ونزعة الإثبات في حين ما وقعت دائرة المعارف الإسلامية في نشرتها الثالثة تحت هذه الوطأة. أما السبب الثاني للضرر فهو الانتشار الواسع خارج الدوائر الأكاديمية في النشرات والمجلات والصحف السيارة والفضائيات. وهكذا اقترنت بالإسلاموفوبيا، وصار القرآن لدى غير المتخصصين بين أسباب ظهور التطرف والإرهاب.
تتبلور في العقود الثلاثة الأخيرة ثلاثة اتجاهات يعتبرها البعض تصحيحية، والبعض الآخر تجديدية أيضاً. أُولى تلك النزعات بدأتها دارسة القرآن المعروفة أنجليكا نويفرت. وقد عملت كثيراً على السُوَر المكية. وهي متأكدةٌ أنّ القرآن ما تعرض للتحريف، وأنّ المرحلة الشفوية تقتصر على ما بين وفاة النبي (ص) والجمع العثماني. وفي العقد الأخير انضمّت أنغليكا نويفرت إلى دارسين آخرين في الكتابة عن القرآن والعصور الكلاسيكية المتأخرة (فيما بين القرنين الرابع والسابع للميلاد)، باعتبار أنّ القرآن ينتمي إلى «الدين الواحد» الذي يتحدث عنه القرآن ذاته.
أما النزعة الثانية، والتي يعمل عليها عشرات شبان وكهول الدارسين في الجامعات الغربية، وبعضهم من أصولٍ عربيةٍ ومسلمة، فتذهب إلى العودة للأسس والأصول المخطوطة، وتداخُل المجالات في الثقافة الإسلامية الوسيطة. وقد بدأت طلائع هذا النزعة في أعمال الدارس الألماني غريغوار شولر (Gregor Schoeler)[28] وهارالد موتسكي (Harald Motzki) (1948-2019). وقد عمل الرجلان على الشفوي والكتابي في صدر الإسلام، وسعياً لإثبات أنهما متلازمان. وكتب موتسكي دراسةً ممتازةً عن الفقه المكي في القرن الأول الهجري[29]، كما كتب عن السيرة النبوية ومدارسها، وردَّ على جوزف شاخت الذي سبق أن زعم أنه لا علاقة للكتاب والسنة بنشوء الفقه الإسلامي. ويعمل الدارس الألماني الثالث توماس باور على تصحيح الانطباع عن العصور الوسطى الإسلامية. وأنها ما كانت عصور انحطاط، وقد ذكرنا ذلك له من قبل. أما الدارس الكبير وائل حلاّق (أستاذ الإسلاميات في جامعة كولومبيا) فقد كتب كثيراً في الفقه الإسلامي وأصوله واتجاهاته، ومصائره في الأزمنة الحديثة وفي حين يدعو إلى تجاوُز الاستشراق[30]، ويأخذ على إدوارد سعيد أنه كان مزاجياً وما كان راديكالياً بما فيه الكفاية؛ يعتبر أنّ العلة في الدولة الغربية الحديثة والتي طحنت الحضارات والثقافات الأُخرى ومنها الإسلام.
إلى ذلك أُشير في القول بأنّ هناك نزعةً ثالثةً ترى أساس الداء في الدولة الحديثة ونظام العالم الحديث، أما الاستشراق، وأما التصورات النافية، فهي مسائل جزئية وهامشية تسبب بها نظام العالم نفسه.
في الأعوام الثلاثة الأخيرة حاضرتُ مراتٍ عدة في إعادة بناء الدراسات الإسلامية الأكاديمية، لأنني اعتبرت أنه ما بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ فإنّ الدراسات الإسلامية ذات الأبعاد التاريخية والحضارية، حوصرت تماماً بين نزعتين: النزعة الإسلاموية التي ما عادت ترى موضوعاً للدراسة غير علائق الدين بالدولة وتطبيق الشريعة، ونزعة المراجعين الجدد التي تريد نسْخَ الإسلام الأول كله، وتعتبر أنّ الدين الذي ظهر في زمن الإمبراطورية في القرن الثالث، هو صناعةٌ من جانب النُخَب الدينية والسياسية[31].
ما كان إدوارد سعيد بالطبع هو أول من تحدث عن تأزم الاستشراق وعدم جدواه بل وأضراره. فقد تحدث عن ذلك في الستينيات كلٌّ من عبدالله العروي وأنور عبدالملك. أما العروي فذكر ضآلة القيمة المعرفية في كتابه «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» ، وما يحدثه الاستشراق من اغتراب؛ في حين ركّز أنور عبدالملك[32] على مركزيةٍ غربيةٍ تتجلى في خطابات الاستشراق عن العرب والإسلام والشرق، وكتب عن الاستشراق وأوهامه عبداللطيف الطيباوي بمنهجٍ مختلف؛ بيد أنّ نقد سعيد القاسي كان متابعةً متطورة لمقاربة أنور عبدالملك.
وفي عامي 1981-1982 أصدرتُ بمجلة الفكر العربي عددين عن الاستشراق لدراسة آثار حملة إدوارد سعيد، وماذا يمثل الاستشراق بالنسبة للغرب وبالنسبة لنا بالفعل. والذي أراه أن النقد العربي والإسلامي للاستشراق ظلّ خارجياً، وسواء أكان الناقدون الناقضون إسلاميين أو يساريين. ولذلك فإنّ «أزمة الاستشراق» لم تظهر أو لم تتبين إلا عندما ظهر المراجعون الجدد الذين تصدّع على أيديهم بالفعل كل ما كان المستشرقون خلال قرنٍ يعتبرونه إنجازاً لهم. لقد انفجر الاستشراق باعتباره تخصصاً معرفياً من الداخل.
في الإسلاموفوبيا ودور الاستشراق
بين يديَّ كتابان، الأول للأستاذ فخري صالح بعنوان: «كراهية الإسلام، كيف يصور الاستشراق الجديد العرب والمسلمين» (2016). والثاني عنوانه: «رُهابُ الإسلام، الإسلاموفوبيا»- لمجموعة من المؤلفين (2016) أيضاً. يدرس الأستاذ فخري صالح أعمال ثلاثة كتّاب باعتبارهم من المستشرقين الجدد، ويشير إلى دورهم في تسعير لهيب كراهية الإسلام وهم: برنارد لويس، دارس الإسلاميات المشهور، وصموئيل هنتنغتون الأستاذ والكاتب السياسي والاستراتيجي، وف.س. نايبول الروائي الحاصل على جائرة نوبل في الآداب. أما لويس فهو مستشرقٌ مشهورٌ، وهو صاحب مقالة: جذور الغضب الإسلامي (1990) التي اعتمد عليها هنتنغتون في فرضيته حول صِدام الحضارات. وقد تابع لويس تدخله إبّان أحداث 2001 وما بعدها بنشر كتبٍ صغيرةٍ شعبية من مثل: «كيف حدث الخلل»، و«أزمة الإسلام».
أما هنتنغتون فليس له دراساتٌ في الإسلام، لكنه صاحب فرضية «صدام الحضارات»، والتي يعني بها الإسلام في صدامه مع الحضارة اليهودية- المسيحية في الأزمنة الحديثة. ونايبول كذلك نشر كتباً عن رحلاته في بعض بلدان العالم الإسلامي، واشتهر بتحليلاته السلبية للمسلمين والإسلام. وقد لقيت رحلاته مثل كتب لويس الأخيرة، انتشاراً واسعاً في العالم الغربي. أما لويس فقد هاجمه إدوارد سعيد بشدة في الاستشراق (1977)، وردّ عليه لويس وتجادل معه في مقابلةٍ مشهورة. وفعل الشيء نفسه أستاذ معروف للدراسات الشرق أوسطية بجامعة نيويورك هو زاكاري لوكمان[33]. فلا شكّ أنّ لويس مستشرق، وأنه بخلاف كتبه حتى السبعينيات أسهم في تدعيم الأفكار التي بدأت تسودُ عن الإسلام منذ التسعينيات بل وقبل ذلك. وهي ليست كتباً أكاديميةً في هذه المرحلة، بل تقصد للتأثير في الرأي العام المثقف، وفي أنظار الإعلاميين والاستراتيجيين، وأصحاب القرار. وهو عندما كتب ما كتبه ما كان يعتبر نفسه مستشرقاً، بل اعتبر نفسه خبيراً في الإسلام والمسلمين، كما هو معروفٌ عن أدوار الخبراء ووظائفهم مستشارين للحكومات أو للفضائيات ومراكز البحوث التي ترمي للتأثير في أوساط المثقفين، وفي قرارات العاملين في الشأن العام. ولذا فإنّ الأمر هنا يتعلق بدورٍ سياسيٍ واستشاري بدأ المستشرقون وكذلك أساتذة الدراسات الشرق أوسطية يلعبونه. وهذا معروفٌ عن جيل كيبيل وفرانسوا بورغا وأوليفيه روا وهؤلاء جميعاً من الأساتذة والخبراء الفرنسيين.
لكن ماذا نعتبر هنتنغتون ونايبول؟ أما هنتنغتون فكان مؤثراً في أوساط اليمين بالولايات المتحدة، وقد أثرت فرضيته الشهيرة كثيراً على أصحاب القرار، لكنْ هل يمكن اعتباره مستشرقاً؟ إدوارد سعيد اعتبر كل من كتب عن الإسلام بغضّ النظر عن اختصاصه داخلاً تحت مفهوم الاستشراق، بمعنى أولئك الذين لهم اهتماماتٌ ونظراتٌ وكتاباتٌ عن العرب والمسلمين، وشاركوا في تكوين الرؤى لدى الخاصة والعامة في هذا المجال. وعلى هذا القياس يمكن النظر إلى الروائي والرحّالة نايبول باعتباره مستشرقاً، حتى لو لم يعرف شيئاً عن الإسلام أثناء دراساته بالجامعات البريطانية. فإدوارد سعيد اعتبر الرحّالة وموظفي الإدارات الاستعمارية «مستشرقين» لأنهم كتبوا عن الشرق المسلم، ولو لم يعرفوا شيئاً حقيقياً عن الإسلام. إذن لدى البعض مثل لويس ننظر إلى الاختصاص وإلى التوظيفات. أما لدى الآخرين غير المتخصصين بالإسلام لكنهم كتبوا عنه وعن المسلمين وأثروا في مجتمعاتهم، فنعتبرهم من حيث التوظيف -على الأقلّ- من المستشرقين.
إنما المشكلة هنا أنّ المستشرقين الأكاديميين ما كان من طبعهم ولا من قدراتهم على العموم تقصُّد التأثير في أصحاب القرار، ولا في الرأي العام. هناك –إذن- نوعٌ جديدٌ من الاستشراق المسيَّس أو السياسي. وقد ظهر إلى جانب الاستشراق التقليدي الذي استمرت نتاجاته الأكاديمية، دون أن يأبه لما يفعله المستشرقون الجدد. لكن وفي لفتةٍ أخيرة: لماذا الاستمرار في إطلاق لقب «المستشرق» على أُناسٍ ما تأسسوا في مجال الدراسات العربية والإسلامية، ولماذا لا نسميهم خبراء أو أي اسمٍ آخر، بغضّ النظر عن ميولهم، وهل هي مع العرب والمسلمين أو ضدّهم[34]؟!
ولنصل إلى السؤال الأخير: ما هو أو ماذا كان تأثير المستشرقين المتخصصين القُدامى أو الجدد في موجة الإسلاموفوبيا أو كراهية الإسلام؟
لنعُد إلى الكتاب الثاني الذي ذكرناه في بداية هذه الفقرة. هناك بضع عشرة محاضرة مجموعة في كتاب: رُهاب الإسلام، الإسلاموفوبيا. ومعظم المحاضرين بندوة الدوحة (2016) هم من السوسيولوجيين أو أساتذة التاريخ أو دراسات الشرق الأوسط. وهم يُثبتون أنّ ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تقتصر على أوروبا أو أميركا أو أوستراليا، بل هي تمتد إلى الصين والهند وألبانيا ذات الغالبية المسلمة! وما ذكر أحدٌ من الباحثين كتاباً لمستشرق أو خبير، أثر في الظاهرة. بل يذكر الكاتبون الهجرة واليمين الجديد والصورة النمطية للإسلام، والتحول الاستراتيجي لليمين الأوروبي المتطرف، والاختلاف في العادات والتقاليد الدينية والأخلاقية والاجتماعية. فالمسألة –إذن- ليست في الاستشراق الجيد أو السيئ؛ بل في أنّ الأزمة المتفاقمة في العلاقات بين العرب والمسلمين من جهة، والعالم من جهةٍ أُخرى، دفعت إلى الساحة متخصصين وخبراء ومتسلقين وانتهازيين ومتعصبين، وذوي توجهات استراتيجية للإفادة من اللحظة. وما تدخل فيها ممن يمكن اعتبارهم مستشرقين إلاّ القليل، أما المتدخلون الآخرون فتقودهم المصالح أو يقودُهُم فَقْدُها، وينسبون ذلك إلى عللٍ حقيقيةٍ أو وهمية. فالمسألة في الوعي أكثر مما هي في الواقع[35].
الخاتمة
وفي الختام أودُّ الملاحظة، أنه بسبب اتساع المجال، والنقائض في الأسماء والإضافات، والتخالُف والتفاوُت؛ ذلك كلُّه، يدفع باتجاه اعتبار الاستشراق بالمعنى الذي كان متعارفاً عليه حتى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، قد مضى وانقضى بحقّه وباطله. لقد قلتُ في خاتمة كتابي: المستشرقون الألمان (2007): «لقد انتهى الاستشراق بالمعنى المتعارف عليه.. أما أبناء جيلنا ممن نالهم شُواظ تلك الخنزوانات الساحرة؛ فلا تزال النوستالجيا الحارقة تؤرق عقولهم وأعينهم التي نال منها الكلل دون أن يسيطر عليها الملل»[36]: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
[1] كاتب وأكاديمي لبناني.
[2] قارن بتحرير أنجليكا نويفرت وزملاء:
Im vollen Licht der Geschichte, Die Wissenschaft des Judentums und die Anfänge der Kritischen Koranforschung 2008).
ونيكولاي سيناي:
Abraham Geiger and Theodor Nöldeke; op.cit. 145-154.
وانظر عن القرآن في عصر النهضة والأنوار:
H. Bolzin: Koran in der Zeitalter der Reformation, 1995.
[3] قارن مع الدراسات الأخرى فيما بين غايغر ونولدكه، كتابي: المستشرقون الألمان، النشوء والتأثير والمصائر: دار المدار الإسلامي ببيروت، 2007، ص24.
[4] قارن بذلك: «ترجمة عربية لتاريخ القرآن لنولدكه»؛ في كتابي: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص109-115.
[5] انظر:
Andrae, Tor: Mahomet, Sa vie et sa doctrine (1984).
نبيل فازيو: الرسول المتخيل: قراءة نقدية في صورة النبي في الاستشراق: منتدى المعارف ببيروت، 2011.
[6] يوهان فك: تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين. نقله عن الألمانية عمر لطفي العالم: دار المدار الإسلامي، بيروت 2001، ص 205-209.
[7] يوهان فك: تاريخ حركة الاستشراق، مرجع سابق، ص168، ورودي باريت: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية منذ تيودور نولدكه. ترجمة مصطفى ماهر: القاهرة 1967، ص15-18، 99-107، ورضوان السيد: التراث العربي في الحاضر: النشر والقراءة والصراع: إصدارات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 2014، ص83-89.
[8] قارن عن ذلك، رودي باريت: الدراسات العربية، مرجع سابق، ص99-107، ورضوان السيد: التراث العربي في الحاضر، مرجع سابق، ص86-89.
[9] قارن عن التاريخانية ورؤيتها للعالم، ودور الفيلولوجيا والتاريخ في مناهجها:
Friedrich Meinecke: Die Enstehung des Historismus, 1965, PP. 585-646.
وعن تأمل المؤرخين والمستشرقين للميراث المخطوط:
Walter Berschin: Lachmann und der Archetyp; in Theoretical Approaches to the Transmission and Edition of Oriental Manuscripts (ed. Pfeiffer, Kropp). Beirut 2007, PP. 251-258.
[10] رودي باريت: الدراسات العربية، مرجع سابق، ص15-18، ورضوان السيد: التراث العربي في الحاضر، مرجع سابق، ص82، ورضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص41-42.
[11] Joseph van Ess: From Wellhausen to Becker, the Emergence of Kulturgeschichte in Islamic Studies; in: Islamic Studies (ed.M. Kerr), 1980, PP.27-52.
[12] رضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص27-28، ص41-45.
[13] المرجع نفسه، ص59-65.
[14] رضوان السيد: التراث العربي في الحاضر، مرجع سابق، ص89-93، ومحمود محمد الطناحي: أوائل المطبوعات العربية؛ في: ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر، المجمع الثقافي بأبوظبي 1986، ص355-438.
[15] مصطفى عبدالرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (1944)، ص118-136.
[16] قارن بجاك لوغوف: هل وُلدت أوروبا في العصر الوسيط؟ تعريب وتقديم: محمد ضاوي ويوسف نكادي، 2015.
[17] homas Bauer: Warum es kein islamsches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient. C.H.Beck, 2018.
وانظر عن ذلك مراجعةً لي بعنوان: مسألة العصور الوسطى الأوروبية والإسلامية؛ في مجلة التفاهم العُمانية، العدد (63)، 2019، ص381-391.
[18] قام (Bauer) بذلك في كتابه: Die Kultur der Ambiguität, Eine andere Geschichte des Islam, 2017، وهو مترجم إلى العربية بعنوان: ثقافة الالتباس، نحو تاريخ آخر للإسلام. ترجمة: رضا قطب، منشورات الجمل ببيروت 2017. وهناك مؤلفات سابقة في ازدهار الثقافة الإسلامية الوسيطة لغوستاف فون غرينباوم وفرانز روزنتال (ومعظمها مترجَم). وقد تُرجم أخيراً كتابٌ لروزنتال عن الازدهار العلمي الإسلامي هو: Knowledge Triumphant: The concept of knowledge in Medieval Islam, 2007. وعنوان الترجمة العربية غامض وهو: العلم في تجلٍّ، مفهوم العلم في الإسلام في العصور الوسطى: المركز العربي ببيروت، 2019. وكنتُ قد ترجمتُ لروزنتال بالاشتراك مع الزميل المرحوم معن زيادة كتابه: مفهوم الحرية في الإسلام، 1978. بيد أنّ كلَّ هذه المؤلَّفات ما كانت تحمل الوعي الجديد بأنّ الإسلام الوسيط لم يشهد انحطاطاً. بيد أن هذا الوعي كان حاضراً عند الأستاذ الراحل جورج مقدسي (من جامعة بنسلفانيا)، والذي كتب عن ظهور الجامعات، وعن الإنسانويات الإسلامية.
[19] صدر بالمعهد الألماني ببيروت بالألمانية، وفي سلسلة عالم المعرفة بالكويت بالعربية من ترجمة الدكتور عبدالغفار مكاوي.
[20] قارن بذلك دراستي: ما وراء التبشير والاستعمار: ملاحظات على النقد العربي للاستشراق؛ في كتابي: سياسيات الإسلام المعاصر، دار الكتاب العربي، بيروت، 1997، ص 323-337.
[21] انظر عن ذلك دراستي: استشراق إدوارد سعيد وعلاقات الشرق بالغرب؛ في كتابي: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص143-158.
[22] Suzanne L. Marchand: German Orientalism in the Age of Empire: Religion, Race and Scholarship,2009. وقد قمت بترجمة الكتاب إلى العربية بمعاونة بعض الزملاء، وسينشر بالمركز القومي للترجمة بالقاهرة عام 2019.
[23] هذه وجهة نظر الأستاذ وائل حلاق في: الدولة المستحيلة (2013)، وقصور الاستشراق (2018).
[24] قارن بذلك دراستي: جوانب من الدراسات القرآنية الحديثة والمعاصرة في الغرب؛ في رضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص93-108؛ وخصوصاً ص99-102.
[25] هذا رأي جون بيرتون في The Collection of the Coran, 1977.
[26] هي الرواية الإسلامية التقليدية، والتي ما قبلها معظم المستشرقين.
[27] رضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص102-107.
[28] تُرجم من أعماله: الكتابة والشفوية في بدايات الإسلام. ترجمة رشيد بازي: المركز الثقافي للكتاب، 2016.
[29] تُرجمت إلى العربية عام 2004.
[30] معظم دراساته مترجمة إلى العربية خلال السنوات العشر الماضية، وهي تحظى بشهرةٍ واسعة. وأهمها لدى العرب اليوم: الشريعة 2009 (تُرجمت 2018)، والدولة المستحيلة (2013)، وقصور الاستشراق (2018).
[31] ألقيت في الموضوع ثلاث محاضرات: ما هي الدراسات الإسلامية، الماضي والحاضر والمستقبل (2017)، وفيلولوجيا التاريخ والمستقبل وإمكانيات الإسهام في إعادة بناء «دراسات الإسلام» (جامعة برلين، 2017)، والدراسات الإسلامية: التصدع وإمكانيات إعادة البناء (بالجامعة الأميركية ببيروت، عام 2018).
[32] الاستشراق في أزمة: مجلة ديوجين، 1963.
[33] راجعت كتاب زاكاري لوكمان: الرؤى المتنافسة للشرق الأوسط، تاريخ الاستشراق وسياساته؛ في رضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص159-164.
[34] يقول إدوارد سعيد في الاستشراق (ص24): «قد تكون أهم المهام على الإطلاق هي إجراء دراسات في البدائل الراهنة للاستشراق، والتساؤل عن المنهج الذي يمكن للمرء من خلاله دراسة الثقافات والشعوب الأُخرى من منظور متحرر من الكبت والمناورة. بيد أن المرء سيحتاج إلى إعادة التفكير في مشكلة المعرفة والقوة المعقدة برمتها». ويأخذ وائل حلاق (في: قصور الاستشراق، ص256) على سعيد أنه لم يعد لذلك مطلقاً، ويعتبره قصوراً منه. وربما كان يعتبر كتابه هذا معالجةً للمشكلة (بين المعرفة والقوة) لتجاوز قصور سعيد وتقصيره، لكنه هو أيضاً وسط تعقيدات المعرفة والقوة التي أعجزت سعيداً ما وجد بدائل غربية للاستشراق، ويحسب الأمر مستحيلاً!
[35] عندي محاضرة طويلة غير منشورة، وهي موجودة على الموقع، ألقيتُها في الجنادرية في شتاء العام 2016 عنوانها: رؤى العرب والإسلام في المخيلة الألمانية. وقد تحدثت فيها عن إشكاليات الوعي والواقع أو الوعي بالواقع.
[36] رضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص89.