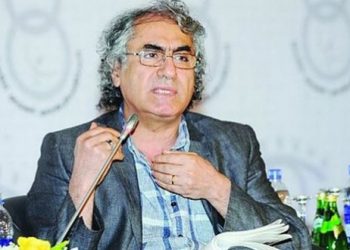آدم غارفينكل ([1] (Adam Garfinkle، خاص بمركز المسبار من سنغافورة
تتفنّن شدائد النوازل والأزمات وعظائم النوائب والملمّات أيّما تفنُّن في إظهار أسوأ ما في البشر وأفضل ما فيهم سواءً بسواء -كأفراد وجماعات وأمم بأكملها، بل وعلى مستوى الإنسانية نفسها، حسب نطاق الأزمة أو حجم المُلِمَّة؛ وهي بذلك تكشف النقاب عن التمايز الشديد في السلوك–فالبعض نبيل وأصيل، والبعض خسيس وغثيث لا خير يرجى منه، والبعض بين هذا وذاك؛ مما يطرح سؤالاً مطْلقاً بلهجة حادة ليست معهودة في الأوقات العادية: أياً كان الحال، مَنْ نحن على وجه الدقة والضبط، كما نرى أنفسنا، كجنس بشري؟
ليس ثمة جديد في هذا الشأن؛ إذ يعود تاريخ الجائحات على أقل تقدير إلى عام 3550 قبل الميلاد، وقد حلّت وقتها في مصر. ومما لا مراء فيه أن العديد من الجوائح الأخرى وقعت قبل أول جائحة حوتها سجلات التاريخ المكتوب. وفقاً للفكر الديني الذي كان سائداً آنذاك وظل مسيطراً لردحٍ من الزمن فيما بعد، يُنْظَر إلى تلك النوازل وأمثالها في العادة بأنها “ابتلاءات (tests)”: فهل هذه النازلة عقوبة إلهية حلّت بنا بسبب سيئاتنا وذنوبنا وآثامنا؟ وهل يستحق بعضنا، على الأقل، الكفارة من الذنب؟ وهل مآلات الأمور ومصائر المخلوقات برمَّتها قد اختص بها الخالق سبحانه وتعالي –رب العزة والجلال– وفق سننه الكونية، أم إن لنا دوراً في تشكيل المستقبل -بمقتضى الاستخلاف- وفق السنن الشرعية التي تقع بأمره تبارك وتعالى مع اتخاذ الوسائل المشروعة؟
لا يزال بالإمكان حتى الآن تفسير الشدائد والأزمات بأنها ضرب من ضروب الابتلاء، ولكن في كثير من الأحيان في يوم الناس هذا يكون التفسير من قبيل ما كُتِبَ من وحي الحداثة بسطْوتها وهيلمانها الطاغي: هل الجنس البشري بطبيعته ميّال للانقسام ونزّاع للانشطار والعنف وحتى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية [علماً بأن نظرية انقراض إنسان النياندرثال (theory of Neanderthal extinction) لا تفضي على وجه الدقة والضبط إلى الجزم والحتم والتأكيد في هذا الخصوص]؟، أم إن بمقدور الجنس البشري أن يحقق التقدم الأخلاقي والمادي على حد سواء؟ وهل يمكن لنا أن نرتقي إلى مستوى أفضل للجوانب الخيّرة في جوهر طبيعتنا البشرية أو نرقى إلى “أفضل مستوياتنا الملائكية (betterangels)” كما قال أبراهام لينكولن ذات يوم، أم إنه محكوم علينا أن نعيش لحظات سيد الذباب “(lord of the flies)” ونقاسيها لحظة تلو الأخرى إلى أن نستأصل أنفسنا ونجتثها من على وجه البسيطة في نهاية المطاف؟ وهل يميل منحنى التاريخ حقاً نحو اتجاه العدل والتسامح والاستنارة بفضل جهود بشرية وئيدة ولكنها أكيدة على مر الأزمان؟ أم إن الأمر ليس كذلك؟
ظلت مثل هذه الأسئلة تثير جدالاً بين الفلاسفة كما كانت المناقشات بشأنها سجالاً بين علماء الدين في جميع المجالات الحضارية المتمثلة في مظاهر الرقي والتطور، واستمر الحال على هذا المنوال لألف عام. أما في الوقت الحاضر، فنستطيع أن نمعن النظر في تلك المجالات والمظاهر مستأنسين بمعطيات العلوم ومتسلّحين بمنجزاتها، بدءًا من علم وظائف الأعصاب (neurophysiology) إلى علم النفس المعرفي (cognitive psychology) وعلم أصل الإنسان “الأنثروبولوجيا” (anthropology) وعلم التاريخ. ولكن إلى أي مدى يمكن أن نستفيد حقاً من العلوم في هذا الصدد؟ فلئن كان من الممكن للعلوم الطبيعية والاجتماعية أن تُنْبئنا عن الحاضر (أي عما هو كائن في الوقت الراهن)، فإن علم التاريخ –كصيغة تجريبية تفسيرية أُخْضِعَتْ للتصفية والتنقية من الشوائب- يمكن أن يُنْبئنا عن الماضي (أي عما كان). ولكن وفقاً لما اشتهر به “ديفيد هيوم (David Hume)” من قول، فإن العلوم لا تستطيع إنباءنا بما يجب أن يكون (أي ما ينبغي أن يكون). ليس هنالك مقاييس تجريبية تطبيقية للاستدلال والتسويغ الأخلاقي، ولكن من دون ذلك لا يمكن أن توجد نماذج للحياة الاجتماعية والسياسية.
تعد صيغ الاستدلال ومقاربات التسويغ الأخلاقي في واقع الأمر من صميم الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) –فهي في القلب من تلك الأزمة. لا ينصبُّ اهتمامنا فقط على ما هو حقيقي وصحيح بالمعنى الطبي وحسب تعريف علم الوبائيات، وإنما أيضاً على ما هو ليس بصحيح وغير حقيقي من تدابيرنا وترتيباتنا الاجتماعية والسياسية، ولكن ذلك ينبغي أن يكون كذلك. فالفيروس نفسه سينحسر ويمضي إلى حال سبيله حسب الوقت والمسار المناسبيْن، تماماً كما انحسرت جميع الجائحات الباكتيرية والفيروسية ومضت إلى حال سبيلها؛ فهو ليس تهديداً وجودياً للبشرية جمعاء بالمعني الحرفي للعبارة، وإنما هو محض ألم ممض وجرح غائر في قلوبنا وأرواحنا. أما مصدر قلقنا فهو يتعلق في المقام الأول –الآن أو في القريب العاجل- بإحباطاتنا وخيبة أملنا في المؤسسات المحلية والوطنية والعالمية الحالية، واختلافاتنا حول مَنْ ينبغي أن يُنْحى عليه باللائمة من أشخاص، أو ما ينبغي يُنْحى عليها باللائمة من جهات حيال أوجه القصور والسوءات التي ظهرت أخيراً، وما إذا كان هنالك أي شيء يمكن القيام به بشأنها، ومَنْ ينبغي أن تكون لديه الصلاحية والسلطة لإنفاذ تلك التغييرات.
بعبارة أخرى، حال فهمنا لحدود المعرفة التجريبية والتطبيقية في التعامل مع ما يقع بالفعل على حافة الخطر المحدق الداهم، سنرى أن المسلّمات العَقَدِيَّة هي التي تشكِّل الأساس الممكن الوحيد لمسيرنا ومسارنا المستقبلي. وقد لا يكون من المهم إن أطلقنا عليها مسمى المسلّمات الدينية أو الفلسفية أو اللاهوتية أو العلمانية. ولعل ما هو أكثر مما نود الإقرار به أن التصنيفين، وإن كانا غير متطابقين، كلاهما مبني على أساس عَقَدِيٍّ وليس على أساس علمي.
يترتب على ما تقدم أنه لما كانت الفضاءات التعبُّدية والأطر العَقَدِيَّة تختلف من ثقافة لأخرى، تماماً كما تتفاوت مع مرور الوقت داخل الثقافات نفسها، غاب الإجماع وأصبح غير منعقد بيننا كجنس بشري على تسلسل هرمي واحد لمنظومة القيم، فلم نعُد نتنادى إلى كلمة سواء بيننا في هذا الصدد. ويفضي التغاير وعدم التجانس في مقارباتنا إلى تفريخ الخلافات والصراعات وتفجيرها، فضلاً عن التعاون الانتقائي على المصالح المتقاطعة من حين لآخر. وبطبيعة الحال هذا هو الدأب دائماً؛ إنها الطبيعة البشرية التي تقتضي أن تكون موجبات التعاون بيننا كبشر أقوى وأوثق كلما كنا أقرب وألصق فيما بيننا مثوىً ومأوىً وصداقةً وقرابةً، وأن تكون بواعث التنافس أقوى كلما صرنا أقرب إلى من نَصِفُهم بأنهم أفراد الجماعات الخارجية. ويكون ذلك أوضح ما يكون عندما تبدو الأوضاع أكثر خطورةً، تماماً عندما تكون حينما ندرك أن خطْباً جللاً ألمّ بنا.
هذه الملاحظة البسيطة من شأنها أن تساعدنا على تكييف السؤال الكبير المطروح أمامنا كما يلي: كيف يمكن لنا اغتنام فرصة أزمة “كوفيد -19” وعدم تفويتها؟ إننا نقف على أعتاب مرحلة مفصلية فارقة في التاريخ، وهي أيضاً مرحلة سيولة في الأوضاع بحيث أصبحت احتمالات التغيير أكثر بكثير مما كانت عليه في الأوضاع العادية. لقد أضحت الخيارات متاحةً أمامنا على جميع مستويات النظام الاجتماعي في كوكبنا الأرضي؛ حتماً، سوف نتبنى تلك الخيارات بطريقة أو بأخرى، وبوعي منا أو من دونه، سهواً أو عمداً، وبذهن شارد أو بخطأ ينمّ عن ارتباك.
وهكذا يمكن النظر إلى أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) فيما بعد، عند الالتفات إلى أحداث الماضي، بأنها نقطة تحول فاصلة، عندما يكون الناس قد تمكنوا في نهاية الأمر من التغلب على العقبات الكؤود، التي اعترضت سبيل بناء عالم أكثر أمناً وأماناً وعدلاً وتسامحاً ورفقاً ورحمةً ورأفة ورِفاءً ورَخاءً وازدهاراً؛ أو يمكن النظر إليها بأنها كانت عاملاً محفزاً للإسراع بانزلاق البشرية إلى الهاوية وإغراقها في غياهب عصور مظلمة جديدة. تتبلَّل الخيارات التي أمامنا بقطرات ندى المسؤولية الدافئة -على الأقل بالنسبة لمن يؤمنون بمفهوم الوكالة البشرية (human agency) “أي قدرة الفرد على أن يتصرف بشكل مستقل ويتخذ قراراته بإرادته الحرة”.
بيد أننا بينما ننهض كلّنا بأعباء مسؤولية جماعية ملقاة على عواتقنا جميعاً عن مستقبل العالم، فنحن لسنا جاهزين بطريقة منظَّمة لممارسة صلاحياتنا بمقتضى الوكالة البشرية المشار إليها أعلاه “كمجتمع دولي” واحد يكون على قلب رجل واحد كما يود الكثيرون أن يتخيلوا وجوده. يمكننا بكل حال توضيح ما يبدو لنا أنه مجموعة من الأفكار الجيدة لتحقيق الإصلاح في غضون ساعة واحدة؛ ومن ثم، وفي مواجهة حالة تقاطع المصالح وعدم تجانس القيم على غرار ما ورد آنفاً، نُمْضِي العمر كله في محاولة تنفيذ فكرة واحدة فقط من تلك الأفكار وإخراجها إلى أرض الواقع –دونما أدنى ضمان لأي نجاح.
وأنا أكتب هذه السطور، يواجهنا تحدٍّ آخر: لا يزال الوقت مبكراً في هذه الأزمة، وهنالك الكثير الذي لا يزال مجهولاً لدينا. صحيح أننا نعلم أن عهد فيروس كورونا (كوفيد -19) لن يمتد لمجرد بضعة أسابيع أو أشهر لأننا نتوقع بالفعل تطوراته في أربع مراحل متتالية:
المرحلة الطبية/الوبائية، والمرحلة الاقتصادية، والمرحلة الاجتماعية السياسية داخل الدول، كل على حدة، والمرحلة الجيوسياسية بين الدول. بعد أن يكتمل التسلسل، ستتداخل الجوانب الأربعة وتتدافع مجتمعةً كما الأمواج في المحيط. ما من أحد يستطيع أن يتخيّل كيف ستبدو هذه العملية المتسلسلة خلال ثلاثة أشهر قادمة، دعك عن أن يتخيلها بعد سنة من الآن.
تمثِّل هذه الحالة المتجذرة الموغلة في اللبس والغموض وعدم التأكّد جزءًا من السبب في أن الوقت بدا طليق السراح ومطلق العنان –إذ نشعر جميعاً بما يلي: أن الوقت يمضي سريعاً كما البرق ويتهادى بطيئاً كالمتثائب؛ وذلك في آنٍ معاً. هذا لا يمكن أن يحدث، ولكنه حادث بالفعل. لقد أُخِذْنَا على حين غرة إلى مجاهل الارتباك والذهول، وعَقَدت الحيرة ألسنتنا منذ آخر مرة ظهر فيها عمودي هذا في مكانه هذا في شهر مارس (آذار). وقد اشتدت الأمور وعَمَّ الكرب والضيق وبلغت القلوب الحناجر منذ الظهور الأسبق لعمودي هذا في اليوم الثاني من شهر فبراير (شباط). ففي ذلك اليوم كان مَنْ يعيشون في شرق آسيا، وتحديداً في أوهان وما حولها بالصين، يعانون بالفعل من وباء الإنفلونزا؛ إلا أن العالم على نطاقه الأوسع لم يكن وقتها مدركاً لطبيعة فيروس كورونا ودرجة خطورته. وقد كانت الآمال المتعلقة باحتواء الفيروس آمالاً واقعية حتى وفقاً لتقديرات العديد من الخبراء. وبحلول اليوم الثاني والعشرين من شهر مارس (آذار)، لم تَعُد الأحوال كما هي: فقد ضربت الكارثة أطنابها شمالي إيطاليا ثم تشعبت فانتشرت فاستشرت في بقية أرجاء أوروبا وأمريكا الشمالية، ثم إيران والكثير من دول منطقة الشرق الأوسط. وقد أُطْلِق عليها مسمى “كوفيد -19” وأُعْلِنت كجائحة عالمية الانتشار. أما الطبيعة الغادرة الماكرة لناقلات العدوى عديمة الأعراض، فسرعان ما بدأت تظهر وتتبدى للعيان. وأما معدلات الإصابة بالعدوى والوفيات، فقد ارتفعت بصورة جنونية وبلغت عنان السماء. وأما القيود الصارمة التي فُرِضَت على الرحلات الجوية الدولية، وكذا التدابير والإجراءات شديدة القسوة والمتعلقة بالتباعد الاجتماعي والإغلاق، فقد تم تطبيقها أينما كانت هنالك منطقة مأهولة في جميع القارات، وإن تفاوتت درجة صرامة تلك التدابير والإجراءات من منطقة لأخرى. وأما الأسواق، فقد عصفت بها الأزمة وأصابها الدمار في مقتل؛ كما أن الآثار الاقتصادية الوخيمة لتفشي الجائحة ما لبثت أن بدأت تظهر، ولو على مُكْث.
وأنا أكتب هذه السطور في اليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل (نيسان)، كانت التداعيات الاجتماعية والسياسية للأزمة قد ألقت بظلالها وأرخت سدولها بالفعل على المستوى الوطني –أي على مستوى الدول كل على حدة. أما عن كيف ستبدو الأشياء، دعنا نقل: في اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو (حزيران)، دعك عن المستقبل مع مرور الوقت، فلا يسعنا إلا أن نطرق باب الحدس والتخمين.
كيفية التفكير في القادم
ما يمكن أن نفعله الآن، على الأقل، هو دراسة كيفية تفاعل الناس مع الأزمة، ورد فعل كل منهم تجاهها، لأن هذا سيخبرنا بالمستقبل بأكثر مما يخبرنا به أي وصف لحقائق الواقع الطبي أو الاقتصادي. فمن خلال تفاعلنا ورد فعلنا تتشكّل المرآة التي تتجلى فيها طبيعتنا الحقيقية كبشر في أوقات الشدة والقهر، والمآلات التي من المحتمل أن تقودنا إليها طبيعتنا البشرية. هنالك ثلاثة جوانب هي الأهم في التفاعلات وردود الفعل تجاه الأزمة الحالية. دعوني فقط أوضحها لكم ومن ثم أتحدث باختصار عن كل منها.
أولاً: ينزع جميع الناس على جميع مستويات المجتمع وعبر جميع المجتمعات –من قادة وزعماء سياسيين ومثقفين ورجال أعمال وصُحُفِيين (أو صحافيين) وعلماء دين وكل شخص آخر– إلى النظر إلى المشكلات الناجمة عن الجائحة وفقاً لشروط ومصطلحات يفهمونها مسبقا، واستناداً على ميولهم وتوجهاتهم الأيديولوجية التي يعتنقونها أصلاً. إن التفكير بشكل جديد؛ وغير مسبوق أو التفكير الكلي الشامل بخصوص تهديد مستجد، ليس أمراً سهلاً بأي حال. قلّة هم الذين سيتمكنون منه ويتقنونه، وبالتأكيد في الوهلة الأولى عندما يكون هنالك غَبَش في الرؤية وحالة من التيه والارتباك؛ مما يؤدي إلى التشويش في الرأي.
ثانياً: هنالك الدرجة العالية من النزعة الانفعالية الجيّاشة، التي عادةً ما تعتري الكثير من الناس بشكل طبيعي في مثل هذه الأوقات، مما يفضي إلى التطرف الشديد في الأفكار وفي التوقعات على السواء، ولا سيما ما هو مُنْبَتٌّ منها عن هموم الواقع. ولئن كان بعض الناس متفائلين بشدة في الوقت الحالي، إزاء ما يمكن أن تأتي به هذه الجائحة إلى العالم من منح قد تولد من رحم المحن، ونِعَم قد تنطوي عليها نِقَم، فإن آخرين يتوقعون “نهاية العالم”، قولاً واحداً. أما العديد من ذوي النفوس المتزنة والأمزجة المعتدلة والمواقف المنضبطة، فهم يقاومون مثل تلك النُّذُر التي لا تبقي ولا تذر؛ ولكن، ومما يدعو إلى الاستغراب الشديد، يظل من الوارد في مثل هذه المنعطفات التي تكتنفها الشكوك ويشوبها الغموض، أن يصار إلى تهوين مفهوم الاعتدال والتفريط فيه، كما يصار إلى تهويله والإفراط فيه، سواء بسواء. لقد جادل البعض بأن الأزمات التي تظهر في هيئة جائحات لا تغيّر الواقع بقدر ما أنها تسرّع من وتيرة التوجهات القائمة أصلاً، والتي يشهد الواقع على وجودها. يبدو ما تقدم صحيحاً بحق وحقيقة؛ وقد كان صحيحاً بالفعل في العديد من الحالات والجائحات التاريخية –مثل الإنفلونزا الإسبانية، ذلك الوباء الوبال الذي ضرب العالم قبل مئة عام ونيف، وتحديداً عام 1919. ومع هذا سيكون من الخطأ أن يُستنتَج من وقائع التاريخ أن التغييرات الكبرى لم تحدث وقتها من جرّاء معايشة التجارب في أزمات الجائحات الأخرى –ويعد الموت الأسود أو الطاعون الأسود الذي تفشى في القرن الرابع عشر مثالاً توضيحياً في هذا المقام. يكمن الفرق فقط في أن الطرق التي أفضت إلى تلك التغييرات قلَّما كانت نتاج جهد مباشر ومتعمّد، وإنما تبلورت في كثير من الأحيان بأسلوب موارب وملتو، لم يكن لأحد أن يتوقعه في خضم الأزمة، دعك من أن يتولى توجيهه في غمرتها.
ثالثاً: كما ورد آنفاً، تشهد أوقات الأزمات مرحلة سيولة وهشاشة في الأوضاع. لذا فهي تستثير كوامن الأفكار المبتكرة وتستمطر سماء الفكر الإبداعي، وتسترفد مكنوناته وتستلزم بناء الأطر والرؤى السياسية. وهي أيضاً توفر للناس الأسباب والذرائع -على حد سواء- للتحرر من المفاهيم والمعتقدات والأعراف والتوقعات الموروثة أو الأثيرة المحببة إلى النفس والعزيزة عليها، وللانعتاق منها وخلع ربقتها من أعناقهم.
أما الإطلالة من نافذة أوفرتون “Overton Window” (نسبةً إلى العالم السياسي جوزيف أوفرتون؛ وهي منهج لوصف الأفكار المقبولة في الخطاب العام)، فهي أسرع بكثير مما هي عليه في الأوقات العادية. وأما الخيارات السياسية التي كان من المفترض ذات يوم أن تكون خارج نطاق المُمْكِن السياسي، فيمكن أن تبدو فجأة بمثابة ضربة لازب تقريباً، فتكاد تصبح من قبيل: ما لا مفر منه؛ ولا مندوحة عنه. وأما الأساليب التي كانت فيما سبق وظلت حتى الآن من الأساليب الاعتيادية لإنجاز الأشياء، فيمكن أن تبدو بين عشية وضحاها من قبيل ما عفّى عليه الزمن، فما تلبث أن تتوارى طي النسيان والهجران. يتنامى الطلب على الخيارات، وحيث إن الطبيعة تستنكف الفراغ، سيترتب على ذلك الطلب ازدياد في العرض. وبكل حال ليست الابتكارات والاختراعات جميعها مفيدة تنم عن حكمة مبتكريها وحنكة مخترعيها. ففي استعار أوار القلق والفزع والهلع، يُقْدِم الناس في أغلب الأحيان على اقتراف أفعال متسرعة ومتهورة ومؤسفة. وقد قالت إيلينا بونر (Elena Bonner) ذات مرة: إن “الخوف يسدي نصائح سيئة”، وكانت محقّة فيما قالت.
تكمن المشكلة هنا، وهنا يكون المحك: إذا سعى الناس أفراداً وجماعاتٍ وأمماً ودولاً إلى التصرف بتناسق وتناغم وانسجام، وإلى اتخاذ التدابير الحكيمة القويمة، يمكن أن نأمل -على الأقل- أن المعاناة في الأزمة لن تضيع سدىً أو تذهب أدراج الرياح. أما إذا سعوا إلى اتخاذ التدابير الفاسدة وغير الملائمة، والتي تنم عن قصر النظر والسطحية والأنانية، فسيكون عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) محبطاً لأي أمل معقول في أي أسباب وجيهة لرفع المعاناة التي تسبب فيها الفيروس، والتكفير عنها. وتكمن المشكلة في أن من الوارد جداً أن تكون الكثير من الخيارات المطروحة على بساط البحث دون المستوى الأمثل، وأقل من المؤمل لدواعي الرؤية النَّفَقِيَّة “tunnel vision” (الرؤية الضيقة التي لا يرى صاحبها إلا ما يريد) ومظاهر الاختلال الانفعالي التي تتبلور من خلالها الخيارات. وهكذا نرى أن الجوانب الثلاثة للتفاعلات المستمرة للأزمة يأخذ بعضها برقاب بعض، فتتجمع معاً لتصبح بمثابة مرآة واحدة. مع هذا دعنا الآن نلقِ نظرة عن كثب إلى كل منها على حدة.
المزيد من الأمر نفسه
يستمر معظم الناس في التفكير بطريقتهم الاعتيادية المعهودة حتى في غمرة أزمة مستجدة. وهذه طريقة مأمونة للتفكير حتى وإن لم تكن مفيدة في كثير من الأحيان. أما في البيئة الأكاديمية في أوساط قبيلة الأكاديميين، فينظر علماء الاقتصاد إلى الأزمة وفق المصطلحات الاقتصادية، وينظر إليها أهل العلوم السياسية بلغة المصطلحات السياسية، وينظر إليها العاملون في مجال العلاقات العامة وفق المصطلحات الجيوستراتيجية وهكذا.
أما في المستويات الأقل درجةً على سلّم الفكر البشري (مقارنةً بالأكاديميين)، فينظر المناهضون للساميّة إلى الأمر برمته على أنه عبارة عن مؤامرة إسرائيلية أو يهودية. وفي الهند، يشن بعض المسلمين غير المتعلمين هجوماً على العاملين في الحقل الصحي الحكومي، متوهّمين أنهم يتعمدون نقل العدوى إلى المؤمنين. وأما بعض القوميين الهندوس، فقد أنحوا باللائمة على المسلمين فيما يتعلق بتفشي الفيروس؛ لرفضهم الانصياع للتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي. وأما الحكام الموتورون المتوترون المتعطشون للسلطة فيما لا يقل عن أربع قارات، والذين يركزون على الأخطار الناجمة عن عدم شرعيتهم كحكام وعدم مشروعية حكمهم، فهم يرون في الأزمة فرصة لقمع الاحتجاجات التي تجتاح الشوارع منددة بهم، والمظاهرات التي تندلع ضدهم في الشوارع؛ وإلا فلعرقلة مساعي قوى المعارضة المزعجة.
ذهب بعض الناشطين من قوى اليمين في الولايات المتحدة إلى الزعم في شهر مارس (آذار) أن فيروس كورونا محض خدعة –مجرد نزلة برد عامة– وحمَّلت “وسائل الإعلام الليبرالية الزائفة” وزر ترويجها لترويع الناس، وقذف الرعب في قلوبهم لكي يتنازلوا عن حرياتهم ويتخلوا عن حقوقهم المتعلقة بحماية الخصوصية، ولتقويض فرص إعادة انتخاب ترمب. وفي الوقت نفسه، ذهب بعض الليبراليين إلى وصف الحظر الذي فرضه البيت الأبيض على الرحلات القادمة من الصين وأوروبا بصفة مبدئية، وإن جاء متأخراً، بأنه حظر مستوحى من دوافع “عنصرية” ومفروض لدواع “تمييزية”.
فضلاً عما سبق بيانه، تتربّع المخاوف الخاصة ونوبات الغضب والضيق في كثير من الأحيان على رأس قائمة الأجندة، من خلال الجمع بين أزمة الجائحة والهواجس التي كانت موجودة قبلها. لذا أصبح أولئك الذين تسنّى إقناعهم -بطريقة صحيحة أو من دونهاـ بوجود ارتفاع حاد في حالات عدم المساواة ينظرون إلى الأزمة بتوجس شديد، من حيث ما تنطوي عليه من مظاهر عدم المساواة. أما المهتمون بالاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، فيرونها دليلاً على الشكل الذي ستبدو عليه أزمة التغير المناخي. وأما “رجل دافوس”(Davos Man) ، هذا هو اللقب الذي أطلقه صاموئيل هنتنجتون (Samuel Huntington) على المناصرين و”الهتّيفة” أو الهتّافة النمطيين وكبار المشجعين لتمدد “الرأسمالية التوربينية أو الرأسمالية المتسارعة (turbo-capitalism)”، فينصرف جل اهتمامه إلى الحرص على ألا تعصف الأزمة بالعولمة، فتفضي إلى تفكيكها بدداً. وعلى النقيض تماماً، يأمل “الشعبويّون (Populists)” ومَنْ والاهم أن تودي الأزمة بالعولمة، فتجعلها هشيماً تذروه الرياح. وإلى مثل هذا يتطلع الحركيون في العالم الإسلامي، والمتعصبون الدينيون أينما كانوا في العالم؛ وذلك لأسباب تخص كلاً منهم فيما يتعلق جزئياً بما تقدم.
كل هذا والكثير غيره إنما يُثْبِتُ أكثر فأكثر، كأنما كانت هناك حاجة للمزيد من أدلة الإثبات، أن الأيديولوجية آفة ذهنية أو علة دماغية (brain disease)، وبصفة خاصة عندما تصاغ بدافع التعصب الأعمى، وفرص التعامل الذاتي الذي تتعارض فيه المصلحة مع الواجب (self-dealing). يظهر أحد أعراض تلك العلة عندما تتصادم المعتقدات مع الواقع؛ والأسوأ بكثير يكون من نصيب الواقع في تلك القسمة الضيزى. لا يبادر الأيديولوجيون إلى النظر أولاً فيما هو مطروح قيد النظر، ثم يعكفون بعد ذلك على وضع التعاريف، وإنما يضعون التعاريف أولاً ثم ينظرون بعد ذلك إلى ما يودون النظر فيه، كائناً ما كان، ثم يصرفون النظر عما تبقى.
ربما كان الأسوأ من ذلك أن الجهل تميل كفته بصورة ساحقة إلى الخلط والتصلب في المواقف والتعصب للآراء، بينما تميل كفة المعرفة إلى التمحيص الدقيق للفروق وإلى مذهب الشك والارتياب. ولأجل هذا يميل الفكر الأيديولوجي بشدة إلى مخاطبة قليلي المعرفة أو ضعيفي الفكر أو إلى الصنفين كليهما؛ لأنه يوفر طريقة اقتصادية (على الرغم من أنه عادةً ما يساء فهمها) لتفسير تعقيدات قد يكون تفسيرها صعباً بغير تلك الطريقة. ولعل أسوأ ما في هذا الخصوص أن الأزمات المستجدة تفضي إلى تعميق ورطة الفكر الأيديولوجي وتُوقُعُه في المزيد من الاضطراب والربكة والرغبة الشديدة في الحصول على إجابات سهلة، تكون أكثر تأثيراً بالمقارنة التقريبية على أساس النسبة والتناسب مع الارتباكات والالتباسات المتزايدة التي تحدثها تلك الأزمات بطبيعة الحال.
لا داعي لأن ينتابنا القلق كثيراً بخصوص تأثير التفكير الأيديولوجي على الأطباء والممرضين وفنيي المختبرات. إنهم حاصلون على التدريب بطريقة أخرى؛ وإنما ينبغي أن نقلق أكثر إزاء علماء الاقتصاد والاقتصاديين، لولا أنهم عادةً ما يكونون ملزمين –إلى حدٍّ ما على الأقل– بما تقوله البيانات. إلا أنه فيما يتعلق بالسياسيين ومؤيديهم في أوساط العامة وعموم الأفراد، فيلزمنا أن نقلق بشدة، بل أن يستبد بنا القلق. فقد قال “تشارلس فرانكل (Charles Frankel) ذات مرة: إن “الأفكار لا ينبغي رفضها مباشرةً عن طريق أخذ الأمور ببساطة بطريقة واضحة كوضوح عدم أخذها بجدِّيَّة، سواء بسواء؛ ذلك أن التفكير البسيط ليس إعاقة في مجال التنافس في الأفكار الاجتماعية…”. وربما كان عليه أن يردف قائلاً، وبصفة خاصة عند حدوث أزمة. أما مؤلف روايات الخيال العلمي فيليب ديك (Philip K. Dick)، فقد كان محقّاً عندما قال ذات مرة: إن “الواقع هو ذلك الذي لا يذهب بعيداً (ولا يختفي) عندما تتوقف أنت عن الاعتقاد بوجوده”. أجَل. ولكن ينبغي للمرء ملاحظة أن الواقع لم يذهب بعيداً وإقناع غير المصدقين بذلك. وهذا أمر لا يحدث بصورة تلقائية أو –في العديد من الحالات– بطريقة سهلة.
المتفائلون والمتشائمون
يفضي نوع من الأيديولوجية أيضاً إلى إضفاء الطابع التفاؤلي والتشاؤمي الحاد للتفسيرات والتوقعات المستقبلية في أثناء الأزمات الكبيرة –إلا أن ذلك يكون مرهوناً بالحالة المزاجية ومحكوماً بها. فلئن كان بعض الناس متشائمين بطبعهم، فإن لآخرين مزاجاً أمْيَل للمرح. وقد قال لنكولن ذات مرة: إن الناس يكونون سعداء بقدر ما يتخذونه من قرار لأن يكونوا سعداء؛ وهذا صحيح إلى حد بعيد. بيد أن ما لم يقله لنكولن يتعلق بالدواعي الموجبة لأن يتخذ بعض الناس قرارهم بطريقة ما، بينما يتخذ غيرهم قرارهم بطريقة مختلفة.
لا مراء في أن الرغبة في رؤية بصيص من نور في الظلام الدامس، أو عسر يحمل بذور يسر أو فرج يسكن في قلب الضيق، هي رغبة تندرج ضمن الخصال الحميدة. ويمكن أن يكون التفاؤل عاملاً مضاعِفاً للقوة ومساراً مفضياً إلى العمل والإنجاز. إلا أنه، كشأن جميع الأشياء الجيدة والخصال الحميدة، لا يعود الإسراف فيها كماً والإفراط فيها كيفاً بالفائدة المرجوة. وكما كتب وولتر ليبمان (Walter Lippmann) ذات مرة، “إن الوقوع في حب الأشياء المستحيلة يعد مرضاً من أمراض الروح”. ذاك ما يبدو أن البعض قاموا به في أثناء هذه الأزمة.
وهكذا فقد زعم أحد المعلقين أن “… جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) التي ضربت العالم سيُنْظَر إليها فيما بعد، عند الالتفات إلى أحداث الماضي، بأنها (المسرِّع العظيم) الذي نقلنا من مواصلة الماضي إلى عهد جديد. وحده الحدث الذي يفضي إلى اقتلاع جميع الأفكار المسبقة، وإلى الانفجار المعرفي هو الذي يستطيع تغيير أوضاع البشر (…) وحدها الأزمات الكارثية والحروب هي التي دفعت المجتمعات في الماضي إلى التصدي بصورة جذرية لموضوع عدم المساواة الاجتماعية أو غياب العدالة الاجتماعية. ينطبق ما تقدم على جميع التحديات الأخرى (…) وفي الوقت المناسب وبدافع الغزيرة الفطرية البحتة المتأصلة فينا كبشر، ستتكيف العوامل الجيوسياسية وتتأقلم حتماً مع طبيعة الميكروبات، وليس العكس فقط“[2].
هنالك مشكلة واحدة فقط في التوقع المذكور أعلاه، هي أنه لا يوجد له أساس تاريخي أو سند من التاريخ. وإلا، فكيف تأقلمت العوامل الجيوسياسية بصورة بناءة ومضطردة مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1919م؟ ومع الحرب العالمية الثانية ومع الهولوكوست؟ وكيف تأقلمت العوامل الجيوسياسية مع الطاعون الأسود أو ما يسمى الموت الأسود في القرن الرابع عشر؟ أو طاعون جستنيان (Justinian’s Plague) في القرن السادس أو الطاعون الذي ضرب أثينا عام 420 قبل الميلاد؟
صحيح أن المجتمعات العلمية والطبية وجدت الدوافع لتحقيق التطور والتقدم بعد الجائحات التي ضربت العالم في القرن العشرين، ومن الوارد جداً أن تحرز مزيداً من التطور والتقدم، مما يكون له عظيم الأثر وحميد التأثير ومفيده؛ ولكن أن يُنظر إلى هذا النوع من التطور والتقدم بأن تداعياته تمتد بالضرورة أو في واقع الأمر “بصورة حتمية” إلى السياسة، دعك عن الأمور الجيوسياسية، فهذا أمر غير مبرر وبلا مسوغ –ذلك أن التعاون الوظيفي ليس له عائد سياسي بالضرورة؛ فهو لا يملي المردودات السياسية؛ وإنما السياسة، بوجهتها نحو الأفضل أو الأسوأ، هي عبارة عن مجال مستقل من مجالات الثقافة البشرية أو الإنسانية. وهي تؤثر في التطورات تماماً كما تتأثر بها في مجالات الثقافة والاقتصاد وحتى العلوم التطبيقية؛ ولكنها لا تسير مع أي منها بإيقاع موحد، ولا تحذو حَذْوَ أي منها حذو القذة بالقذة.
إنه لمن الأمور الجيدة والحسنة لجميع الناس أن يشعلوا قناديل الرجاء، فيأملون في أن يهب “المجتمع الدولي” هبّة رجل واحد لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)؛ وهو من الوارد أن يقوم بذلك ولكن، مرة أخرى، بطرق انتقائية. بيد أنه لما كانت المجتمعات المحلية عبارة عن حقائق اجتماعية وفقاً لتعريف علم الاجتماع، فما “المجتمع الدولي” سوى استعارة مجازية لها. وقد جرت العادة على أن ترقى فائدته إلى ما هو أعلى بقليل من التلويح بالفضيلة من قبل الأمميين الأحرار (liberal internationalists) المخلصين لقضيتهم والأوفياء لها، والذين إما أنهم نسوا أو لم يعلموا قط أن المثالية الأممية أو العابرة للأمم لا تروق لغالبية الناس العاديين، وليس لها أساس ذاتي مستقل على أرض الواقع بمعزل من القوة والسلطة والنفوذ والسمعة للدول التي تتولى الترويج لتلك القيم، كما أن لها تاريخاً يحتوي على ملهيات ومثبطات كارثية من قبيل ميثاق “كيلوج-برياند (Kellogg-Briand Pact)” للعام 1928م (أريستيد برياند هو وزير خارجية فرنسا وقتها وفرانك كيلوج هو نظيره الأمريكي).
أما المتشائمون، فهم متطرفون كالمتفائلين سواء بسواء في هذه الأزمة، ومعرضون بالمثل للمحاسبة على خطئهم. وقد كتب ريموند أرون (Raymond Aron) ذات مرة ما مفاده أن “عادة التنبؤ بالدمار والهلاك تثبت الوضوح أقل من إثباتها للخضوع والاستسلام.”وهي أيضاً تثبت، على الأقل في بعض الأحيان، وجود رغبة غريبة في هدم المعبد فوق رؤوس الجميع بدافع الضغينة والحقد أو الحسد والرغبة الوهمية في العيش في الحياة على نطاقها الأرحب، حتى ولو على وقْع أنغام نهاية العالم. وهذا ينسحب على حالة التشاؤم الشديد إزاء أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) تماماً كما حدث للسنوات ذات العدد في النسخ الأكثر تطرفاً من هستيريا الاحتباس الحراري. وقصارى ما يمكن أن يقال من كلام آخر، أياً كان ذلك الكلام عن الكارثة وأرمجدون (ويوم القيامة) والدمار الشامل المجهول المفضي لنهاية العالم، إنه لن يكون كلاماً مملاً.
هنالك شيء غير واقعي لا تخطئه العين بخصوص التشاؤم الخارج عن حدود المعتاد. فهو ينطوي على لمحة من فكرة فرويد عن ثاناتوس (Thanatos)–الذي يجسد الرغبة في الموت على حد زعم الأساطير اليونانية– على مستوى جماعي؛ وهو في الوقت نفسه ينطوي على قطعة ذات مضامين دينية –يرجى ملاحظة الأوصاف الواردة فيما يسمى سفر الرؤيا (Book of Revelations)؛ ومع هذا فهو أيضاً متناقض مع وظيفة تاريخية رئيسة للمجتمعات الدينية. وهذا يتطلب مزيداً من الاستفاضة لأن بناء الجمل والتركيب اللغوي والجرس والطابع الخاص بالفكر الديني ليس أمراً منقطع الصلة بما نحن بصدده الآن.
يسهل الوقوف على عدم الواقعية من قبل الجماعات الدينية المناوئة للحداثة في يوم الناس هذا. فقد أصر العديد من الوعاظ البروتستانت؛ في الولايات المتحدة على عدم التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي؛ وتجمعوا في الكنائس حتى إن بعضهم أودع السجن في الحال. وقد رفض حاكم فلوريدا ريك دو سانتيس أن يأمر بإغلاق الكنائس؛ لإدراكه لقوة نفوذها السياسي، فادعى أن إغلاقها يعد خرقاً لحقوق الحرية الدينية. وتم ضبط امرأة داخل سيارة في لانسينغ؛ بعد أن رصدتها كاميرا المراقبة بعد أن حضرت “تجمعاً حراً في متشجان” فقالت لرجل الشرطة الذي عاتبها: إنها “اغتسلت بدم يسوع”. وتجاهل الأرثوذكس اليهود أوامر التباعد الاجتماعي في إسرائيل؛ وليكوود ونيوجيرسي وبوروغ بارك؛ فكانت التكلفة الباهظة هي نقل العدوى والوفيات. وهذا هو نفسه ما قامت به جماعات التبليغ في باكستان وماليزيا. أما الراجبوت في الهند فقد أقاموا مهرجاناً لفيروس كورونا في شهر فبراير(شباط) حيث تجمع عشرة آلاف (10000) شخص بزعم أن طائفتهم ستحميهم من المرض.
جميع ما ورد أعلاه صحيح؛ لكن إحدى أقدم الوظائف المنوطة بالسلطة الدينية هي الإقرار بحتمية عدم عقلانية البشر؛ وبصفة خاصة في أوقات الأخطار، مع تقييد عدم العقلانية المذكور وتوجيهه في قنوات مفيدة أو على الأقل غير ضارة. ولأجل هذا فإن التقاليد الدينية؛ تقتضي كسر القواعد التنظيمية وانتهاك القوانين وممارسة السلوك الهزلي في أيام معينة منتقاة –مثل “ماردي جرا (Mardi Gras)” أو يوم الثلاثاء البدين الذي يسبق أربعاء الرماد (يوم الصوم الكبير) في كل عام و”الكرنفال (Carnival)” وفقاً للتقاليد الكاثوليكية، ومهرجان “بوريم (Purim)” أو عيد المساخر حسب التقاليد اليهودية، و”هولي (Holi)” أو عيد الألوان حسب التقاليد الهندوسية وهكذا؛ ولكن حتى كسر القواعد التنظيمية يكون مقيداً بقواعد تنظيمية معينة.
عندما يقفز التشاؤم غير العقلاني متخطياً سياج التقاليد الدينية ورافضاً الانصياع لصلاحيات السلطة الدينية، عندها لن تكون هنالك ضوابط أو قواعد تنظيمية لكبح جماح عدم العقلانية ولجمها؛ وعندما يجد عامل عدم العقلانية أهدافاً سياسية تلفت الانتباه إليه، أغلب الظن أننا سننزلق -على الأرجح- إلى مهاوي العنف، الذي يصحبه جنون العظمة (paranoia-tinged) وتعقبه التبعات الوخيمة التي تكون بطعم الكارثة وبحجمها.
يجدر ملاحظة أنه في الأزمان الأخيرة فقط، نجد أن الهولوكوست، والإبادة الجماعية الذاتية للخمير الحمر (Khmer Rouge) في كمبوديا، والإبادة الجماعية في رواندا، والعديد من حالات الإبادة شبه الجماعية الأقل درجة، المدرجة على القائمة، ليس من الصعب تذكرها واسترجاع شريطها من الذاكرة –هذا فضلاً عن “الفظاعات والأعمال الوحشية الشاملة ضد الأرمنيين”، والمجاعة الأوكرانية التي هي من صنع الإنسان، والقفزة الكبرى أو القفزة العظيمة إلى الأمام (Great Leap Forward) وهي الحملة التي أطلقها ماو تسي تونغ، والمجازر والمذابح الفظيعة في البوسنة والهرسك والكثير غيرها. وكما قال جي كي تشيسترتون (G.K. Chesterton)، “عندما يقْلِع الناس عن الإيمان بالله، لن يؤمنوا بلا شيء؛ بل سيؤمنون بأي شيء”. أما الانسياب الخطير لعدم العقلانية البشرية، فهو ليس مقتصراً على المتدينين التقليديين؛ وإنما تشير معظم السجلات التاريخية إلى النقيض تماماً –ذلك أن الانسياب الخطير لعدم العقلانية البشرية إنما يحد منه المتدينون التقليديون. وقد توقع تشرتشل في إحدى المرات أن تكون الحروب الأيديولوجية أسوأ وأشد ضراوةً وفتكاً من الحروب الدينية؛ وكان محقاً في توقعه. وطالما أن النوعين من الحروب ظهرا على حد سواء، وبصفة خاصة في العالم الإسلامي، ولكن ليس قصراً عليه فقط على وجه الحصر والتحديد، تكون جميع الرهانات والتكهنات قد سقطت.
يترتب الكثير على تبني قراءة تتأرجح بين الإمعان في التفاؤل؛ أو الإيغال في التشاؤم لأزمة “فيروس كورونا” أو “كوفيد -19”. فعلى سبيل المثال، يعتقد أغلب المتشائمين أن دعاة الشعبوية سيستفيدون من الأزمة سياسياً، لأنها ستثبت أن معارضة الشعبويين لكبار سدنة العولمة كانت معارضة مبررة. لقد انهار النظام بأكمله مثل بيت من ورق تداعى؛ وتقوضت أركانه؛ وانهد فوق رؤوس ساكنيه فتأذى من جراء انهياره من كان منهم أسفل الدرك، وتضرروا بشكل غير متكافئ وغير متناسب. أما المتفائلون، فيعتقدون أن أنصار الشعبوية سوف يعانون أيما معاناة من الناحية السياسية، على الأقل في الدول التي توجد بها انتخابات حرة ونزيهة. أما لماذا، فلأنهم أظهروا قدراً ملحوظاً من عدم الكفاءة في التعامل مع الفيروس، وارتكبوا خطأً قاتلاً باستهتارهم وسوء تقديرهم لخطورة الفيروس، واستخفافهم بتلك الخطورة في المراحل المبكرة، فضلاً عن التخلي عن التحلي بروح المسؤولية في صلفهم وعنجهيتهم وعجرفتهم لرفضهم الأخذ بنصائح الخبراء العلميين والطبيين. وكما هو الشأن في العديد من الجوانب المتعلقة بأزمة (كوفيد -19)، فإن الزمن كفيل بكشف المستور. ومن جانبي أتوقع نتيجة مختلطة لهذه التكهنات ولأغلب التكهنات الأخرى المنقسمة على نفسها.
النزعة الانفعالية في أوقات الأوضاع السائبة
فيما سبق، استصدر الدين والتدين، على الأقل كما نعلم من دين وتدين في العقيدة الإبراهيمية، صيغةً تعبدية موحدة، من واقع الحلول في كل شجرة وصخرة وحيوان على وجه الأرض، في فضاء متجاوز للحدود الاعتيادية؛ وكانت الثقافة البشرية محكومة بوعي مشوَّش سكنته الشِّرْكِيَّات واستوطنت فيه الأساطير والأباطيل التي لا أصل لها. فقد حكم السحر واستحكم، ومضت الخرافات تكسر حاجز التحدي وهي لا تلوي على شيء، وكان العلم ضرباً من المحال مبتدأً وابتداءً، كما أن العقلانية في صيغتها الرمزية التي نعرفها اليوم لم يكن لها أي حضور على صفحة الوجود. أما في يوم الناس هذا، فيمكن للعقلانية أن تتعايش مع العقيدة، بل وأن تشد كل منهما من أزر الأخرى. أما في الوعي المسكون بالأساطير والأباطيل والخرافات، فالأمر ليس بالقدر المطلوب.
لطالما وددنا أن نعتقد أن الأساليب القديمة لما قبل العقلانية للإنسان في عهد الجماعات البدائية التي تعتاش على الصيد وجمع الثمار، قد تم تجاوزها تماماً ومرة واحدة وإلى الأبد. أيضاً الأمر ليس كذلك. وفقاً لما أورده إرنست كاسيرير (Ernst Cassirer) في “خرافة الدولة (The Myth of the State)”، الذي اكتمل عام 1944:
حتى في المجتمعات البدائية حيث تسود الأساطير والخرافات وتتحكم في الشعور الجمعي للناس وفي حياتهم الاجتماعية، فهي لا تعمل دائماً بالطريقة نفسها، ولا تظهر دائماً بالقوة نفسها. وهي تبلغ مداها من القوة عندما يكون الإنسان مضطراً لمواجهة أوضاع خطيرة وغير عادية (…) وفي جميع المهام التي لا تتطلب بذل جهود استثنائية وذات طبيعة محددة، ولا تقتضي إظهار شجاعة خاصة أو جَلَد ورباطة جأش، لا نجد أي سحر ولا أي خرافات وأساطير. ولكن يكون للسحر المتطور المرتبط مع الأساطير والخرافات وجود مستديم إذا كان المسلك خطيراً ومآلاته غير مضمونة وغير مؤكدة.
ظهرت في مرحلة لاحقة قوى سياسية واجتماعية أخرى. ويبدو أن بناءً تنظيمياً عقلانياً قد جبّ ما قبله من بنية تنظيمية كانت قائمة على الخرافات والأساطير في المجتمع. وفي الأوقات التي يعمها الهدوء والسلام، وفي فترات الاستقرار والأمن النسبي، يصبح الحفاظ على البناء التنظيمي العقلاني أمراً سهلاً وميسوراً؛ ويبدو مأموناً ومحصناً ضد جميع الهجمات. ولكن في السياسة لم يتم قط تحقيق التوازن المطلوب بصورة كاملة. وما نجده هنا هو عنصر متغير أكثر من كونه توازناً ثابتاً. وفي عالم السياسة، نعيش دائماً فوق ثرى يحتدم في جوفه البركان. ولهذا يجب أن نكون جاهزين للاضطرابات العنيفة المفاجئة التي تباغتنا على حين غرة والانفجارات التي تفاجئنا بغتة.
لم تَعُد العوامل العقلانية التي تقاوم ظهور المفاهيم البالية المفعمة بالخرافات والأساطير تتصف بالقدر اللازم من الكفاءة والموثوقية في جميع اللحظات الحرجة من الحياة الاجتماعية للإنسان؛ لأن الأساطير لم يتم دحرها وقهرها وكسر شوكتها بصورة فعلية…
ينطبق وصف دور السحر والأساطير في المجتمعات البدائية بالمثل على المراحل التي تكون على درجة عالية من التقدم والتطور في الحياة السياسية للإنسان. وفي حالات اليأس والقنوط، يلجأ الناس دائماً إلى الوسائل اليائسة المتهورة –والخرافات والأساطير السياسية تمثل تلك الوسائل اليائسة في يومنا هذا…
لئن كان الإنسان في العصر الحديث لم يعد يؤمن بالسحر الطبيعي، فإنه لم يتحرر بأي حال من الإيمان بضرب من ضروب “السحر الاجتماعي(social magic)”. فإذا كان هنالك شعور جمعي برغبة جماعية في كامل قوتها وجموحها وعنفوانها، أصبح من السهل إقناع الناس بأنها تحتاج فقط للشخص المناسب لينهض بأعباء تحقيقها.
يصبح من الصعب، ومن غير الضروري، إدراج أي إضافة إلى الوصف الذي أورده “كاسيرير”. فقد كان يكتب عن عدم عقلانية الحركات السياسية الفاشيّة بعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، وفي أعقاب الكساد العظيم (Great Depression)، وإثر حالات التفكيك والاضطرابات الشاملة في الثورة الصناعية التي كانت مستمرة في التقدم والتطور. وقد ارتبطت حالة عدم العقلانية القاتلة بحركة رومانسية شعبوية معادية للدِّين ومناهضة للتدين في ألمانيا، إحدى أكثر أمم الأرض تقدماً وأفضلها تعلماً. وفي وقتنا هذا، نعاني لسوء حظنا، ربما، من محنة جائحة (كوفيد -19) التي أتت في أعقاب ظروف اضطرابات مماثلة نوعاً ما ومثيرة للقلق والكرب والهم.
هنالك كم هائل من جحافل القلق التي تسد عين الأفق وتلامس عنان السماء في العديد من الدول، بما فيها العديد من الدول الغربية، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظل الناس يسعون بدأب ومثابرة وهم لا يلوون على شيء ولا يألون جهداً في محاولة وضع إصبعهم على مصدر ضيقهم والاهتداء إلى دواعي قلقهم؛ أكان ذلك من جرّاء التوابع والهزات الارتدادية لما بعد الصدمة لنازلة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001م، والكساد العظيم في عامي 2008 و2009، والبلبلة والاضطرابات العاتية التي أحدثها تسونامي التقنية في مجالات العمل، والكثير غيرها؛ أو بسبب نتاج الرفاهية غير المسبوقة من الإفرازات المتراكمة للعزوف عن خوض غمار المخاطر، بما في ذلك الآفة الاجتماعية المتمثلة في الانزواء والشعور بالوحدة لدى نسب قياسية من الناس الذين يعيشون في عزلة. وقد قامت جائحة “كوفيد -19″، بصورة أو أخرى، مقام مانعة الصواعق؛ حيث أفضت إلى تجميع كم هائل من الذعر والهلع والجزع والفزع واستقطاره وحثو ذرّاته في مجرّة تهديد واحد مخيف مثل كائن شيطاني مرعب. وأصبح العديد من الأمريكيين في حالة توهان جذرية بعد أن تبعثرت أوراق توقعاتهم وأنماط حياتهم اليومية الاعتيادية، وأصبحوا في مواجهة غيبوبة اقتصادية على غرار ما حدث في فترة الكساد العظيم. وعلى هذا فإن الحديث عن ارتفاع احتمالات اندلاع حالات عدم العقلانية لا ينطوي على أي مبالغة أو غلو في التقدير.
لعل أهم ثروة لدى أي أمة في مثل هذه الأوقات، هي أن تكون هنالك قيادة تتصف بالحصافة والهدوء وضبط النفس ورباطة الجأش ومراعاة مشاعر الآخرين، واتساق الذات وتطابق الأقوال مع الأفعال والأهلية والكفاءة والاقتدار. وعلى هذا فإن الانتخابات التي ستقام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020م بالولايات المتحدة تعد انتخابات مهمة جداً جداً، ليس للأمريكيين فقط. لقد كانت دائماً مهمة ولكن أهميتها الآن تفوق أي وصف، ويتقاصر عن هامتها أي تقدير.
سيدرك القادة المستنيرون أننا لسنا في حاجة إلى تفكيك الأنماط والمؤسسات الاقتصادية العالمية، واستنساخ لوثة ثلاثينيات القرن الماضي المتمثلة في تجربة الاستكفاء أو الاكتفاء الذاتي، وحظر الواردات على المستوى الوطني، تلك التجربة المفضية إلى الإفقار؛ وإنما يلزمنا أن نستصلح تلك المؤسسات والأنماط، بحيث تصير أكثر مرونةً وأسرع استجابةً للمتغيرات وأفضل حمايةً وتحصيناً من احتمالات تعطل الأعمال وتوقف الخدمة، بالمقارنة مع ما قمنا ببنائه بطريقة مزاجية من أدوات غريبة الشكل وذات طابع بدائي مرتجل، مما جعلها عرضةً للحوادث وسريعة التأثر بالأخطار.
سيدركون أنه يجب علينا عدم تدمير مؤسساتنا الدولية على الرغم من حقيقة أن أياً منها لم يكن يستحق أن يعبأ به أحد أو يحفل به أبداً في هذه الأزمة –إذ يجب ألا ندمر مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولا جامعة الدول العربية، ولا رابطة بلدان جنوب شرق آسيا أو الاتحاد الأفريقي، ولا منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يلزم أن نجعل تلك المؤسسات تعمل بشكل أفضل بناءً على أسس ومسوغات واقعية، بدلاً عن التفكير القائم أساساً على المراء وزيف الخداع والتمنّي والتماس الحلول السحرية الكاذبة.
لا نحتاج إلى تطبيق إجراءات ومراسيم استبدادية وحشية وشديدة القسوة، أو إلى توسيع قاعدة الحكم بحيث تصبح الحكومة أكبر حجماً وأكثر تدخلاً ودسّاً لأنفها في شؤون الأفراد وخصوصياتهم، وأقل خضوعاً للمساءلة والمحاسبة؛ ولكننا نحتاج إلى ضبط طريقة استعداداتنا لمواجهة طوارئ الصحة العامة الكبرى وطريقة استثماراتنا في القدرات الخاصة بتلك الطوارئ وكيفية إدارتها.
وفي الولايات المتحدة، لا نحتاج بالضرورة إلى إقامة خطة لدخل قومي/وطني بحيث تكون باهظة التكلفة ومضمونة على المستوى الاتحادي، بينما الأمة منهكة أصلاً وهي ترزح تحت ديون بمقدار (23) تريليون دولار أمريكي؛ ولكننا نحتاج بالفعل إلى إعادة التفكير في كيفية تخفيف الصدمات على الاقتصاد في أثناء الأزمة، على غرار ما حققته عدة ديمقراطيات أخرى.
لا نحتاج إلى ضمان تحقيق المساواة في المدخولات المادية، ولكننا نحتاج حقاً إلى تحقيق توازن أفضل بين الغايتين المركزيتين لأي نظام اجتماعي سياسي ديمقراطي قويم وسليم، وهما: الكرامة والحرية. وهذا يعني أننا نحتاج إلى إزالة البثور والتشوهات البلوتوقراطية (المتعلقة بحكومة الأثرياء وطبقة الأغنياء) من جسد الاقتصاد السياسي الأمريكي، وإنهاء انتهاكات أصحاب الأملاك الريعية وتعسفاتهم التي تحدق به وتحيط به من كل جهة.
لكل دولة أخرى ما يخصها مما يتطلب الإصلاح بسطاً أو ثنياً من حقائق واقعها ووقائعها التي يعتريها النقص وعدم الاكتمال؛ ويمكن أن تنتهز تلك الدول هذه اللحظة السائبة وغير المنضبطة لإحراز تقدم قد يكون إحرازه أصعب بكثير في الأوقات العادية؛ ولكن يجدر التنويه مرة أخرى بأن إدخال التحسين على الأشياء بحيث تصبح أفضل، يتطلب وجود قيادة مستنيرة ومؤسسات فعالة يكون بمقدورها بذل جهود الإصلاح واستدامتها على مر الزمن. ففي هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، سيكون في وسع أي مجتمع يعمد إلى تفويض قيادته المستنيرة وتمكينها أن يتوقع صحوة اجتماعية ونمواً اقتصادياً ونهضة ثقافية في مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد -19”. أما المجتمعات التي لا تجد إلى ذلك سبيلاً لأي سبب، فستجد نفسها محاصرة بالمشكلات من كل جانب. ومن الوارد أن تصبح بعض تلك المجتمعات غارقة في مشكلات كبرى.
يشير التاريخ إلى أن الناس سيكونون في حاجة إلى شيئين عندما يجتاح الفيروس حياتهم، هما: إحراز التقدم في مجال أمصال اللقاحات والعلاج في حالة تكرار ظهور الفيروس؛ والعودة إلى الحياة الطبيعية كيفما كانت تلك العودة. ومن جانبي أتوقع أنه في عدد كبير جداً من الدول ستزداد لدينا الاحتمالات -إلى حد بعيد- للحصول على الشيء الأول، وذلك بأكثر بكثير من احتمالات حصولنا على الشيء الثاني.
تشير الوكالة البشرية (agency) إلى الأفكار والأفعال التي يتخذها الناس، والتي تعبر عن أهليتهم وقدراتهم الفردية. ويكمن التحدي الجوهري في صميم علم الاجتماع في فهم العلاقة بين البناء الاجتماعي (structure) والوكالة البشرية (agency) . يشير البناء الاجتماعي إلى المنظومة المعقدة والمتشابكة والمترابطة من مصادر القوى الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية وعناصر البناء الاجتماعي التي تعمل معاً لتشكيل الأفكار والسلوك والخبرات والتجارب والخيارات ومظاهر الحياة الإنسانية الشاملة ومساراتها المختلفة. وبالمقابل، تشير الوكالة البشرية إلى القدرة التي يمتلكها الناس للتفكير لأنفسهم بمفردهم، والتصرف بالطرق التي تشكّل خبراتهم وتحدد مسارات حياتهم. يمكن أن تتخذ الوكالة شكلاً فردياً وجماعياً على حد سواء.
يدرك علماء الاجتماع كنه العلاقة بين البناء الاجتماعي والوكالة، ويعلمون أنها علاقة جدلية دائمة التطور. وتشير الجدلية في أبسط معانيها إلى وجود علاقة بين شيئين يكون بمقدور كل منهما أن يؤثر على الآخر، بحيث يستلزم التغيير في أحدهما تغييراً في الشيء الآخر. أما النظر إلى العلاقة بين البناء الاجتماعي والوكالة البشرية على أساس أنها علاقة جدلية، فيعني تأكيد أنه بينما يتشكل الأفراد من البناء الاجتماعي، فإن البناء الاجتماعي يتشكل أيضاً من الأفراد (والجماعات) -على أنه بعد كل شيء، يمثل المجتمع قوام تشكيل اجتماعي؛ ويتطلب تشكيل القوام والحفاظ على النظام الاجتماعي تعاوناً بين الأفراد الذين تربط بينهم علاقات اجتماعية. وعلى هذا ففي حين أن حياة الأفراد تتشكل عن طريق البناء الاجتماعي القائم، يتمتع الأفراد على الرغم من ذلك بالقدرة –الوكالة– على اتخاذ القرارات والتعبير عنها سلوكاً.
[1]– كاتب عمود منتظم في مركز “المسبار للدراسات والبحوث”، وزميل زائر متميّز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة.
[2]– Nathan Gardels, “Planetary Co-immunism Is on the Way”, The WorldPost (Berggruen Institute), March 21, 2020. Emphasis added