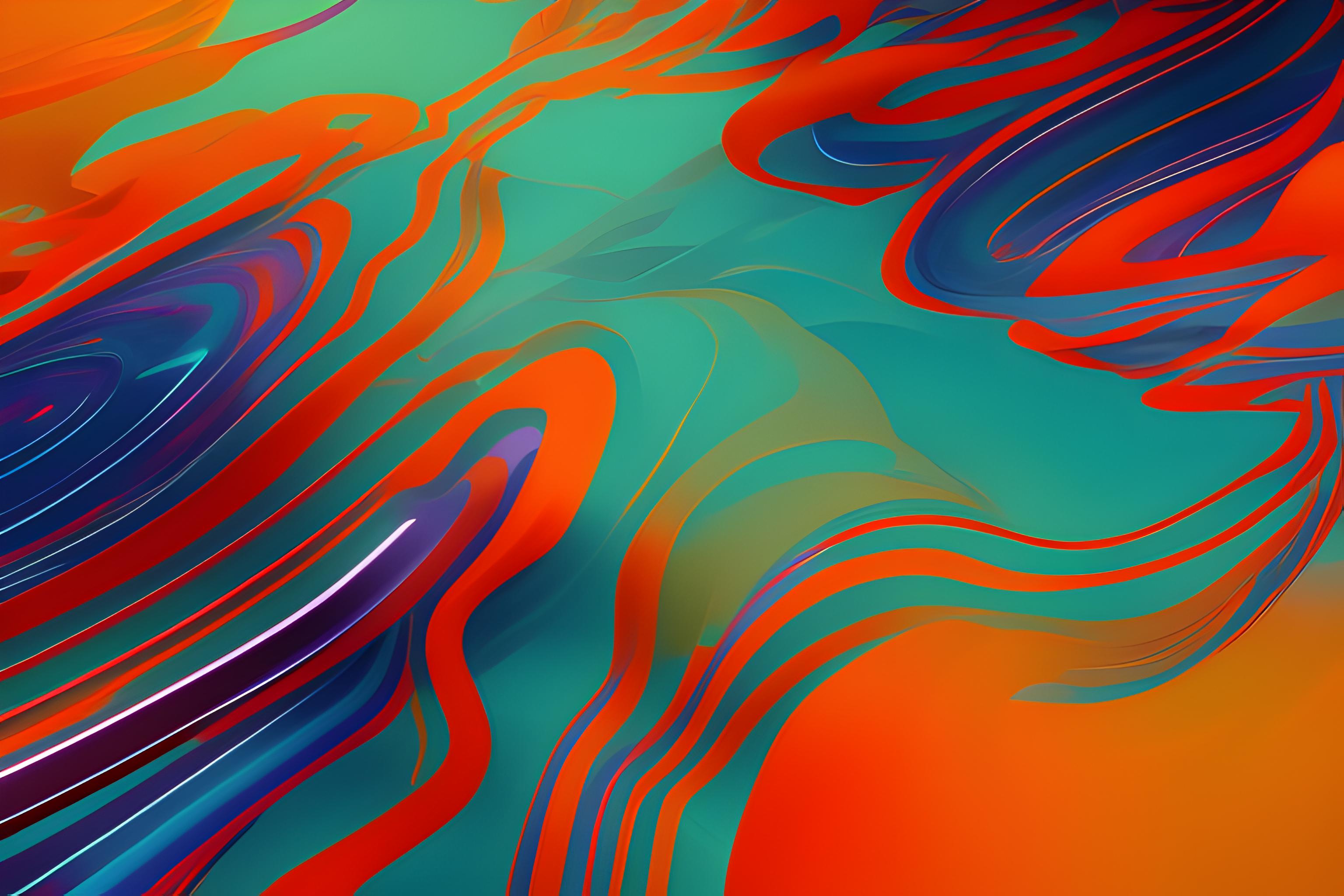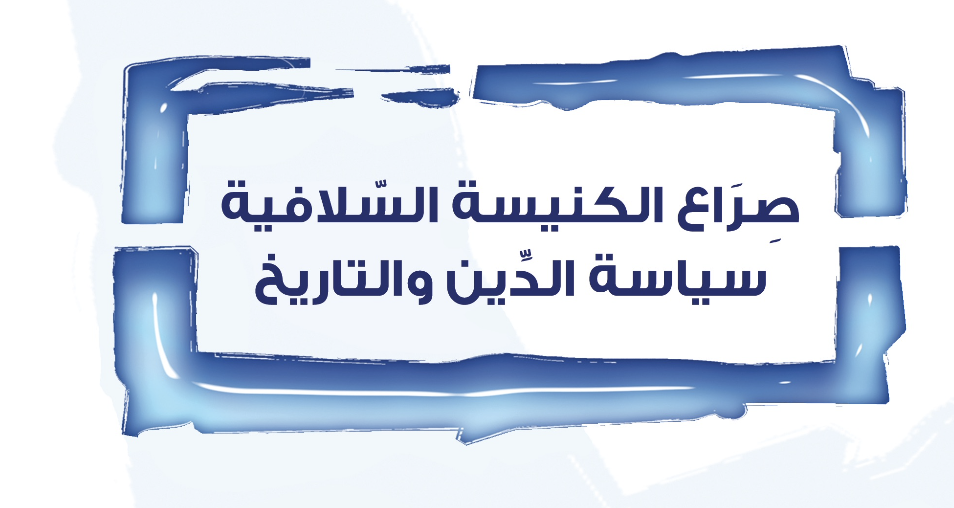يتضمن هذا التقرير، ملخصًا تحليليًا، وتعقيبًا على دراسة: “جماعات صغيرة وأسلحة كبيرة: الارتباط بين التقنيات الناشئة وأسلحة الدمار الشامل للإرهاب”[1]، المنشورة في مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت (West Point) فيوجزها بثلاثة محاور ويحللها بعمق، مناقشًا أبرز خلاصاتها وأفكارها في المحور الرابع[2].
ملخص تنفيذي
تسلط الدراسة الضوء على التحديات التي كانت تواجه الجهات غير الرسمية؛ التي تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وكيف يمكن أن تساعدها التقنيات الناشئة حديثاً في التغلب على العقبات التقنية، وذكر أبرز هذه التقنيات، وتحديداً في علم الأحياء التركيبي، والتصنيع الإضافي عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة الطائرات المسيرة دون طيار. استعان القائمون على الدراسة بمجموعة واسعة من الخبراء، للاسترشاد بآرائهم حول منتجات الاستخدام الثنائي، والمقصود بها المنتجات الصناعية مزدوجة الاستخدام في الميادين المدنية أو العسكرية، وما تمثله من مخاطر إذا ما تم إساءة استغلالها، وكيفية مواجهة تلك المخاطر.
أولاً: ما التقنيات الجديدة التي يخشى من استغلال الإرهاب لها؟
تحذر الدراسة، من استخدام بعض التقنيات التي يمكن أن تساعد الإرهابيين في الحصول على أسلحة دمار شامل. وهنا نقدم التمهيد والتعريفات الضرورية لفهم الدراسة.
المقصود بالتقنيات الناشئة، التقنيات الناشئة حديثًا كافة، والتي عبرها يمكن للأفراد أو التنظيمات، والجماعات المارقة، والإرهابية استخدامها لتصنيع أسلحة غير تقليدية، حيث ساهمت هذه التقنيات الناشئة حديثًا في إمكان تطوير قدرتهم على القيام ببعض المهام، التي لم يكن من الممكن في الماضي سوى للدولة القيام بها. يحدد معدّو الدراسة، وفريق الخبراء المتعاون معهم التقنيات الأكثر خطورة؛ وتم حصرها في المجالات الآتية:
- الأحياء التركيبي Synthetic biology)).
- التصنيع الإضافي عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing).
- الأنظمة الجوية دون طيار Unmanned aircraft systems)).
مجال الأحياء التركيبي
مجال الأحياء التركيبي يتشارك في تأسيسه علوم الأحياء، والهندسة، وعلم الأحياء الحاسوبي، وله تخصصات واستخدامات متعددة في مجالات الطب، والنبات، والغذاء، والطاقة، وإعادة تكوين واستنساخ الحمض النووي (DNA).
تاريخيًا، ساهم في تطويره النمساوي غريغور يوهان مندل عام 1865، وشهدت في سبعينيات القرن العشرين تطورات على يد عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي بول برغ، ثم بدأ استخلاص «النوكليوتيدات» الأنزيمات الخاصة بالحمض النووي، وإعادة لصقها واستخدامها، أو تنحيتها، أو إضافتها، وهو ما طوّر معرفة تسلسل الحمض النووي للفيروسات، وساهمت في تطوره الهندسة الوراثية، وهو ما انعكس على صناعة الأدوية بكميات أكبر، وتقنيات أحدث، وسعر أقل.
فتحت هذه الاكتشافات الباب واسعاً أمام التجارب، والوصول لنتائج جديدة، وصولاً إلى إمكان تعديل الحمض النووي، وإنتاج مواد بروتينية سامة تؤدي لموت الخلية أو ما يمكن وصفه بتخليق الفيروسات القاتلة. ومع شيوع المعرفة بهذه الأدوات وتأثيرها، والعلم بأن القدرة على الوصول إليها، متاحة للجميع، حيث نُشر عام 2017، وحده، أكثر من (17000)، دراسة لتسلسل حمض نووي؛ تختلف التكلفة، لكل سلالة، حسب طول التسلسل الجيني. إلا أن وصفها بأنها غير مكلفة؛ لا ينطوي على أيّ مبالغة. يمكن هنا أن نتذكر نشر التسلسل الجيني لفيروسات مثل الجدري، والأنفلونزا الإسبانية لعام 1918، وأنفلونزا الخنازير (H1N1)، والجمرة الخبيثة، وكل هذه السلاسل الجينية منشورة الآن بشكل علني ومتاحة، ربما بلا مقابل مادي.
فما الذي يمكن أن يعنيه ذلك؟
على الرغم من توفر التسلسل الجيني؛ فإن ذلك لا يسمح لأي جهة “مارقة” أن تصنع مرضاً ما، حيث تطلب عملية توليف الحمض النووي: معداتٍ ومهارات مخبرية معقدة. يصعب توافرها لجهةٍ عادية.
على سبيل المثال؛ أعلن الباحث الكندي ديفيد إيفانز في جامعة ألبرتا عام 2017، عن استخدام المواد الوراثية المتاحة تجارياً في تجميع الجدري الجديد، وهو فيروس يتكون من حوالي (200,000)؛ زوج أساسي، وينتمي لعائلة فيروس الجدري؛ الذي تم القضاء عليه في أمريكا الشمالية، وقد كلّفت هذه العملية (100.000)، دولار أمريكي.
يتضح من المثال السابق، إمكان إعادة تصنيع فيروس قديم، سبق التخلص منه، وإعادته بشكل جديد، وإن كانت هذه التجربة تحتاج لمتخصص ذي كفاءة عالية ومعرفة واسعة. وربما فإن الجهات البحثية والمعلوماتية؛ التي قد يحتاجها “البعض” لتخليق فيروس جديد؛ تكون ملزمة، بالتأكد من سلامة الجهة التي تستخدمها. الجدير بالذكر أن تجربة د. ديفيد إيفانز لم تكن الوحيدة، فقد تم إعادة تخليق فيروسات عدة لأهداف بحثية علمية منذ عام 2002؛ مثل شلل الأطفال، والأنفلونزا الإسبانية، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس)، وفيروس غرب النيل، وغيرها من الفيروسات التي يبدو بعضها غير قاتل ومعروفاً على نطاق واسع.
لهذه القيود والتعقيدات، يعتقد الباحثون المتخصصون، أن الصعوبة الشديدة تمنع الجماعات الإرهابية والمارقة، من استخدام علم الأحياء التركيبي في صناعة سلاح بيولوجي. ولكن مع وجود بعض المخاطر المحدودة التي يمكن توقعها بناء على عوامل عدة، منها المعدات اللازمة لتنفيذ هذه السيناريوهات، كما هو موضح في الجدول الآتي:
|
نوع الخطر |
حدود إمكانيات الخبرة منخفض (3) متوسط (2) عال (1) |
حدود إمكانيات المعدات منخفض (3) متوسط (2) عال (1) |
مستوى التهديد |
|
عوامل القدرة على نشر خطر بيولوجي يؤدي لتلويث السلسلة النهائية لمستخدمي الماء أو الغذاء |
3 |
3 |
9 |
|
استخدام الوسائل الميكانيكية كعامل ضمان إضافي لبيئة مستقرة بيولوجيا الكبسلة الدقيقة مثالاً |
2 |
2 |
4 |
|
التلاعب في فاعلية المضادات الحيوية المفيدة أو العلاجات المضادة للفيروسات |
2 |
2 |
4 |
|
عوامل سهولة الإنتاج البيولوجي |
2 |
2 |
4 |
|
عوامل القدرة على نشر خطر بيولوجي يؤدي للتلويث المبكر لسلسلة المستخدمين للماء أو الغذاء |
3 |
1 |
3 |
|
عوامل القدرة على نشر خطر بيولوجي في شكل مسحوق أو بخاخ |
1 |
2 |
2 |
|
تخليق فيروسات صناعية |
2 |
1 |
2 |
|
تحويل اللقاح لغير فعال |
1 |
1 |
1 |
|
التعزيز من خطر بيولوجي |
1 |
1 |
1 |
|
زيادة عوامل انتقال خطر بيولوجي |
1 |
1 |
1 |
|
عوامل تعزيز عدوى بيولوجية |
1 |
1 |
1 |
|
عوامل التغيير البيولوجي للمضيف |
1 |
1 |
1 |
|
عوامل التحويل البيولوجي غير الضار إلى خطير يؤدي للمرض |
1 |
1 |
1 |
|
إضافة عوامل تؤدي لزيادة الخطر البيولوجي |
1 |
1 |
1 |
|
تعزيز مقاومة العامل البيولوجي لإضعاف الجهاز المناعي |
1 |
1 |
1 |
|
تعديل جيني على العامل البيولوجي لتغيير الاستجابة المناعية والعصبية |
1 |
1 |
1 |
|
تخليق سلالة جديدة من فيروس قديم |
1 |
1 |
1 |
|
التعديل الجيني |
1 |
1 |
1 |
|
خلق نتائج غير واقعية للكشوفات والتحاليل |
1 |
1 |
1 |
|
توجيه مواد معينة إلى أماكن محددة داخل الجسم |
1 |
1 |
1 |
بناءً على الجدول أعلاه، ينظر إلى سيناريوهات الإرهاب البيولوجي بأنها معقدة، وتتطلب قدرات علمية عالية، ومعدات نادرة.
دائرة لأمن العلوم البيولوجية؟!
توفِّر -على سبيل المثال- مؤسسة (Genspace)، في مدينة نيويورك، مختبرًا مجتمعيًّا بيولوجيًّا، يُمكِّن عشاق التكنولوجيا الحيوية المبتدئين من العمل مع الخبراء، والتعلّم على أجهزة حديثة، وكذلك مسابقة الآلة الدولية للهندسة الوراثية (iGEM). التي كانت تستهدف في البداية طلبة الجامعة، لكنها توسعت لتشمل أقساماً لطلبة المدارس الثانوية، ورجال الأعمال، والمختبرات المجتمعية، بالإضافة إلى الخريجين. حيث إن هذا العلم المطلوب دوليًّا، والذي كان مقتصرًا على طلبة الدراسات العليا، قد أصبح متاحاً لكل الراغبين في تعلمه، وتنظم له مسابقات دولية عدة، وتوفر المختبرات فرصاً لزيادة قدرات ومهارات المتدربين، وذلك عبر اشتراك بقيمة (100) دولار أمريكي شهريًّا. يمكِّن المشترك من الوصول لكل المعلومات التي يحتاجها، واستخدام مختبرات مؤسسة مثل (Genspace) طيلة أيام الأسبوع على مدار (24) ساعة، وتوجد مختبرات مماثلة في أمريكا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية لا حصر لها تقدم الخدمات نفسها. ويشير معدو الدراسة إلى أنه “من يُرِد استخدام هذه المختبرات، وهذه العلوم لتصنيع أسلحة بيولوجية تضر بالبشر، لن يتحدث عن هذا الأمر بشكل علني”.
اقترح الأمنيون والباحثون المتخصصون في مكافحة الإرهاب، وسائل رقابية يعدونها مهمة، مثل “تعيين موظفين متخصصين؛ يمكنهم ملاحظة نشاط المتدربين، لإيقاف أي ممارسة قد تهدف لتصنيع سلاح بيولوجي”. والأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق، لإيجاد التوازن بين فرص التقدّم الإنساني، وقدر الحرص الملائم، لتفادي أيّ استخدام سيئ، يعلّق مراقب ساخر للمسبار: “ربما سنسمع عن علم أمن العلوم قريبًا”!
اصنعها بنفسك!
ساد أخيرًا نمط جديد من أدوات تعزيز الاستقلال، وتفكيك الكليّات الكبرى عبر توفير آلاتها وأهدافها بأقل كلفة. فانهارت بذلك عقبة كبيرة كانت تحول دون الأفراد والاستقلال وبناء ما يريدون، وهي الآلة. يشير المتخصصون إلى أن المعدات؛ شكلت في الماضي إحدى أهم العقبات أمام قيام الأفراد، أو المنظمات الإرهابية في بناء معامل بيولوجية، ولكن مع التقدم التقني الحالي، وانتشار أساليب (DIY)، أو «افعلها بنفسك»، تمَكن الأفراد؛ من بناء مختبرٍ خاص بهم، وصنع متسلسلات للحمض النووي، وإن كان المختبر الجديد يكلف حوالي (700,000). دولار أمريكي، وهو مبلغ من غير المرجح أن يمتلكه “إرهابي وحيد”، يريد بناء مختبر سري. إلا أن هناك العديد من البدائل، وبتكلفة أقل بكثير يمكن عبرها بناء معمل سري خاص.
2- التصنيع الإضافي عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing))
التصنيع الإضافي أو المعروف بالطباعة ثلاثية الأبعاد، تقنية بدأ استخدامها عام 1987. وهو عبارة عن عملية تصنيع للقطع؛ عن طريق تصميمها؛ أولاً على برامج الحاسب الآلي بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) ثم تقسيمها إلى طبقات صغيرة جدًا من خلال هذه البرامج، وتصنيعها من خلال طابعات ثلاثية الأبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق الأخرى. حتى يتكون الشكل النهائي، وقد تعددت التكنولوجيات المستخدمة في هذه التقنية، التي بدأت بالبلمرة الضوئية والتصليد الحراري، والطباعة بالتليين الحراري، والطباعة باستخدام المسحوق، وتستخدم هذه التقنية الآن في الصناعة، والمجال الطبي، والصناعات الدوائية، والصناعات العسكرية، وغيرها من الاستخدامات.
ماذا يمكن للإرهاببين أن يفعلوا بها؟ وهل يستطيع الإرهابيون استخدامها في صناعة أسلحة؟ بدأ عام 2013، إنتاج أول نماذج لمسدسات وبنادق، عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بتكنولوجيا استخدام المسحوق، وذلك من خلال “كودي رتليدج ويلسون”؛ وهو شاب أمريكي من مواليد عام 1988. طالما وصف بأنه «أناركي» التوجه، وناشط في حقوق “حرية حمل السلاح”، وقام بنشر مخططات تصميماته على شبكة المعلومات الدولية لمشاركتها مع الآخرين، ومع حرية تداول المعلومات ووجود مئات المنصات على شبكة الإنترنت التي يتبادل فيها المصممون تصميماتهم، وسرعة تطور هذه التقنية، وسهولة استخدامها، والحصول على مكوناتها من المواد الخام التي يكاد يكون من المستحيل تتبعها.
الحقيقة الصادمة، أن هناك خشية كبيرة من أن يطور الإرهابيون؛ عبر هذه الوسائل، قدراتهم على صنع الأسلحة بأنفسهم، وقطع الغيار، وباقي المستلزمات اللوجستية عسكريًا، بجانب أن التطور المذهل في هذه التقنية، قد يمكنهم في المستقبل القريب من إنشاء منصات لتوليف بروتينات معقدة وسامة، مثل “الريسين” شديد السمية، والبروتينات الغشائية المشاركة في الاستجابة المناعية، وبعض عائلات البروتينات السامة، التي تشمل: الليكتين، والبروتين المعطل للريبوسوم، ومثبطات البروتياز.
3- الأنظمة الجوية بدون طيار UAS/UAV))
بدأ تاريخ أنظمة الطائرات بدون طيار عام 1918، بالحرب العالمية الأولى، وتسابقت دول المحور والحلفاء على تطوير استخداماتها بالحرب العالمية الثانية، واستخدمت على نطاق محدود في حرب فيتنام. كان أول استخدام لها خارج نطاق الدولة القومية عبر تنظيم «أوم شنريكيو» الياباني أواخر عام 1993، ثم حزب الله اللبناني عام 2004، بإطلاقه طائرة بدون طيار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي 2016، قامت القوات الكردية بإسقاط طائرة بدون طيار لتنظيم (داعش) الإرهابي محملة بالمتفجرات، حتى شاع استخدام هذه التقنية بين جميع المنظمات الإرهابية؛ من تنظيم «فارك» اليساري في كولومبيا بأمريكا اللاتينية، إلى الحوثيين في اليمن، ولشكر طيبة (Lashkar-e-Taiba) في باكستان.
عسكرياً، ازداد اعتماد الولايات المتحدة على هذه الطائرات، وبدأ أول استخدام لها على نطاق واسع منذ نهاية عام 2001، في أفغانستان. وتوسع استخدامها في أماكن أخرى لتصفية إرهابيين أو ضرب قوافل لهم. وتتوقع إدارة الطيران الفيدرالي، أن يصل عدد هذه الطائرات عام 2020، إلى (7) ملايين طائرة في أمريكا وحدها، منها (4.3) ملايين طائرة للهواة، والمتبقي (2.7) مليون للأغراض التجارية.
تتعدد مخاطر استخدام الطائرات بدون طيار؛ فبجانب قدراتها اللوجستية على التصوير الفوتوغرافي والفيديو لأماكن حساسة وقواعد عسكرية أو أسرار تخص الدولة، يمكن تحميلها بمتفجرات للقيام بأعمال إرهابية تقليدية؛ وهو ما يحدث بالفعل حول العالم في بؤر صراعية عدة. وعلى الرغم من أن الطائرات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية صغيرة، وذات قدرات محدودة، ولا تستطيع الطيران لمسافات طويلة، فإن التطور التقني المستمر، وقدرة الوصول إلى تصميمات جديدة لها، وظهور أجيال جديدة قادرة على استخدام بطاريات لمدة أطول، تعزز من مخاوف توسع هذه الجماعات في استخدامها، وتشكيلها لمخاطر حقيقية، خصوصاً لو تمكنت من الحصول على سلاح نووي أو بيولوجي. كذلك من المخاطر المحتملة مستقبلاً؛ قدرة هذه الجماعات على صنع سرب من الطائرات الصغيرة، التي يمكن التحكم بها بشكل مرن دفعة واحدة، وتمتلك قدرة على رصد الأسلاك، والأبراج الهوائية وتفاديها، والإحاطة بطائرة تجارية باستخدام نظام محاكاة أسراب الطيور، لتجبر الطائرات التجارية على الإنزال؛ كما حدث لطائرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية (1549)، في نهر هدسون 14 يناير (كانون الثاني) 2009.
ثانياً: العلاقة بين التقنيات الناشئة وإرهاب أسلحة الدمار الشامل
بناءّ على ما تقدم يطرح السؤال الآتي: ما التهديدات المحتملة من الجماعات الإرهابية، وإمكان قيامها بهجوم كيميائي، أو بيولوجي، أو نووي؟ تبقى الأسلحة النووية، نادرة وغير متاحة؛ ليس فقط بالنسبة للجماعات الإرهابية، بل وللدولة القومية؛ حيث يوجد الكثير من العقبات التقنية والمادية، التي يصعب التغلب عليها من أجل إنتاج سلاح نووي، أبرزها المواد الانشطارية، واليورانيوم.
هل ثمة إمكانية لحصول الإرهابيين على سلاح نووي؟
تبدو هذه الفرضية مستحيلة بالوقت الحاضر بالنسبة للفنيين؛ من حيث المبدأ. ولكن هذه الاستحالة ستتراجع؛ في المستقبل؛ وذلك لما توفره التقنيات الناشئة من قدرات يمكن أن تمكن الجماعات من صنع مثل هذا السلاح.
يمكن “نظرياً” عبر تقنية التصنيع الإضافي؛ والتصوير ثلاثي الأبعاد؛ صناعة طرود مركزية لتخصيب اليورانيوم. إلا أن هناك عيوباً فنية ستشوب هذه الطرود، ولن تمكنها من أداء مهمة التخصيب بالكفاءة المطلوبة لصنع قنبلة نووية.
يمثل البلوتونيوم عقبة أخرى؛ فإذا افترضنا قدرة الجماعات الإرهابية على تحسين كفاءة تصنيع طرود مركزية بالمستقبل، وهو ما يمكنها من تخصيب اليورانيوم، فإن البلوتونيوم غير موجود بشكل طبيعي مثل اليورانيوم، بل لا بد من إنتاجه عبر عملية معقدة، ثم استخلاصه عبر فصله كيميائياً.
إلا أن تجربة العالم النووي الباكستاني عبدالقدير خان (Abdul Qadeer Khan)، في تصميم مخططات أقل تكلفة وتعقيدًا، عبر استخدام أكسيد المغنيسيوم، وتبريد المفاعل بواسطة ثاني أكسيد الكربون، واستخدام الغرافيت، قد غيرت من المعادلة، وهو ما ظهرت آثاره، بعد وصول هذه المخططات لدولٍ ثالثة. إذ يصرّ متابعون أن كوريا تمكنت عبرها من صنع سلاحها النووي بالفعل، لأسباب، من بينها حصولها على هذه المخططات.
وعلى الرغم من أن هذه العملية أبسط وأقل كلفة من العمليات التقليدية، فإنها تحتاج لمستوى غير بسيط من المعرفة، ومختبرات على مستوى عالٍ من التجهيز، وهو ما لا يمكن توفره بالوقت الحالي للإرهابيين، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود خطر. إذ يتخوّف التقنيون، أنه في حال كان هناك إرهابي “صبور”، أو منظمة إرهابية لها خطط بعيدة المدى، وتتابع كل ما هو جديد في علوم الكمياء، والتصوير ثلاثي الأبعاد، ومع التطور التقني المتوقع خلال الـ(15) سنة القادمة؛ أن تجارب بدائية ستكون وصلت إلى أن لا يكون مستحيلاً بالنسبة لهم تصنيع سلاح نووي، ولو بشكل بدائي في البداية.
وفي حال حدث هذا السيناريو المفزع، وتمكنت جماعة إرهابية مع الوقت من الحصول على سلاح نووي، سيكون لديها مشكلة في كيفية توجيه هجمات لخصومها مع افتقادها لقدرات الدولة، وهنا تبرز خطورة استخدام الطائرات بدون طيار، لكن؛ للقيام بهجوم كهذا تحتاج الطائرة لحمل حوالي (25) كيلوجراماً من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما لا توفره التقنية الحالية، ولكن يمكن أن يكون متاحًا خلال السنوات الخمس عشرة القادمة!
يظل السلاح النووي وامتلاكه أمرًا صعبًا للغاية؛ ولكنه لن يكون مستحيلاً في السنوات القادمة، حال كان هناك من يخطط لذلك من الإرهابيين، ولديه صبر، ومخطط للمعرفة، بشكل هادئ وبلا ضجيج، أو عبر مساعدة تقدم له من دولة مارقة.
الأسلحة الكيمائية؟
يظل السلاح الكيميائي الأسهل، والأكثر قدرة للإرهابيين على استخدامه؛ وذلك لكونه يحتاج لمعارف بسيطة، وتقنيات محدودة ومتوافرة بسهولة، ومعلومات متاحة على شبكة الإنترنت يمكن العودة إليها، وقد قامت بالفعل الجماعات الإرهابية بعدة هجمات كيميائية في اليابان وسوريا.
وعلى الرغم من أن استخدام السلاح الكيميائي أسهل إذا ما تمت مقارنته بالسلاح النووي والبيولوجي؛ فإن الجماعات الإرهابية؛ بدائية في معرفتها بتقنياته. يمكن رصد ذلك عبر تحليل هجمات تنظيم (داعش) الإرهابي؛ حيث قام بالفترة من 2014 إلى 2016 بحوالي (52) هجومًا، باستخدام غاز الكلور، والكبريت، والخردل؛ بإطلاق صواريخ وقذائف هاون، تم إزالة البارود منها، ومُلئت بالمواد الكيميائية. ونتيجة درجة الحرارة العالية للمتفجرات التي تطلقها هذه الصواريخ، تحللت أغلب المواد الكيميائية. إلا أن الخطر ما زال كبيرًا نتيجة القدرة على صنع المواد الكيميائية الخطرة، وبكميات كبيرة. ويكفينا العودة لتجربة تنظيم «أوم شنريكيو» الياباني، الذي كان لديه كميات من غاز السارين، تكفي لقتل ما يقارب (4) ملايين شخص.
من هذا المنطلق، تنبع خطورة التقنيات الناشئة، في تمكين الجماعات الإرهابية من امتلاك قدرات أكبر على الهجوم؛ فمن الممكن -على سبيل المثال- تحميل الطائرات المسيرة بدون طيار، بكميات من المواد الكيميائية الخطرة، وتلويث الجو بها؛ خصوصا مع التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار، في رش المزارع الكبرى بالمبيدات الحشرية، وسهولة الحصول على هذه التقنية. وعلى الرغم مما تقوم به إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي -مثلاً- من تتبع طائرات الهواة، وحظر طيرانهم بمناطق معينة، فإن مخاوف جديّة؛ تشير إلى أن اختراق هذه المنظومة ممكن، عبر برنامج تحديد المواقع GPS. لذلك، يظل التهديد باستخدام السلاح الكيميائي للإرهابين في حالة نمو متزايد.
الأسلحة البيولوجية؟
ربما كانت البداية في استخدام هذه الأسلحة قديمة، وعبر حيل قديمة؛ كتلويث مصادر المياه للجيش المعادي، أو ما كانت تنتجه جثث القتلى والحيوانات من أمراض وأوبئة فتاكة، أو حتى ما قام به المستكشفون، من نقل عدوى الجدري -مثلاً- إلى السكان الأصليين في أمريكا، حسب إحدى الروايات.
تشرح الدراسة العوامل الفنية من الناحية العلمية، ليتمكن المرء من تخليق فيروس، أو إعادة إنتاج فيروس قديم، وتخلص -عبر آراء الخبراء المختلفين ووفق القدرات المتاحة حالية- إلى صعوبة قيام إرهابي بتصنيع سلاح بيولوجي دون أن يتم كشف أمره.
إلا أن التقنيات الناشئة حديثاً، والتي تطرقت الدراسة لها؛ جعلت الأمر أكثر سهولة من الماضي. ووفق معدل التطور الحالي، وسهولة الحصول على المعرفة، وشيوع استخدام الطائرات بدون طيار والتعامل معها على أنها أمر عادي، سيعزز بالمستقبل القريب من خطر قيام الإرهابيين بهجوم بيولوجي دون كشفهم. لا سيما لو كانت خلفهم جهة دولية، أو منظمات ذات قدرات كبيرة، وهو ما يفاقم الخطر في منطقتنا؛ حيث ترعى دولة مثل إيران -على سبيل المثال- العديد من المنظمات الإرهابية.
ثالثًا: التحليل الختامي والحلول الممكنة
يقول مالوري ستيوارت (نائب مساعد وزير الخارجية السابق) عام 2018: “لا أحد يفهم حدود هذه التقنيات الحديثة، فكيف يمكن أن نتعامل مع التهديدات”؟!
يعدد البحث الموضوعي في مجالات مكافحة الإرهاب إيجابيات التعلّم والعمل المختبري من أجل الخيرية، ثم يجزم بضرورة رفع درجة الاحتياطات والتأمين العام لمنع انحرافها إلى أهداف تقوض المجتمع. ينطلق ذلك من قناعة مستقرة، بأن هذه التقنيات ستتغير، على مدى السنوات المقبلة؛ إذ ستنخفض تكاليف تسليم وتصنيع السلع، لينتقل حساب الوقت إلى وحدة الساعات لا الأيام، وسيكون من السهل الوصول للأماكن النائية بيسرٍ أكبر، وستمكن علوم البيولوجيا والأمراض الوراثية، الباحثين وشركات الدواء من علاج الآلاف، وسيتم تطوير العقاقير الطبية بشكل أسرع وأقل كلفة. ستنتعش أنظمة الطائرات بدون طيار، وتستخدم لتوصيل السلع والمنتجات، وربما سيختفي بشكل سريع العلماء المحتكرون للمعرفة السريّة، أو الحاجة إلى المصنعين ذوي المهارات العالية لاستخدام هذه التقنيات، وستنمو بدلاً من ذلك مجتمعات التقنيين الهواة. وعلى الرغم من كل الفوائد المتاحة، والخير الكبير لهذه التقنيات، فإن المخاطر الكبيرة ماثلة، وتستحق التأمّل الطويل؛ خصوصًا فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. كما توقع كل من البروفيسور سيث كاروس، وجون بي كيفز، في مركز دراسة أسلحة الدمار الشامل بجامعة الدفاع الوطني، في تقريرهم عن مستقبل أسلحة الدمار الشامل، أن عام 2030، من المرجح أن تبدأ فيه هجمات إرهابية باستخدام التقنيات الناشئة لأسلحة الدمار الشامل.
فما الذي يمكننا التفكير فيه؟
ترى الدراسة أنه: “لا يوجد حل سحري يمنع الإرهابيين من استخدام هذه التقنيات في عمل إرهابي، وهو ما يتطلب من الحكومة بأكملها على المستوى المحلي والفيدرالي العمل لأجل إيقافه، ووضع سياسات وقائية لمواجهته”.
أول الجهود التي ينبغي على الحكومة القيام بها؛ التواصل والتعاون مع المستهلكين، والمجتمعات المحلية، والعلماء، والموردين، والشركات والحكومات حول العالم، ويستند ذلك إلى جهد مشترك، ولا يعتمد فقط على الضوابط الأخلاقية، والأخطار المحتملة من التراخي في التعامل مع الإرهابيين، بل يوفر حوافز للإبلاغ عنهم؛ مثل الإعفاءات الضريبية، والخصومات بالمصروفات الحكومية والتجارب التي يتم إجراؤها، وتقديم تدريب مجاني، وتلقي على مجتمع الهواة للطائرات بدون طيار خصومات على عدد ساعات الطيران الآمنة بعيدًا عن مناطق الحظر، وكذلك الأمر بتقديم حزم من المساعدات والحوافز المختلفة للمصانع والمعامل، بجانب حملات التوعية الشعبية.
هل نحتاج إلى تطوير دراسات دورية لكل ما هو متصل بالأخطار البيولوجية؟ نعم، وهذه التكنولوجيات الناشئة أيضًا، تحتاج إلى تخصيص قسم خاص بمتابعة هذه التقنيات، والمواد الخام المستخدمة فيها، وأماكن وجودها، وكيفية بيعها بالأسواق، ووضع سياسات وآليات تضمن عدم وقوعها بيد المخربين، إلى جانب التركيز على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والتي في ظاهرها تستخدم بأعمال مدنية، ويسهل الحصول عليها، ولكن يمكن استخدامها في صناعة أسلحة دمار شامل.
كانت التوصية الأهم للدراسة، هي تطوير قاعدة بيانات مؤمنة، ومن ثم تعزيزها بكشّاف وبروتوكول ذكيان؛ لتمييز الباحثين عن التسلسل الجيني للفيروسات؛ بغرض المعرفة أو التخريب. وهذه العملية يمكن السيطرة عليها؛ لوجود اختلافات كبيرة بين سلسلة المعلومات التي يسعى الباحثون في الشؤون العلمية للحصول عليها، مقارنةً بمن لديهم أغراض أخرى، وهو ما يحتاج لجهود وتنسيق مع أعضاء الاتحاد الدولي لتوليف الجينات (IGSC)، وذلك لحماية الجميع، مع ضرورة توضيح ذلك لهم.
تخلص الدراسة إلى أنه “ليس من المنطقي أن يقوم الإرهابي بتطوير الأسلحة: كيميائية أو بيولوجية أو نووية، بشكل دائم”. ولكنه يكون في حالة سباق مع الدولة، ولذلك، فمن المهم تطوير الإجراءات والاستعدادات التقنية، لعلاج الحدث، بتطوير عملية لصنع أسلحة ردع، وأدوية وأمصال قادرة على تطويق أي مرض، ووسائل حديثة لنقلها بشكل سريع. هذا سيفقد الإرهابيين القدرة على المجاراة، وسيجعل الاحتواء ممكنًا”.
تختتم الدراسة توصياتها بتأكيد ضرورة وضع قيود على بيع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، ومراقبة سلاسل تصنيعها وتوريدها وبيعها، وصولاً للمستهلك النهائي. وفي حال النجاح في هذه العملية، سيفقد الإرهابيون قدرتهم، بشكل كبير على القيام بأي عمل إرهابي شديد التأثير من الناحية التخريبية والأمنية.
رابعًا: تعقيب وإضافة على الدراسة
الأسئلة التي تضيء عليها الدراسة، كثيرة، ولكنّا انتخبنا أهم تطبيقاتها على المستوى الذي يهم طبقات مكافحة الإرهاب الراهن، واتصاله بمنافاة الدولة واستقرارها. لذا، عقّب باحثون على مناقشة الدراسة، باستحضار محاور رئيسة: الأسباب الموجبة لمثل هذه النوعية من الدراسات ومناسبتها أولاً، وأهمية التطرق إلى هذا الميدان المعني بقضايا الإرهاب وقياس مخاطره المحتملة، ومناقشته في إطارين: الأول: التطرّف الإرهابي الراهن، والثاني: تماسك الدولة وتأثيرها على ضيط الأمن.
وعليه، يتبين ما يلي:
- أدى التطور المستمر في علم الأحياء التركيبي، وشيوع المعرفة وسهولة الحصول عليها، إلى تخطي العديد من الصعوبات التي كانت موجودة بالماضي، لصنع أو تطوير سلاح بيولوجي للإرهابيين بمعزل عن الدولة، وتزداد المخاطر مع وجود دول “مارقة”، وجهات وجماعات لديها قدرات مالية ضخمة، قادرة على تمويل هذه الأنشطة. ما يعزز من هذه المخاوف، فقدان بعض البلدان لسلطة الدولة، وهو ما قد يمكّن بعض الجماعات، من تطوير سلاح بيولوجي واستخدامه.
- إن التفكير في دعم تخصص جديد “علم أمن العلوم”؛ يحتاج إلى تفصيل دراسته، لتطوير خطط الرعاية التي تؤمِّن عدم وصول المعلومات إلى أيدي الإرهابيين، دون خرق مجالات الحريّة العلمية التي تؤمّن ازدهار المعرفة.
- التهوين من مخاطر الإرهاب سيؤدي إلى ازدهاره: يتنافس باحثون من مشارب مختلفة منذ سنوات عديدة، في السيطرة على دراسات مكافحة الإرهاب. يعود سببها إلى تشعّب الإرهاب ومجالات مكافحته الميدانية والقبلية والبعدية. فتنحاز الدراسات إلى ترويج الخوف من (أدوات/ أسلحة) الإرهاب الميدانية، ومتابعة تطويرها. يرتبط ذلك بالخطر الميداني، ويحث على مواصلة تمويل الجهات القائمة على منعها. تحاول الدراسات الفكرية مواصلة تحليل دوافع الإرهاب الدينية والسياسية والاقتصادية، ووضعها في إطارها. يتخوّف الباحثون من توهّم بعض الجهات المسؤولة بانحسار خطر الإرهاب، إبّان الأزمات الكبرى، كما حدث عقب مقتل أسامة بن لادن في 2010، وهو التصوّر (الانحسار) الذي قاد إلى دعم حكومات غربيّة لجماعات أصوليّة في الشرق الأوسط. لذا، فإنّ ظهور مثل هذه الدراسات، التي توضح اتصال الخطر الإرهابي بالأوبئة الراهنة، مهم. ويظلّ تطوير دراسات الإرهاب، وتحديد ما يدفع الناس إلى الإرهاب، ليس بالمهمة السهلة. ويمكن أن يقود تشخيص أنشطة الإرهابيين؛ من زاوية خاطئة، أو واحدة، إلى استنتاجات مضللة.
- الحرب غير التقليدية وتطبيقات الوكالة في الشرق الأوسط: إن مخاطر أمنية غير تقليدية، ترتبط بحروب الجيل الجديد: “نتجت عن التغيّرات في طبيعة القوة وانتشارها في العالم، وتؤثر على مستقبل العنف (غير المشروع) والجهات التي تستخدمه”. فقد كانت الحرب التقليدية واضحة الأدوات والمعالم، وباتت خليطاً من توظيف الأدوات المتاحة: التقليدية وغير التقليدية، في ظل التطور التكنولوجي الهائل. وتقود إلى الحرب غير المتكافئة (Asymmetric Warfare)؛ وهي حرب بين جهتين متحاربتين تختلفان بقوتهما العسكرية والاستراتيجية؛ وهذا ما يحدث عند وقوع حرب بين دولة وجهة مسلحة غير رسمية. مثل هذه الحروب، تقوم بشكل أساسي على استراتيجيات غير تقليدية للحرب، بحيث يقوم الطرف الأضعف بمحاولة استخدام استراتيجيات معينة لموازنة أوجه الضعف الكمية والنوعية الموجودة عنده. وهذا ما يقودنا إلى الحرب الهجينة. وتطرح هنا، مواجهة “غير العاقل”، في الحروب التي لا تجمع بين شخصين؛ بل بين شخص، وطائرة بلا طيار أو فيروس. تقوض مثل هذه التحديات قدرة الدول على الاستجابة تجاه عدو غير مرئي، مثل تحدي مواجهة فيروسٍ مخلّق مثلاً، خصوصًا أنّ القدرات العسكرية، تعد أساس دفاع الدول عن نفسها.
- إنّ استخدام التقنيات الناشئة من قبل جماعات متطرفة؛ ممكن: فهي تتحالف مع بعض الدول المارقة. وفي حال سلمنا جدلًا بعدم احتمال حدوث هجوم إرهابي خطير يستخدم السلاح البيولوجي أو الكيماوي أو أي نوع آخر، فإن احتمال أن تقع مجموعات إرهابية على الأسلحة الكيماوية -على سبيل المثال- يبقى فرضية قائمة، لا سيما في الدول الهشة أو الضعيفة.
- “المختبرات” واحتمالات التجنيد: نواجه إلى جانب احتمالات لجوء الإرهابين إلى أنماط غير تقليدية من العنف والوسائل العسكرية نمطاً آخر من الإرهاب الأشد خطورة، وهو ما يمكن أن نسميه “إرهاب المختبرات”، فلا أحد يعلم ما هي الاحتمالات المتاحة، أو ما الذي يدور في المختبرات؟ فربما يتمكن أي فريق من العلماء غير المنضوين في مؤسسات الدولة أو الجهات الحكومية من إنتاج فيروسات فتّاكة، لذا لا بد من أن تكون مثل هكذا وظائف وتخصصات محكومة بشروط علمية صارمة، وببروتوكول دولي، خوفاً من فرضية جنوح بعض العاملين في المختبرات، وهذا لا يعني تشكيكاً بأمانتهم العلمية، وإنما باحتمال تجنيد بعض العاملين بهذا القطاع الصحي من قبل تنظيمات إرهابية أو دول مارقة.
- هل تحاول “القاعدة” و”داعش” ذلك…؟
- جواباً عن السؤال نحتاج إلى أساس داخل الفكر المتطرف نفسه، دار نقاش طويل في منتديات “القاعدة” و”داعش” وغيرهما بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية وحكمها وكيفية إطلاقها أو النشر المتعمّد لعواملها، مثل البكتيريا، والفيروسات، والفطريات، أو السموم، سواء بشكل طبيعي أو عن طريق أسلحة، وتطور الأمر بعدها للحديث عن استخدام الأسلحة النووية، قادت هذه النقاشات إلى جزم مسؤولين، من بينهم الرئيس الأميركي بيل كلينتون، “أنه من الممكن وقوعِ هجومٍ إرهابي باستخدام مثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة في العقد المقبل”، وفي المقابل نُشرت عشرات الوثائق والملفات على المواقع الجهادية، تُشرّع لهذا الإرهاب البيولوجي (Bioterrorism).
- حاول ابن لادن وخطط لاستخدام أسلحة بيولوجية مبكراً؛ فقد عُثر في آبوت آباد، وهو المكان الذي قتل فيه، على ملف (السموم)، مؤلف من (56) صفحة، لتعليم العناصر كيفية استخدامها، وطرق التنفيذ، كما يحوي تعليمات عن إجراءات الأمان التي يجب اتباعها عند تصنيع السلاح البيولوجي قبل استخدامه في الهجوم الإرهابي، والتجارب التي يجب أن تتم على الفئران لاختبار فاعليته، كما يشرح كيف يمكن لأسلحة لا يكلف تصنيعها الكثير من المال أن تؤتي ثمارها باستهداف أعداد كبيرة من البشر. وأظهرت رسالة عُثر عليها في أفغانستان، على حاسوبٍ يعود إلى أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أن الدعاية الإعلامية لفتت انتباه التنظيم، إلى أهمية استخدام هذه النوعية من الأسلحة. يقول: “لم نكن على علمٍ بهذه الأسلحة إلا عندما وجه العدو انتباهنا إليها، إنه يمكن تصنيعها من مواد يسهل الوصول إليها”.
- نشر تنظيم القاعدة بعد ذلك، مجموعة (أبو خباب المصري) مدحت مرسي السيد عمر، تناول فيها طرق الحرب الكيماوية، وكيفية صناعة القنابل الكيماوية والسامة، وتطوير أنواع من السموم، وكيف يمكن أن ترمى في مناطق معينة، مع المزيج من زجاج مسحوق، للمساعدة في الدخول إلى مجرى دم المصاب[3]. بحلول عام 2002، كان أبو خباب، الذي قتل فيما بعد يوم الاثنين 29 يوليو (تموز) 2008، قد طور سلاحاً بيولوجياً، وهرب إلى الشيشان أو إلى جورجيا، ليستأنف تدريب المتطرفين على استخدام هذه الأسلحة، قبل أن ينتهي به المطاف إلى باكستان.
- حاول عضو القاعدة الماليزي، يزيد صوفات –وهو حاصل على شهادة في التكنولوجيا الطبية والكيمياء الحيوية من جامعة أمريكية– تطوير برنامج الأسلحة البيولوجية التابع للقاعدة؛ حيث ساعد في إنشاء مختبر القاعدة في قندهار بأفغانستان، وقضى عدة أشهر في تحضير الجمرة الخبيثة لصالح الجماعة الإرهابية[4]. وعلى الرغم من أن مختبر القاعدة لم يكن متطورًا بشكل عام، فقد كان محاولة انتهت بتدميره عام 2001، وعاد مؤسسه يزيد صوفات إلى ماليزيا، واعتُقل في العام نفسه، ثم أُطلق سراحه عام 2008.
- وعلى الرغم من أسبقية التخطيط، فإن التشريع والتنظير الفقهي، بدأ فيما بعد، وطرحت “القاعدة” السؤال الآتي: ماذا يعني الهجوم البيولوجي من الناحية الشرعية؟ لم تخرج الأجوبة من السياق الفقهي العام للتنظيم، الذي يرى أن الدول تُحكم براياتها، وأن راية الكفر مرفوعة في كل الديار “غير الإمارة الإسلامية في أفغانستان”، وهذا يجيز قتل الناس على العموم دون تكفيرهم إلا بثبوت شروط وانتفاء موانع.
- أعاد منبر التوحيد والجهاد نشر رسالة، منسوبة إلى ناصر الفهد، تحت عنوان (حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار)، جاء فيها: إنه يجوز استخدام هذه الأسلحة لدك وقصف المقاتلين على الأرض، أو المتخندقين بالخنادق وإصابة نسائهم، أو أطفالهم، إذا تعذر الوصول إليهم بغيرها[5]. وفي مذكرة اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ ﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻷﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻦ تدمير، إجازة استخدام الأسلحة الفتاكة في قتل “الكافرين”، حتى وإن قتلتهم جميعاً دفعة واحدة وقضيت على ذريتهم في وجه الكرة الأرضية[6].
الخاتمة
تعاظمت المخاوف من امتلاك الجماعات الإرهابية لتقنيات تسبب ضررًا كبيرًا، تحت وطأة جائحة كورونا. وبرزت الحاجة إلى وضع آلية لسيطرة الدولة على أمن العلوم التي يمكن أن تستمد منها المجموعات الإرهابية القدرة على إحداث ضرر أكبر، يلفت النظر إلى مرادها. ولكنّ هذا يعيد السؤال عن أهمية تطوير دراسات لفهم نفسيّة الإرهابي، وتطوير قدرة الدولة، وتأمين وضبط مسارات العلوم، وتقليل المخاطر.
[1]– نشرت الدراسة في:
Small Groups, Big Weapons, The Nexus of Emerging Technologies and Weapons of Mass Destruction Terrorism, Major Stephen Hummel And Colonel F. John Burpo | April 2020.
وهي تقع في (٣٦) صفحة،ٌ شارك فيها: العقيد/ إف. جون بوربو (John Brpo) رئيس قسم الكيمياء وعلوم الحياة في ويست بوينت (West point). عمل سابقاً ضابط مدفعية، وخدم في الوحدات المحمولة جواً، وسلاح المدرعات على ناقلة الجنود المدرعة «سترايكر» بجانب مشاركته بعمليات إنسانية، وبقوات حفظ السلام الدولية. كما شغل منصب نائب القائد العام للقيادة العشرين، لقطاع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات (CBRNE). حاصل على بكالوريوس هندسة الطيران من الأكاديمية العسكرية الأمريكية «ويست بوينت» بجانب ماجستير الهندسة الكيميائية من جامعة ستانفورد، ودكتوراه في علوم الهندسة الحيوية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology) بالإضافة إلى الرائد ستيفن هامل (Stephen Hamel) نائب مجموعة مبادرة القيادة العشرين لقطاع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات (CBRNE). شغل مهام عسكرية في أفغانستان والعراق، ومسؤولية خطط الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي (CBRN)، في الجيش الأمريكي في أوروبا «الجيش السابع» (USAREUR).
[2]– عقد مركز المسبار للدراسات والبحوث، جلسة افتراضية لنقاش الدراسة، والتعقيب عليها، بمشاركة الباحثين: إبراهيم أمين نمر، أحمد لطفي، جمانة مناصرة، د. ريتا فرج، عمر البشير الترابي، ماهر فرغلي.
[3]– مجموعة أبو خباب المصري، منبر التوحيد والجهاد، على الرابط التالي:
[4]– بسام عباس، ما هو مستقبل الإرهاب البيولوجي في إندونيسيا؟ ذا دبلومت، 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على الرابط المختصر التالي:
[5]– ناصر بن حمد الفهد، حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار، منشورات التوحيد والجهاد.
[6]– ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻘﻼء، وﻋﻠﻲ اﻟﺨﻀﯿﺮ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫدم اﻟﻌﻤﺎرات وتخريب اﻟﻌﺎﻣﺮ من الديار وﺗﺤﺮﯾﻘﻬﺎ، مؤسسة الأندلس، تنظيم القاعدة.