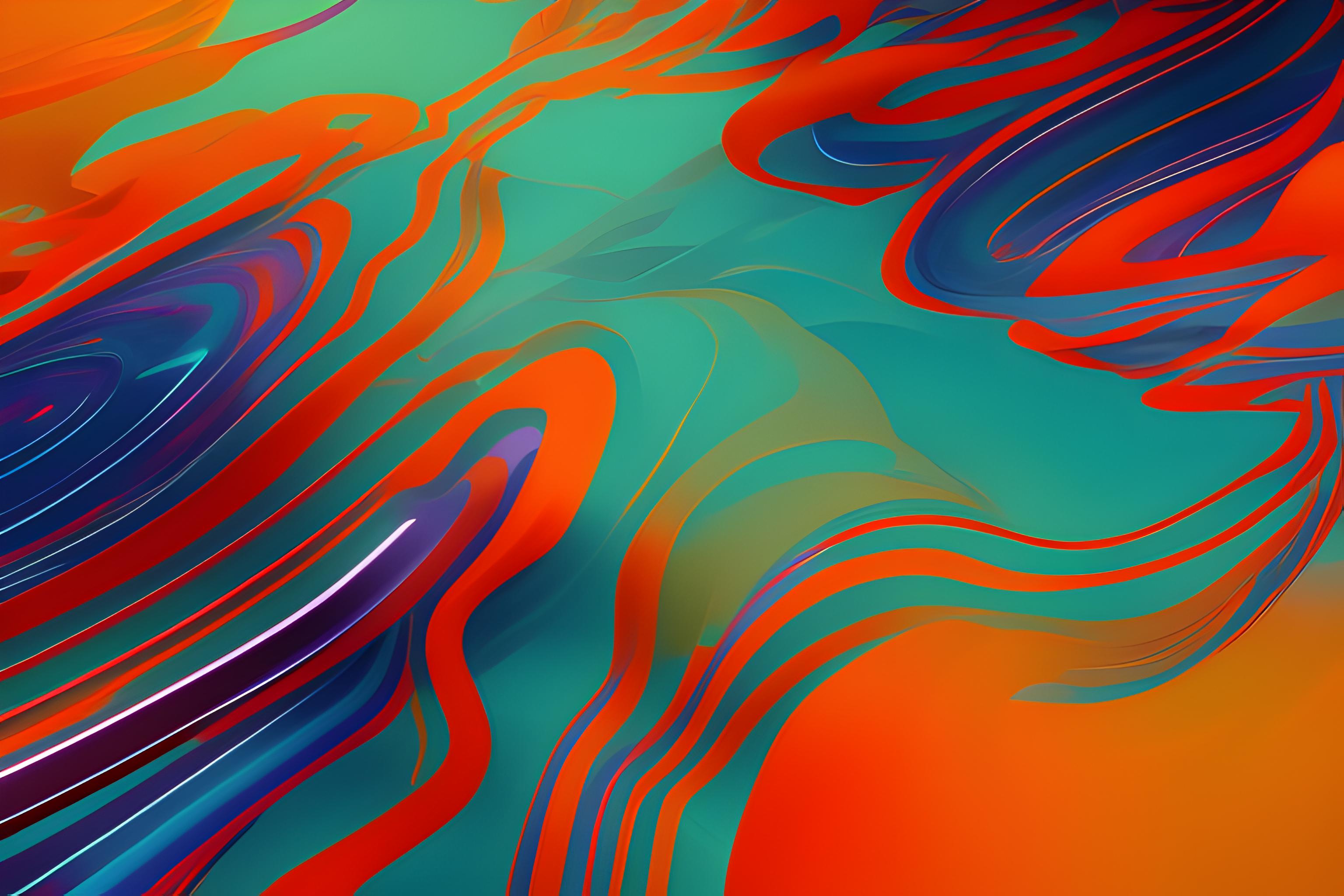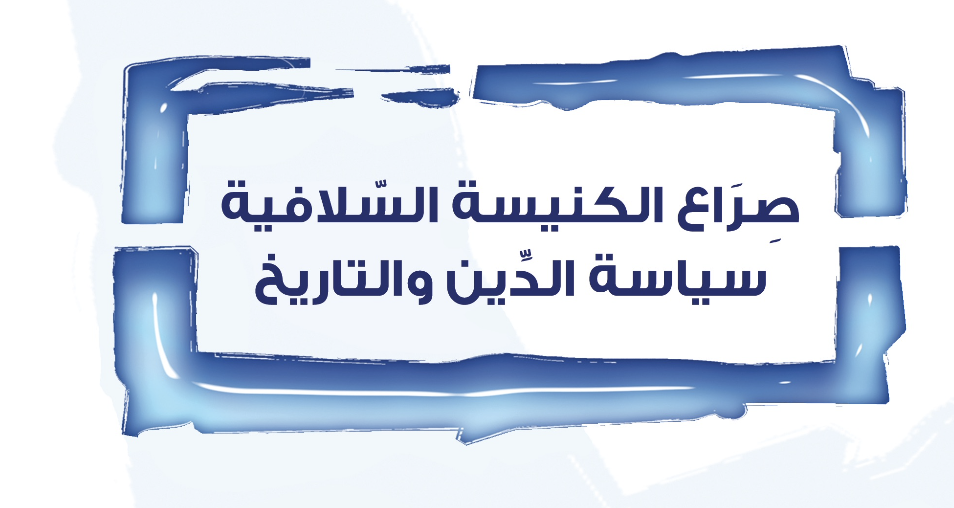دبي:
 تستقي الحركات الإسلاموية عدّتها الأيديولوجية من مصادر تراثية ومعاصرة، ولما أجريت دراسة مسحية عام 2013 على عيّنة تنتمي إلى تنظيم “داعش” تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها اعتماد عناصرها على أسماء مؤثرة لإسناد أيديولوجيته المتطرفة، وأعاد الداعشيون طرح أفكارٍ تعود بجذورها وتأصيلاتها النظرية إلى شخصيات مؤثرة في حركة التاريخ الإسلامي، وإن تمّ ذلك بشكلٍ مشوّهٍ ومبتور عن سياقه أو متصل، فإن بروز هذه الأسماء ارتبط بألسنة المنادين بالعنف الديني أو التغيير الثوري الانقلابي؛ لتبديل المجتمعات العربية والإسلامية منذ النصف الثاني من القرن الماضي.
تستقي الحركات الإسلاموية عدّتها الأيديولوجية من مصادر تراثية ومعاصرة، ولما أجريت دراسة مسحية عام 2013 على عيّنة تنتمي إلى تنظيم “داعش” تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها اعتماد عناصرها على أسماء مؤثرة لإسناد أيديولوجيته المتطرفة، وأعاد الداعشيون طرح أفكارٍ تعود بجذورها وتأصيلاتها النظرية إلى شخصيات مؤثرة في حركة التاريخ الإسلامي، وإن تمّ ذلك بشكلٍ مشوّهٍ ومبتور عن سياقه أو متصل، فإن بروز هذه الأسماء ارتبط بألسنة المنادين بالعنف الديني أو التغيير الثوري الانقلابي؛ لتبديل المجتمعات العربية والإسلامية منذ النصف الثاني من القرن الماضي.
يتناول كتاب المسبار “مرجعيات العقل الإرهابي: المصادر والأفكار” (الكتاب الثلاثون بعد المئة، أكتوبر/ تشرين الأول 2017) بعض المصادر النظرية التي يستند إليها «الجهاديون المتطرفون» و«التنظيمات الإرهابية» و«السلفية الجهادية» لإضفاء المشروعية المزعومة لعنفهم ضد المجتمع والدولة، ساعياً إلى تتبع المسارات التاريخية لنضوج الأيديولوجيات الجهادية على مستوى التنظير والتأصيل والتأثر، على اعتبار أن الفهم العام الذي يحاول تفسير ظاهرة «العنف الإسلاموي» لا بد له من استحضار الرموز والأطر العقائدية التراثية والحديثة، لتحديد القوالب النظرية التي ينهض عليها الخطاب السلفي الجهادي.
أفكار ومواقف ابن تيمية: ما لها وما عليها
عالج عبدالفتاح نعوم (باحث مغربي في العلوم السياسية) أهم معالم فكر وسيرة ابن تيمية، وذلك على نحو غير مدرسي، ومن منطلق السعي إلى استبيان مدى مسؤوليته الأخلاقية عن العنف الذي ينسب نفسه إليه ويمتح برنامجه الفكري والسياسي من إرثه.
يشير الباحث إلى أن ثمة اعتقاداً رائجاً مفاده أن الاتجاهات السلفية التي تعتني بنصوص ابن تيمية، هي اتجاهات لديها فقط خلاف فقهي مع باقي الاتجاهات الأخرى، أو أنها اتجاهات ميسمها الأساسي يتمثل فقط في تشددها الفقهي، وفي تميزاتها الظاهرة في أنماط السلوك والمعاملات الاجتماعية، ونمط اللباس والعيش، وغيرها. لكن في الحقيقة، فإن الجذر الأساسي لهذه التيارات يكمن في خلاف في العقيدة، ظهر في القرون السابقة على ابن تيمية، وقام هذا الأخير بتزخيمه والتنظير له، وأّفرد له متوناً، لم تشكل متون الفقه التي ألفها والمتمثلة في فتاواه إلا ترجمة لوجهة نظره في العقيدة، واستمراراً في الدفاع عنها من حيث السعي إلى تمييز «المسلم» على صعيد السلوك والعبادة والمعاملة، أي تمييز في مجالات الفقه، يقتضيه التمييز الأصلي الذي هو ذو صلة بمجالات الاعتقاد والإيمان والمنطلقات الكبرى للدين.
يجري تصنيف ابن تيمية ضمن ما يعرف بـ«مدرسة الحنابلة»، أي طائفة الفقهاء الذي تشبعوا عبر العصور بفكر الإمام أحمد بن حنبل، وبأنه كان واحداً من أكثر من توسعوا في التراث الحنبلي فقهاً وعقيدة. إلا أن مراوحته في الفقه بين التشدد في التكفير وبين التيسير في بعض المسائل -كما سنرى- يجعله -ربما- مؤسساً لتيار فقهي متنوع المشارب والرؤى؛ ومن ناحية ثانية، فإن تبنيه لوجهة نظر معينة في العقيدة، لا ينسبه إلى الإمام أحمد بن حنبل بقدر ما ينسبه إلى ما يعرف في الدراسات الدينية التقليدية والمعاصرة بـ«عقيدة السلف». فضلاً عن أن التشابه في تجربة «المحنة» بينه وبين ابن حنبل قد يكون واحداً من دواعي ذلك الاعتبار.
يتوافر تراث ابن تيمية على الكثير من وجهات النظر التي لا تستقيم مع عصرنا، علاوة على أنها ليست سوى وجهة نظر لا تختزل الإسلام حتى في عصرها، وذلك مهما حاول ابن تيمية نفسه صوغها في قوالب المرافعات المعرفية العقدية والفقهية. لكن ثم معضلة أخلاقية وعلمية أن يرتبط اسم ابن تيمية بالتطرف والإرهاب والعنف، وما إلى ذلك من أفكار وممارسات لا تمت للإنسانية بصلة، والتي أضحت عنواناً بارزاً لهذا العصر، وعنواناً يجري ربطه بتراثنا العربي الإسلامي، ذلك الارتباط يحتاج إلى قدر من الرزانة والإنصاف، لأن صاحب كل فكر في أي عصر لا يمكن تحميله المسؤولية عن فهم البشر اللاحقين له، مهما ادعوا أنهم يؤسسون أفهامهم عليه، إذ باستحضار فرضية أن يحيا هذا الشخص بينهم مجدداً، سيكون من الوارد جداً أن يخالفهم، إذا كان قد حدث في التاريخ أن قام الأتباع بتكفير وقتل -أحياناً- زعيمهم حينما لا يقرهم على تأويلاتهم، كما قتل الخوارج عليا على سبيل المثال لا الحصر.
من المؤكد أن تراثنا العربي الإسلامي تملؤه الكثير من عوالق النقص، باعتبار المحطات الزمنية وملابسات الوقائع الاجتماعية التي نشأ ذلك التراث ضمن نتوءاتها ومنعرجاتها. ولهذا لا تكاد تجد شخصية من الشخصيات ذات خط واحد فيما يتعلق بالتأسيس للقيم التي باتت اليوم كونية، أي القيم التي تنطلق من الفرد الحر العاقل المالك للحق في الاختيار، والذي يؤسس بمعية الأفراد على شاكلته المجال العام، ويؤطرون مجال الفرد. أي القيم التي أنجبتها صيرورات الحداثة والأنسنة منذ عصر النهضة الأوروبي، وتعممت منجزاتها القيمية والإجرائية على عدد غير يسير من أقطار العالم. واصطدمت في منطقتنا بالتأويلات اللاتاريخية والتراثية للتراث.
ويقول الباحث نعوم تأسيساً على كل ذلك، بأن أتباع ابن تيمية في كل العصور وفي عصرنا هم ذوو تفكير «لا تاريخي»، لكن يمكن أيضاً قول الشيء نفسه عن ابن تيمية، فهو بدوره لا تاريخي، إذ يشدد على رؤية عصر السلف ويسقطها على كل عصره وعلى كل العصور، لكن بؤراً مضيئة توطنت في تجربته لم تأخذ حظها الكافي من الاهتمام، وذلك بصرف النظر هل كانت تقع ضمن حيز المفكر فيه أو اللامفكر فيه لدى ابن تيمية، المهم أنها سقطت من اعتمادات الأتباع، وإعادة إثارة الانتباه إليها هي مهمة جوهرية ضمن مهام استكمال إعادة قراءة التراث واستثماره.
المودودي مُنظِّر الحاكمية والجاهلية والدولة الإسلامية
يقول رشيد إيهُـوم (باحث مغربي في الفلسفة والفكر الإسلامي ) في دراسته: إن العنف الذي يُمارس اليوم، والذي يُعتبر سمة من سمات العقود الأخيرة التي يمر بها العالمان العربي والإسلامي؛ يعبر عن أزمة حضارية بدأت بوادرها ترتسم في شرايين هذه الحضارة منذ سقوط الخلافة العباسية في بغداد بعد الغزو المغولي سنة 1258م، والتي أعلنت بعد ذلك عن انتهاء العصر الذهبي في الإسلام، وبداية التراجع الحضاري للمسلمين، مقابل النهوض الغربي، الذي أسّس للحداثة الكونية.
ويرى أن أهمية العرض التاريخي تكمن في النظر إلى السياق العام الذي يُؤطر ظاهرة العنف الديني كما نلاحظها اليوم، لذلك فإن أي فهم لهذه الظاهرة لا بد له من استحضار مجموعة من المعطيات والمحددات التي تتضافر لكي تنتج هذا العنف الذي يمس من جهة الفكر السلفي، باعتباره المشتل الذي نبتت فيه فكرة «الجهاد»، كما يمس من جهة أخرى صميم الدين الإسلامي، الذي تحول في مخيال الغربيين إلى دين عنف وقتل، وهو ما يفرض على المسلمين إعادة النظر في دينهم وفي واقعهم الحضاري والسياسي، من أجل النهوض وتجاوز التأخر التاريخي.
ويضيف أنه ما دام الحديث عن العنف و«الجهاد» والإرهاب، فإن مواجهته تقتضي الغوص عميقاً في الفكر الذي سمح بظهوره، ونظر له قبل أن يتحول إلى واقع على الأرض. وتعتبر الرموز التي ذكرناها ذات مسؤولية، إما مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأحداث، وكي لا يتم إصدار أحكام متسرعة وطلباً للموضوعية، لا بد من الرجوع إلى الأدبيات التي نظرت لهذا الفكر لمساءلة أطروحاتها، والكشف عن مدى مسؤوليتها المعنوية في هذه الأحداث، وسينصب اشتغالنا على أحد أهم هذه الرموز، القيادي الإسلامي الباكستاني أبي الأعلى المودودي، الذي عاش خلال القرن العشرين، وأسهم في تأسيس «الجماعة الإسلامية في الهند» وفي التنظير لأيديولوجيتها السياسية.
ويخلص الباحث في دراسته وتحليله لأفكار المودودي إلى ما عمل على إيجازها في مجموعة من النقاط المهمة:
أولاً: الطابع الأيديولوجي لفكر المودودي، والذي يجب فصله عن الدين، لأن الدين قد يتحول إلى أيديولوجية للتجييش والدمج والانقلاب، والمودودي خير أنموذج عن الأيديولوجية الإسلامية السلفية الانقلابية التي ارتبطت بسياق تاريخي محدد، والتي استغلت في زمن ومكان آخرين.
ثانياً: ارتباط المشروع النظري الفكري بسياق معين، لا يمكن لغير المطلع عليه، أن يأخذ فكرة وافية عن هذا الصرح الأيديولوجي الذي بناه المودودي، وهو ما أبرزناه في تحليلنا، إذ بينا أن الطموحات السياسية للمودودي ورغبته في الزعامة، في فترة شهد فيها مسلمو الهند تحولاً جوهرياً في تاريخهم، جعلته يوظف الموروث الديني والشعور القومي، كأفكار يمكن أن تؤسس لدولة دينية تحتضن الهنود، وتحكم بينهم بما أنزل الله.
ثالثاً: إن امتداد فكر المودودي وتأثيره على رموز السلفية والإسلام السياسي في الوطن العربي، جعل فكره أكثره انتشارا، ورفع المودودي إلى مرتبة المنظرين الكبار للدولة الإسلامية في الفترة المعاصرة من تاريخ الإسلام.
رابعاً: المودودي له مسؤولية معنوية في ظهور الجهاد والإرهاب في العالم المعاصر، ما دامت أفكاره تشكل عقيدة مجموعة من الجماعات الإرهابية، التي توظف مفاهيم، «الحاكمية» و«تكفير الدول» و«تكفير المجتمعات» و«الانقلاب» و«تطبيق الشريعة» و«القضاء على الجاهلية» وغيرها من المفاهيم. وحتى إن سلمنا جدلاً بأن هذه الجماعات هي التي أساءت الفهم، فإن الثابت هو أن المودودي، أضفى على طروحاته مسحة دينية مقدسة، قد تغري كل مسلم لا يمتلك العدة النقدية والحس العقلي في التمييز بين الصواب والخطأ، ما دام أنه ينطلق من النصوص المؤسسة، وهي القرآن والسنة، ليصوغ من خلال آياتها ومقولاتها، فكراً لا نكاد نميز فيه بين حدود الدين والأيديولوجيا، وذلك راجع بالأساس إلى طبيعة الإسلام نفسه، الذي ظهر في البداية كحركة دينية وسياسية وأيديولوجية تهدف إلى توحيد عرب شبه الجزيرة العربية، وهو ما يقتضي -كما رأينا في المحور الأخير- إعادة النظر في ديننا وتراثنا، من أجل تخليصه من كل التأويلات المغالية، والمتطرفة التي قام بها أشخاص كان هدفهم في المقام الأول سياسياً، ومن ذلك، الحد الأدنى من الفصل بين المجال الزمني، والمجال الديني المطلق، من باب المساهمة في حماية الدين من مقتضى العمل السياسي، المتميز بطابعه النسبي والمتحرك والذي يغلب عليه منطق المصلحة، وإرجاع الدين بالمقابل إلى نفوس معتنقيه وقلوبهم، وفي ذلك تحصين للدين من انحرافات الفاعلين في الحقل الديني.
حسن البنا وأدبيات التطرف العنيف
يشير عثمان بلغريسي (باحث مغربي) إلى أن شخصية حسن البنا ( 1906-1949)، المنظِّر الأول لجماعة الإخوان المسلمين 1928، تثير انقساماً بين منتقديه وأتباعه أو أنصار المشروع الإسلامي الحركي بشكل عام، والمشروع الإخواني بشكل خاص، فهو الشيخ المسلح كما يصفه بعض نقاده، والمجاهد بالسياسة والقتال كما يراه بعض أنصاره. وأنه يمكن التعامل مع حسن البنا، باعتباره أحد المنظرين للتطرف، وتحمله مسؤولية مباشرة عن العنف الموجود في العالم.
واضح أن حسن البنا يتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن إنتاجاته، التي كانت سبباً بشكل أو بآخر في وقائع وتطورات عدة، منها أحداث عنف ما زلت ارتداداتها إلى اليوم.
إن إنتاجات حسن البنا عبارة عن تعليمات مستخلصة من رؤيته للتراث الإسلامي وفق منهج أصولي، تؤطر نظرة مريدي جماعته في جميع مناحي الحياة؛ «الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دين ووطن أو حكومة وأمة، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة»، وقد انبثق هذا التنظيم الذي أسسه البنا من دعوة تبتغي السيطرة على إدارة السلطة في المجتمع، فهو يعتبر «الحكومة الإسلامية صالحة ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير مجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه».
لم يترك حسن البنا ملامح فكر سياسي متكامل، خصوصاً أن محاولته لإعادة إحياء عناصر المثالية السياسية الإسلامية المتعلقة بالدولة، انتهت إلى إنتاج خطاب سياسي عام، وبدون تفاصيل كما نعاينها في النصوص الدستورية على سبيل المثال، وقد ساعدت هذه العمومية على اتساع دائرة الجماعة وأنصارها. في حين استلهم ميراث السلفيين الإصلاحيين الذين سبقوه، سواءً فيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الإسلامية، أو الإصلاح الداخلي، أو العلاقة مع الغرب.
ويتأسس هذا الموقف السلفي الذي تبناه حسن البنا على عدد من المبادئ. ابتداءً من احتكار «الفهم الصحيح للإسلام الذي لا يقبل الجدل إلا في الفروع». هذا الفهم الملخص في استلهام الحلول لمشاكل العصر من القرآن والسنة وتجربة «السلف الصالح»، وِفق «عقيدة أهل السنة والجماعة»، والذي لا ينبغي أن تمثله إلا جماعة جعلت القرآن دستورها وهي «جماعة الإخوان المسلمين».
انطلاقاً من هذا يتأسس المبدأ الثاني وهو «الشمولية والعالمية»؛ أي الامتداد المجالي الموضوعي للدعوة الإخوانية. باعتبار الجماعة تحمل مرجعية نظرية تفسر كل شيء في الحياة وتحمل حلولاً جاهزة لمشكلات الواقع «الإسلام وتعاليمه يحيط بكل ما يخص الإنسان… فهو إيمان وعبادة، وطن ومواطنة، دين ودولة، روح وعمل، كتاب مقدس وسيف»، هذا المشروع غير المحدود بالمكان والزمان «جاء الإسلام الحنيف يعلن الأخوة الإنسانية ويبشر بالدعوة إلى العالمية»، كما أن «إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية، وتحرير أوطانها وإحياء مجدها وتقريب ثقافتها وجمع كلمتها» هي من صميم الدعوة الإخوانية. وظهر هذا التوجه العالمي للإخوان المسلمين باستخدام فكرة «الرابطة الشرقية» التي بدأت مع أحمد زكي باشا، وتطورت فيما بعد عند جمال عبدالناصر في فكرة «الرابطة القومية».
إن الرؤيا المتضخمة للدين، تبرر لضرورة نشوء جماعة تسهر على تنزيل الإسلام «الحقيقي»، فبناءً على المبادئ السابقة، وضع حسن البنا ثلاث قواعد يتأسس حولها نظام الحكم:
مسؤولية الحاكم أمام الله والناس. الوحدة والأخوة بين أعضاء المجتمع انطلاقاً من الوحدة في العقيدة: على اعتبار أن الوحدة قرين الإيمان والفرقة قرين الكفر. إرادة الأمة التي يجب عليها مراقبة الحاكم ونصحه.
يختتم الباحث دراسته بأن حسن البنا أعاد إحياء عناصر المثالية السياسية لدى الأصوليات، وأنزلها من الأذهان إلى الأعيان ليصوغها في قالب حركي تنظيمي يحتكر الحديث باسمها دون تجديد أو إصلاح يفيد الوطن بله الأمة، لأن هاجس التنظيم الديني شبه الطائفي كان حاضراً في جهازه المفاهيمي، كما يلخص ذلك انتصاره لخيار «الحزب الوحيد» القادر على «لم شمل الأمة»، والذي يفترض فيه أن يكون «إسلامياً خالصاً» وهو حزب «الإخوان المسلمين»! وربما لم تستفد الجماعات الإسلامية المتشددة، أو جماعات «التطرف العنيف» التي ظهرت بعد تجربة حسن البنا من الأدبيات التي أنتجها على المستوى الفكري، غير أنها اقتدت به في طرق الدعوة وأسلوب الخطاب والتدجين وتقنيات التدرج في الانتشار، وأيضاً على المستوى التنظيمي المحكم الهرمي القائم على السرية والانضباط.
أفكار سيد قطب وأثرها في الحركات الجهادية المعاصرة
يرى مصطفى زهران (باحث مصري متخصص في الحركات الإسلامية ) أن طروحات سيد قطب الفكرية وامتداداتها، ظلت تمثل إشكالية كبرى وسط الحالة الإسلامية المعاصرة بشقّيها الحركي السياسي والراديكالي الجهادي المتطرف، وطالت أقلام الانتقاد سيد قطب باعتباره المسؤول الأول عن تحولات شهدتها التجربة الإسلامية في العقود الأخيرة من القرن المنصرم، خصوصاً بعد أن سعت تلك الجماعات الجهادية نحو إخراج أفكار سيد قطب من الحالة التنظيرية إلى واقع عملي عبرت عنه تشكلات وتمظهرات الحالة الجهادية المعاصرة بكل أنواعها، بداية من أطوارها التكوينية الأولى مروراً بتنظيم القاعدة وانتهاءً مع آخر نسخها الراديكالية الحالية ممثلة بتنظيم “داعش”، وما رافقها من انتقال من الجماعة الجهادية إلى ما يدعى أنه الدولة.
يبحث زهران في تلك الإشكالية وما يدور في فلكها، وحجم التقاطع الفكري الذي برز خلال تحولات التيار الجهادي وتوثباته من الإطار المحلي إلى الإقليمي خصوصاً في ثوبه المعولم؛ فضلاً عن تبيان حجم التفاعل معها ودرجات التأثير والتأثر، فيما يخلص العمل من خلال عرض لأهم المحطات الفكرية والميدانية لمسيرة ذلك التفاعل وما صرّحت به قيادات «جهادية» متنوعة، عن مدى العلائق وحجم الانسجام الذي أبدته تلك التيارات وتوظيفها لأفكار سيد قطب في إطار مشروعها «الجهادي» بما أتاح لها صبغة شرعية على آلياتها في مواجهة العالم من حولها، خصوصاً الغربي منه وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية.
إذ إن مصطلحات مثلت جدلاً كبيراً -وما زالت- مثل الجاهلية والدعوة إلى الحاكمية والمفاصلة بين أهل الحق والباطل، التي حملتها كتب سيد قطب ومقالاته وشروحاته، وجدت مكانها وضالتها بين أروقة «الجهاديين» ودروبهم الوعرة، مما مثّل إشكالية أخرى تضاف إلى أخرياتها، خصوصاً أنها كانت دليلاً دامغاً لدى البعض على الربط بين قطب وتلك التيارات، التي عززت من راديكالية آلياتها في مواجهة خصومها، وجعلته في بؤر الإدانة الدائمة والاتهام المتواصل، وهو ما سعت دراسته إلى محاولة تشخيصها ووضعها تحت العين المجهرية البحثية، للوصول في نهاية العمل إلى خلاصات استنتاجية، يرى فيها أن سيد قطب انتقل من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين في رحلةٍ غلفتها أفكار أكثر تشدداً، خصوصاً وأنها كانت يوماً بعد يوم ومن خلال سياقات متباينة وظرفيات متعاقبة، تسهم في إنضاج وإخصاب بذور التشبث بالنصوصية ويتم تحويل الهوامش إلى متون، ومن ثم تزداد «قدسية» الآليات التي قد تخضع لجملة من التأويلات والتفسيرات الاجتهادية، وهو ما دفع البعض بعد ذلك إلى جعل أفكار سيد قطب المكتوبة ونظرياته المعروضة واقعاً عملياً، وظفها المتشددون، وهي إشكالية ما زالت تبحث عن حلول منذ وفاة سيد قطب وحتى يومنا هذا.
ويكمن البعد المفصلي لأفكار سيد قطب في تعديل وتأهيل وإنضاج أفكار أبي الأعلى المودودي، حيث أسهم في إخصابها وإنضاجها وقولبتها بشكل أعمق وأكثر امتداداً، ولم تكن ابتداعاً منه، لذا فحجم التقاطع بينهما ومستوى التأثير يجعل من سيد قطب تلميذاً طيعاً لأفكار المودودي و«عراباً» لمن جاء بعده، ليحول هذه الأفكار إلى واقع فعلي على الأرض مع اختلاف التلقف والتعاطي، سواء أكان ذلك من حركات الإسلام السياسي أو الحركات الإسلامية «الجهادية».
الأمر بالمعروف وظاهرية النص: ابن حزم والجهاديون
أحمد الخنبوبي (باحث مغربي في العلوم السياسية ) يقول: إن أحداث 2011 في المنطقة العربية، حركت المياه الراكدة على المستوى السياسي والفكري والأيديولوجي في مختلف دول المنطقة، بعدما عانت هذه الأخيرة من قمع أمني واستبداد سياسي وحجر فكري طيلة عقود من الزمن، ومن الأحداث السياسية المثيرة للجدل ما قام به مجموعة من المحسوبين على الحركات الإسلامية، في شقها السلفي الجهادي، من أعمال بعد الحراك العربي، من خلال تنظيماتهم أو من خلال بعض التصرفات الجماعية والفردية غير المنظمة، وهي الأعمال التي صنفوها في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أثارت ضجة في الساحة السياسية بالمنطقة، كما أنها أحيت مجموعة من الأسئلة المؤرقة حول المستقبل السياسي لهذه الدول، في ظل وجود صراعات فكرية وسياسية تصل في بعض الأحيان إلى مستوى التناقض الصارخ بين الفاعلين السياسيين ورجالات الفكر في هذه البلدان، وبين الفاعلين الإسلاميين أنفسهم بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم.
من خلال الأعمال التي قام بها هؤلاء الجهاديون، يطرح الخنبوبي أسئلة أولية من قبيل: ماذا عن الخلفيات الفكرية لممارسة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قام بها هؤلاء؟ ثم ما علاقة هذه الأفكار بالتراث الفكري والسياسي الإسلامي مما خلفه السلف من اجتهادات وأفكار في هذا الصدد؟
الإشكالية المفترضة في هذا البحث هي: كيف تستلهم الحركات السلفية من فكر ابن حزم الأندلسي بعضاً من مرتكزاتها الفكرية؟ وذلك بناءً على الفرضيات التالية: تنهل أفكار الحركات السلفية من فكر ابن حزم الأندلسي من خلال المذهب الظاهري أو قل التفسير الظاهري للنصوص، وكذا فرضية أساسها أن الحركات السلفية لم تستوعب جيداً أفكار ابن حزم الأندلسي المنفتحة.
يتفرع البحث إلى محورين رئيسين: يتناول الأول بسطاً لبعض مرتكزات فكر ابن حزم الأندلسي وكذا أفكار السلفية الجهادية المعاصرة، ويتناول المحور الثاني نظرة هذين الطرحين الفكريين لمسألة الرأي والتعبير داخل المجتمع واختبار العلاقة بينهما.
سؤال العنف في فكر الخميني بين النظرية والتطبيق
يشير هيثم مزاحم (باحث لبناني متخصص في الحركات الإسلامية المعاصرة) إلى أن الدراسات الموضوعية والحيادية عن الخميني (مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران) هي قليلة، فمعظم الكتابات عنه انقسمت بين دراسات كتبها موالون له بالغت في الثناء عليه وتمجيد أقواله وأعماله، أو كتبها معارضون له فحاولوا شيطنة الرجل وتسخيف أقواله وأفعاله، عمل فيها الباحث على سبر أغوار شخصية الخميني وأفكاره وآرائه السياسية والفقهية في مسائل ولاية الفقيه، والدولة الإسلامية، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطبيق الشريعة، وإقامة الحدود، وحدود استعمال العنف.
تكمن صعوبة الدراسة في قلة المصادر وتشتتها، والتي تتحدث عن رؤية الخميني للجهاد واستعمال العنف للتغيير السياسي، وكذلك لمقاربته لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد ركز معظم الباحثين على دراسة رؤية الخميني لـ«ولاية الفقيه» والدولة الإسلامية من جهة، وعلى تراثه العرفاني من جهة أخرى، بينما ذهب آخرون إلى تأريخ حياته الدينية والسياسية ودراسة دوره في قيام الثورة الخمينية في إيران، ومن ثم تأسيسه للجمهورية الإسلامية فيها وقيادته لها على مدى عشر سنوات قاسية (1979-1989)، شهدت الحرب العراقية- الإيرانية (1980-1988) والحصار الغربي المفروض على إيران، والتوتر مع دول الجوار.
أبو قتادة الفلسطيني والسلفية الجهادية : الفكر والممارسة
يشير محمد لكريني (باحث مغربي في العلوم السياسية) بداية إلى أن مختلف دول العالم شهدت محطات إرهابية خطيرة، من بينها ما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية عبر استهداف مراكزها الحساسة، الممثَّلة في مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وأحداث 16 مايو (أيار) بالدار البيضاء 2003، وتفجيرات مدريد في 11 مارس (آذار) 2004 في محطة قطارات أتوشا رينفي، ثم تفجيرات لندن في 7 يوليو (تموز) 2005 في محطة القطارات تحت الأرض التي تزامنت مع انفجار آخر لحافلة نقل عام تتكون من طابقين، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان سنة 2005 عندما استهدفت مجموعة من الفنادق.
تنبني البنية الفكرية للسلفية أساساً على التشدد والتعصب، وهي أفكار تعود لعصور مضت لم يعد لها مكان اليوم، وفقا لمبدأ «طاعة ولي الأمر»، وفي هذا السياق نجد -على سبيل المثال لا الحصر- أن «الجماعة الإسلامية المسلحة» بالجزائر [G.I.A] ما زالت تعتمد على فتاوى واحد من أبرز الشخصيات التي أشرنا إليها، ويتعلق الأمر بأبي قتادة الفلسطيني.
أضحت الفتاوى بمثابة تهديدات إرهابية تقوم بها «السلفية الجهادية» مستغلة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة (مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، المدونات… إلخ) للترويج لأفكارها بغية استهداف بعض الأماكن في الدول الغربية، بل حتى الدول العربية والإسلامية نفسها مستهدفة. كما استغلت هذه الجماعات أيضاً حالة اللااستقرار في منطقة الشرق الأوسط لكي تتوسع وتنمو.
إن مواجهة الفكر السلفي المتشدد تقتضي أساساً إقرار استراتيجية تهدف إلى تنشئة اجتماعية في المدارس والجامعات العربية والإسلامية والمؤسسات الدينية، مع العمل على رفع التهميش والبطالة والفقر…، هذه الأسباب وغيرها تسهم في تصاعد الفكر الجهادي بدل الفكر الذي يؤمن بالتسامح والإخاء والمحبة.
إن بعض الأعلام الإسلامية المنبثقة عن الحركات الإسلامية تؤمن بفكر متطرف يعود لعصور وعقود مضت، هذه الأفكار لا يمكنها أن تطبق في الظرفية الراهنة لاعتبارات عدة. إن زعماء بعض الحركات الجهادية يقرون بأن: «قتال المرتدين مقدم على قتال غيرهم، أي الكفار الأصليين وعقوبتهم أشد من عقوبة الكفار الأصليين في الدنيا والآخرة، فلا تعقد لهم ذمة ولا أمان، ولا عهد ولا صلح ولا هدنة، ولا يُقبل منهم إلا التوبة أو السيف».
الإسلام السياسي في الجزائر.. أثر ابن تومرت
عقون مليكة (أكاديمية وباحثة جزائرية في مخبر البحوث الاجتماعية التاريخية في جامعة معسكر بالجزائر) تركّز في ورقتها على توظيف الدّين خدمة للمشروع السياسي من خلال إعادة حضور التأويلات الخاصّة للنّص في العراك السيّاسي، فبالنّسبة لابن تومرت تجلّى هذا التوظيف من خلال “تسنين” الاعتقاد بالإمامة وفروعها، العصمة والمهدويّة في إطار سنّي مالكي بحت، بدءاً بتحطيم البنية المعرفية لخصومه، عبر رفضه الفقه الذي يقود إلى التّجسيم حسب ادّعاءات ابن تومرت، ومن ثمّ دعوة خصومه إلى التّأصيل والتّوحيد، ثمّ تكفيرهم عبر خطاب خارجي مقاتل، انتهى بالثّورة عليهم بمقتضى ادّعائه الإمامة والمهدويّة.
أمّا بالنّسبة لحركات الإسلام السيّاسي، ممثّلة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فإنّها وبالنّظر إلى التّجربة التومرتيّة التي حاكتها في المنهج والأسلوب والآليات، نجد أنّها ربما لا تختلف عنها كثيراً، بداية من اتّشاحها بوشاح المهدويّة، لقد اعتبرت نفسها المخلّص والمنقذ، الذي يملأ الأرض عدلاً بعدما ملئت جوراً، وإن غاب عن مشروعها التّأصيل النّظري والفكري، ذلك أنّ قادتها قد راودهم مطمح الإصلاح، ومطمع السلطة فنظروا إلى أنفسهم على أنّهم المؤهّلون لحمل مشعل التّغيير والإصلاح، لهم وحدهم أحقيّة الإشراف على العامّة بإصلاح أخلاقهم، وتخليصهم من ابتزاز الحكّام واستبدادهم، مع أنّهم لم يكونوا أوّل من دعا إلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، على الرغم من إخلاص العديد منهم، لكنّهم أوّل من سخّر هذا المبدأ الخالد لأهداف سياسيّة في تاريخ الجزائر، من خلال صبغ حركتهم السياسية بصبغة دينية. إنّ الانشغال الذي يعني الباحثة في هذه الدراسة ليس ذلك المشروع السياسي في حدّ ذاته الذي تحقّق في الأنموذج الأوّل، وفشل في الثاني، لعلّ ما يعنينا بالنّسبة لكلا التّجربتين، وبصفة خاصة في تجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو المنهج، والأسلوب، والمسوّغات الدّينية، فضلاً عن الظروف السيّاسيّة التي جرت فيها تلك الأحداث.