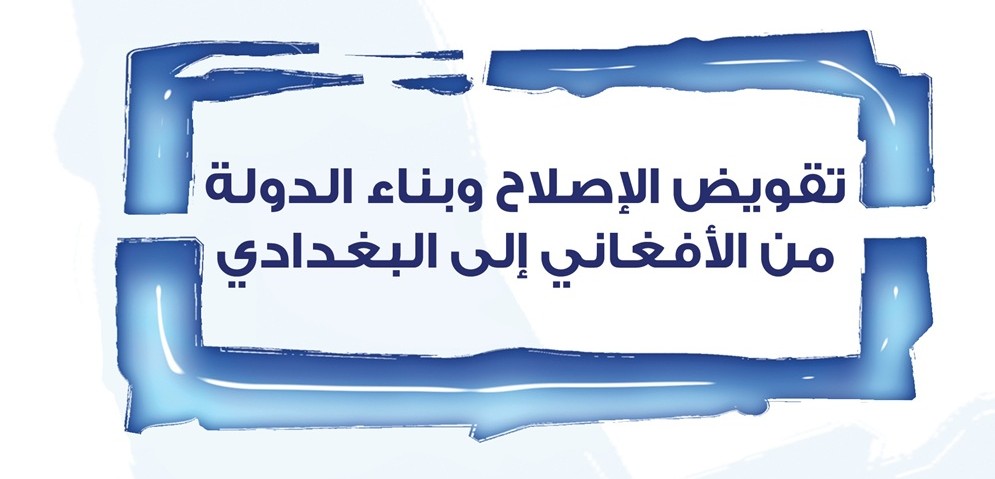ظهر مفهوم “الشرق” لدى الغربيين قبل ظهور مفهوم “الغرب” لدى الشرقيين، مما يعني أن مفهوم الغرب هو بالأساس مفهوم غربي.
يرجع البعض بفكرة التمييز بين الشرق والغرب على أساس ثقافي إلى أرسطو الذي أشار في كتاب السياسة إلى أن البرابرة –بطبيعتهم- أكثر من الإغريق قبولًا للعبودية، والأسيويين أكثر من الأوروبيين، إذ يحتملون السلطة الاستبدادية دون احتجاج. لهذا السبب فإن أنظمة البرابرة طغيانية، إلا أنها أكثر استقرارًا بفعل كونها وراثية وخاضعة لأعراف. (كتاب 2، فصل 14، فقرة 6).
وعلى الرغم من أن مصطلح البرابرة عند أرسطو يتسع لبقية الأوروبيين خارج اليونان، فإن المقابلة بين الآسيويين والأوروبيين من جهة القابلية الطبيعية للطغيان على أساس وراثي، وظفت كنواة إثنية مبكرة لما سيتحول لاحقًا إلى مقولات كلاسيكية مؤسسة للمركزية الأوروبية المتعالية التي سيتبلور في إطارها المفهوم الحديث للغرب.
في القرن التاسع عشر سيظهر هذا التمييز بشكل فج. عند هيجل الذي نظر للشرق كنقيض كامل للغرب، ومرة أخرى تظهر فكرة القابلية للاستبداد كمعيار صريح للمقابلة “فالشرقيون لم يتوصلوا إلى معرفة أن الروح أو الإنسان –بما هو إنسان- حر. ولأنهم لم يعرفوا ذلك فإنهم لم يكونوا أحرارًا، وكل ما عرفوه أن الحاكم حر” (فلسفة التاريخ، ج1).
في إشارته إلى الآسيويين كان أرسطو يستحضر بالأساس نموذج الاستبداد الفارسي على خلفية الحروب الميدية التي اشتعلت بين المدن اليونانية والإمبراطورية الفارسية (494 – 441 ق.م). وفي إشارته إلى الشرقيين كان هيجل يتكلم عن نموذج الحكم في الهند والصين في الشرق الأقصى، دون استبعاد النموذج الإسلامي في الشرق الأدنى والأوسط. لكن مونتسيكو كان قد ميز صراحة في القرن الثامن عشر بين الإسلام والمسيحية معتبرًا أن “الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للمسيحية، والحكومة الاستبدادية أكثر ملاءمة للإسلام” (روح القوانين، ج2، ص178).
طوال القرن التاسع عشر كان مفهوم “الغرب” يتبلور بشكل مضطرد في الوعي الغربي في ظل التمدد الاستعماري، وطفرة التطور الاقتصادي والتقني. لا يشير المفهوم إلى مجرد تمايز بين ثقافتين مختلفتين، بل إلى تفوق مبني على أسباب طبيعية. غرب متقدم وشرق متخلف. بالأساس، نحن حيال مفهوم ثقافي يضمر وعيًا إثنيًا تغذيه السياسة.
بما هو ثقافي فهو، بالدرجة الأولى، ديني تاريخي (لايزال الدين يمثل الرافد الأول للثقافة في الشرق الإسلامي خصوصًا العربي. وهو ظل كذلك في الغرب المسيحي طوال العصور الوسطى، وبدرجة أقل نسبيًا بعد عصر النهضة والانتقال للحداثة). ومن هنا يظل مفهوم الغرب في الوعي الغربي الحديث موجهًا إلى الشرق الإسلامي أكثر مما هو موجه إلى الشرق الهندوسي الكنفشيوسي، الذي لم يدخل معه في مواجهة احتكاك طويلة، كما دخل مع الشرق الإسلامي بفعل الجوار، بدءًا من المواجهات البيزنطية المبكرة، إلى الحروب الإسبانية والصليبية ثم العثمانية، وحتى حروب الاحتلال والتحرير طوال الحقبة الاستعمارية.
بالطبع يظل الدين مختبئ في الثقافي وفي السياسي داخل العقل العربي، حتى في ظل التحولات البنيوية ذات الطابع العلماني التي سادت طوال القرن العشرين، حتى تراجعت سلطة الدين وجرى التعبير عن المفاهيم بلغة علمانية. في هذه المرحلة صار الغرب مفهومًا سياسيًا يستخدم في الإشارة إلى المعسكر الرأسمالي الذي يقابل الشرق الاشتراكي. وظل يستخدم بهذا المعنى من قبل الأنظمة القومية ذات التوجه اليساري في المحيط العربي.
طوال العصر الوسيط لم تكن المناطق البيزنطية تمثل بالنسبة للمسلمين نموذجًا أكثر تفوقًا على أي مستوى اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، ولم يستخدم في الإشارة إليها مصطلح الغرب فقط كانت تمثل “الآخر” الديني المباشر، الذي يعرف بالروم، ويشار إليه فقهيًا بدار الكفر أو دار الحرب.
لم يظهر مصطلح الغرب في الاستخدام الإسلامي إلا بعد الاحتكاك الاستعماري الحديث الذي بدأ مع الحملة الفرنسية مطلع القرن التاسع عشر. ولكن المفهوم كان يتخلق بالتراكم بفعل العوامل التاريخية والنفسية منذ الحروب الصليبية والخروج من إسبانيا، وحروب الأتراك في أوروبا، ليسفر في نهاية المطاف عن مضمون ثقافي ديني سياسي مركب يشير إلى طرف مقابل يمثل نموذجًا “حضاريًا” متفوقًا يلزم اللحاق به، ولكنه يظل نقيضًا دينيًا وخصمًا سياسيًا تلزم المواجهة معه.
بامتداد القرن العشرين، ومع نمو المد القومي بخلفياته العلمانية، طغى المعنى السياسي للمصطلح على السطح على حساب حمولته الدينية. بمعنى أن المصطلح كان يشير إلى الغرب الاستعماري المحتل. لكن المعنى الديني ظل كامنًا تحت السطح السياسي حتى ظهرت الحركات الأصولية التي استعادت للمصطلح حمولته الدينية، وخلطت تلقائيًا بينه وبين مفهوم الحداثة وفكرة التطور، وهنا يكمن المشكل.