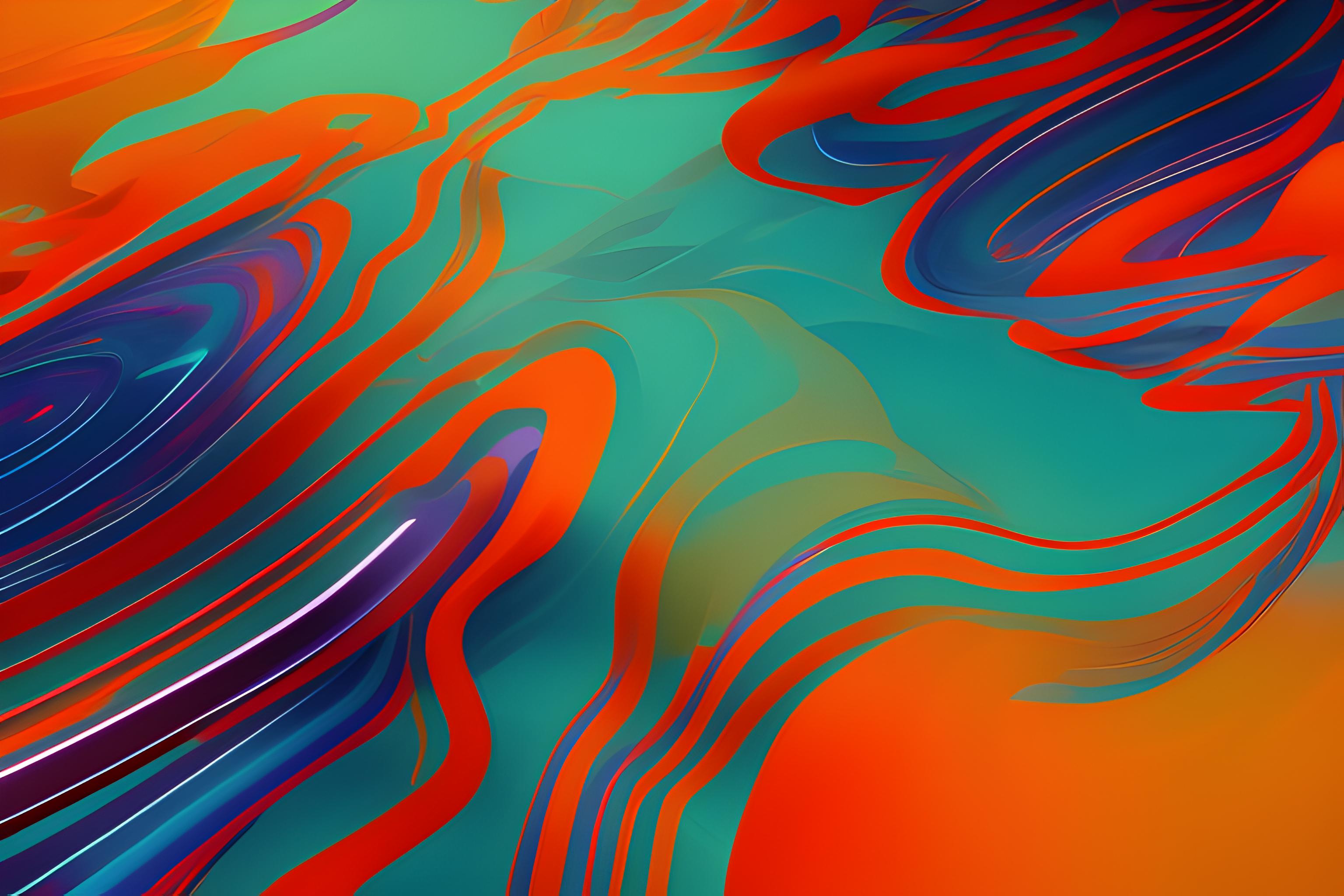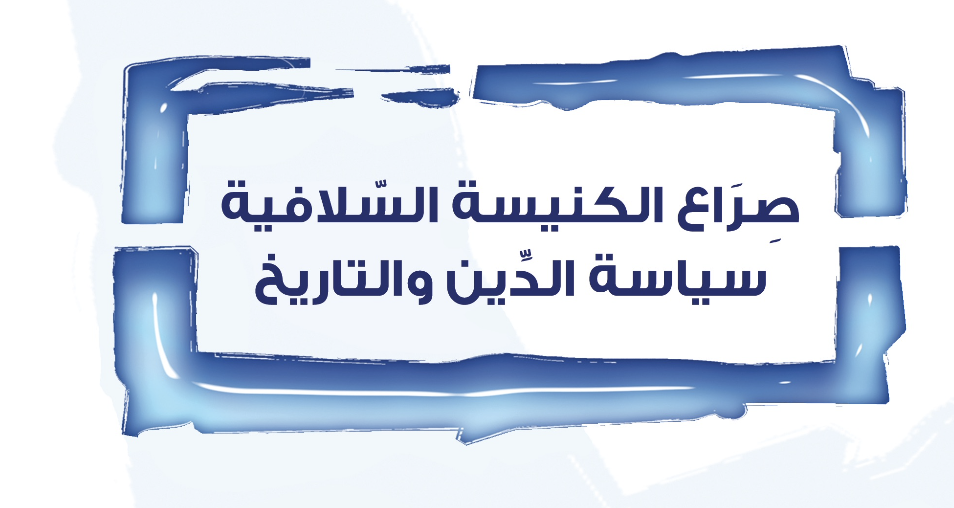حاول يوسف القرضاوي أن يقدم نفسه في الصورة الأبوية القديمة نفسها للحركات الإسلامجية، لكنه لم يملك الكاريزما. أهم مفرداتها أن تظهر في صورة المخاصم للدنيا المتصل بالآخرة، الكائن الرباني الذي يلتزم بالكلمة الربانية ولو فيها مهلكه، حبل مشنقة كسيد قطب، أو حياة كهوف حتى الموت قتلا، كأسامة بن لادن.
ومن هنا كان أسامة بن لادن آخر الآباء. آخر من يمكن لكلمة منهم أن تحدد مصير بقاء شخص في البيت الإسلامي، أو رحيله عنه. أما القرضاوي فعلى الرغم من كل الأضواء المسلطة، والهالة المصنوعة، عجز أن يتجاوز مرحلة الشيخ المقرب من قصر، المسخر علمه الشرعي لرغباته، يمدح له بشارا إن أراد، ويذم له بشارا إن أراد، يزور معه القذافي إن أراد، ويفتي لصالحه بقتله إن أراد. غارق في النعيم المقيم، مستشار ديني لأكبر بنوك الغرب، يجمع مليارات، ويتزوج عذراوات.
مرحلة الأبوة في الإسلام السياسي، بما لها وما عليها، اندثرت ثقافيا بعد ٢٠٠١.
نعم، كانت هناك محاولات سابقة متعددة لأبناء متمردين، لكنهم لم يكونوا خارج الإطار المعرفي. يعلنون التمرد، وينتقدون الكبار، لكنهم يعيشون في جلباب أبيهم. يقيسون الأمور بقيمه. وينتقدونه على مسطرة قيمه. فيأتون بأدلة شرعية أيضا على أنه لم يعد يصلح للقيادة لأنه هو الذي حاد عن المسطرة الشرعية.
ما حدث بعد ٢٠٠١ كان مختلفا.
منذ غزو الكويت اختلطت الفكرة الإسلامية بالفكرة البعثية العروبية، في علاقة طفيلية اعتمادية تبادلية. كائنان عاشا حياتيهما السابقة ينتجان أدبيات يذم فيها أحدهما الآخر، هذا يتهم ذاك بالشعوبية وعداء الإسلام، وذاك يتهم هذا بالرجعية وانعدام الشعور الوطني. لكنهما بقدرة قادر بدءا منذ التسعينيات يتفهمان أنهما قريبان من بعضهما جدا لحد التماثل، وأن الصراع الحاد بينهما سببه الحقيق تضاؤل الفروق، وبالتالي الحاجة إلى بذل مجهود أكبر من أجل التمايز.
اجتمع الاثنان على القسوة والدموية والحسم بالسلاح. على كراهية الأجانب و”استحلال” الاعتداء عليهم تحت شعارات مختلفة. اجتمعا على الشمولية والاعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة. اجتمعا على الاهتمام بالشعارات أكثر من اهتمامهم بالنتيجة المادية الملموسة على الأرض.
سيكون لهذا الاجتماع الذي بدأ في التسعينيات آثار ممتدة، إلى يومنا الحالي، والمقال القادم. أما هنا فموعدنا مع أثره الحركي. مع أول منتجاته البارزة: أبي مصعب الزرقاوي. المرحلة الوسيطة حسب تقسيمي لمراحل ثقافة الإرهابي الإسلامجي.
قبل غزو العراق لم يكن الزرقاوي أكثر من “ابن متمرد” آخر. انعتق من بيعة أسامة بن لادن، وكغيره، لم يكد يسمع به أحد. لكن سقوط البعث في العراق أوجد له راعيا جديدا، وأنتج الثمرة التي تأهلت لها التربة في العقد السابق.
كان اليسار البعثي يحتاج إلى راية الإسلام، تعويضا عن ما فقده. والإسلامجية وصلوا إلى طريق مسدود ويريدون أرضا جديدة، بشروطها.
خلاف الزرقاوي مع أيمن الظواهري بعد ٢٠٠٣ مشهور، تراسلا معا حول مسألة قتل عوام الشيعة، السياسة التي اتبعها الزرقاوي في العراق. وكانت حجة الظواهري بسيطة، أن السابقين لم يقتلوا عوام الشيعة، وإلا لما كانوا موجودين في العراق إلى يومنا هذا.
لا يهمنا الجدل الفقهي ها هنا. تهمنا نقطتان أخريان.
أولا: أن الظواهري كان مهتما بمراسلة الزرقاوي، هذا يعني ببساطة أن الزرقاوي، برعاته الجدد، أثبت أنه مهم. وأن هذا التحالف الجديد صار مؤثرا حركيا.
ثانيا: أن الظواهري لم يفهم ما حدث. وما حدث أن جيل الآباء، والاهتمام بالأدبيات الفقهية، انتهى أو يكاد. وأن السياسة التهمت الدين تماما. الحرب الدائرة في العراق ليست أكثر من صورة أخرى من حرب ممتدة منذ سقوط الملكية. حرب بين البعثيين العراقيين بأسمائهم المختلفة، وحاضنتهم الأساسية السنية الواحدة، وبين الحاضنة الشيعية التي أفرزت هي الأخرى تياراتها، بدءا من الشيوعيين مرورا بحزب الدعوة. الصراع هو صراع ١٩٥٨ و١٩٦١. تتبدل الأسماء لكنها إفرازات مجتمع واحد. تماما كما تبدلت أسماء مدينة الثورة (إحدى ضواحي بغداد)، إلى مدينة صدام، إلى مدينة الصدر. لكنها المجتمع نفسه، الأسر نفسها وأبناؤها.
بدءا من التقويم الزرقاوي، انتهت الحركات الإسلامية التي يعرفها الباحثون الأكاديميون طوال العقود الثمانية السابقة لظهوره. انتهت الحركات التي كانوا يبحثون عن دوافع وموانع أفعالها في أدبياتها “الشرعية”، فيفهمون لماذا تفعل كذا، ويستبعدون أن تفعل كذا. تبلور الحلف الإسلامي البعثي. “البعث العربي الاشتراكي” صار اسمه “البعث الإسلامي الاشتراكي”. هذا ما نتعامل معه. وما لا يفهمه الباحثون التقليديون، ولا يفهمه الإعلام الغربي التقليدي البطيء.
ستتكرر التجربة في مناطق أخرى، بدرجات نجاح وفشل مختلفة. في جوار البعث السوري، بطبيعته الطائفية المختلفة عن البعث العراقي، سيصبح عندنا منظمة اسمها “فتح الإسلام”، هي هي نفسها “فتح الانتفاضة” التي انشقت عن منظمة فتح برعاية سورية، كل الموضوع أنها، تماشيا مع الموضة الجديدة لجيل الأبناء، وضعت اسم الإسلام بدل اسم الانتفاضة.
سأوجز ما فات في نقطتين:
- في هذه المرحلة توارى الجدل الفقهي إلى غرفة التشريفات، كتابا في “النيش”. أعلن الإسلامجية ما أخفوه طويلا، أن “الحركية أولا”، ولا صوت يعلو فوق صوت المصلحة.
- كان الجدل بين الحركات الجهادية الإسلامية سابقا منصبا على فكرة “العدو البعيد والعدو القريب”، نقلا عن جدل شرعي في قرون سابقة. العدو هنا، قريبا كان أم بعيدا، من المقاتلين “ذوي الشوكة”. أما ما يحدث الآن فهو شيء استحدثه الابن، قتل الجار الأعزل الذي لا يتحصن به العدو ولا يأبه. شيء ينخفض مقاما عن معايير المافيا وعصابات الجريمة المنظمة.
إلى هذا الحد يمكن أن ينحدر حامل فكرة الإسلام السياسي، مطمئنا، مرتاح الضمير، مقدما نفسه على أنه بطل. يوما ما في تاريخ أبنائنا وأحفادنا سينظرون إلى هذه الحقبة من التاريخ بنظرة أقسى من نظرتنا إلى آكلي لحوم البشر. لقد خرج من بيننا أقوام “يزهقون لحوم البشر”، يقتلونهم بلا مبرر، وبلا أدنى فائدة. يقتلونهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
كل هذه المواءمات تمت من الجانب الإسلامجي برعاية جماعة واحدة، مراوغة، ثعبانية، متلونة، راعية لكل قيمة سيئة في حياتنا السياسية، حتى وإن كانت أول ذائقي مرها، جماعة “الإخوان العثمانيين”. لكن مهلا. لقد حدث هذا برعاية “الشق القطري” من الجماعة. الشق الذي –توازيا مع مآل الصراع بين الزرقاوي وابن لادن– صار أقوى وأكثر تأثيرا.
الزرقاوي (الإسلامي البعثي) أنجب العبسي، وأنجب البغدادي. بينما كان عزة الدوري خلف الستار.
فماذا أنجبت قطر الإخوان العثمانيين في ثقافة الإرهاب الإسلامجي؟
المقال القادم.