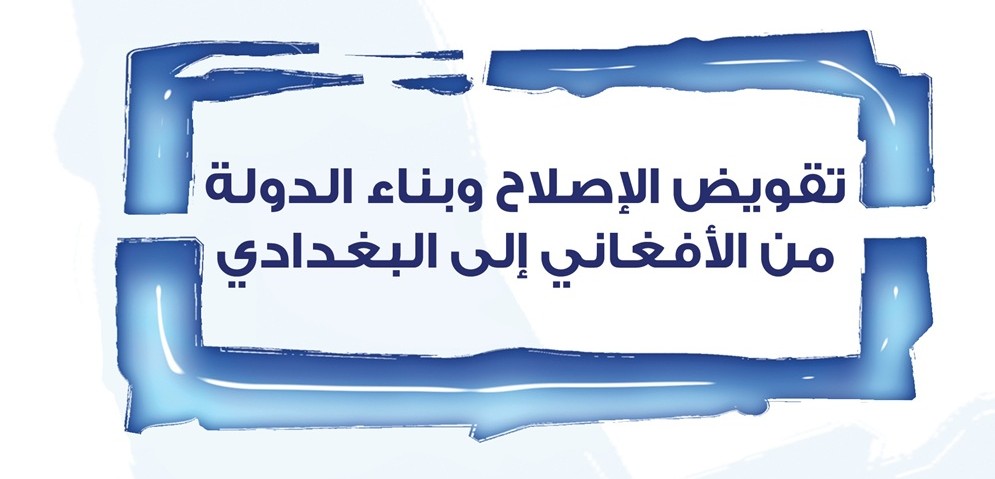كان الغرض الرئيس لهذه المرحلة مقاومة التحديث الذي شهدته دول مسلمة في بدايات القرن العشرين. من أجل هذا كان لزاما على التنظيمات الإسلامية أن تقدم نموذجا لحياة “إسلامية” سلفية ذهبية، وصورة متخيلة مختلقة لـ”جيل قرآني فريد”، وماض تليد.
نبتت هذه التنظيمات بشكل أساسي في صفوف المنتقلين حديثا من مجتمع الريف إلى مجتمع الحضر. والذين تأثروا بما تأثر به أقرانهم في ألمانيا وإيطاليا. صراع بين ماض “إمبراطوري”، وحاضر له مقاييس أخرى ومتطلبات مهارية ومعرفية واجتماعية لم يعرفها مجتمع الريف.
في المجتمعات المسلمة كانت الصورة الموازية هي الإمبراطورية العثمانية التي سقطت لتوها. من هنا نشأت حركة الإخوان “العثمانيون”. تريد أن تعيد تلك الإمبراطورية. وفي الوقت نفسه تعتذر عن مثالبها طازجة الذكرى في أذهان ذلك الجيل، بتبيان أن الإمبراطورية الإسلامية لم تكن دوما عنصرية وشعوبية كما كان الوضع مع الإمبراطورية العثمانية. كما تنسب الفساد إلى التحديث ورموزه، وتدافع عن الباب العالي وحراسه.
المشكلة التي واجهتها التنظيمات الإسلامية أن دولا كمصر والعراق كانت في فترة صعود في ظل الحداثة الوافدة، وضعها بعيدا عن الخلافة كان أفضل كثيرا من وضعها في ظلها، أرض الحرمين تتشكل كدولة وطنية بعد صراع مع الإمبراطورية العثمانية ذاتها.
وفي مواجهة الثقل الفكري للحداثة بكتابها المتصلين ثقافيا بتطورات عالمية، وبإنتاجها الفني والأدبي والاقتصادي والمعماري، كان لزاما على تلك الحركات الإسلامية أن تبحث عن ثقل ثقافي مقابل.
السبب الأساسي لشهرة كتابات سيد قطب أنها كانت بالنسبة لما حولها من كتابات الإسلاميين “حداثية”. بمعنى أنها تستخدم ألفاظا لا يخجل منها طالب الجامعة الذي يريد أن يبدو أفنديا متحضرا. لكنها في جوهرها سلفية التوجه التاريخي، فكرتها الأساسية الاستغناء عن كل ما سوى النهج القرآني، الذي يتفوق فيه الريفي خريج الكتّاب علما على الحضري خريج المدارس الفرنسية.
والسبب التالي لشهرة كتابات سيد قطب أن هذه الطبقة التي تستهلكها تضخمت بعد خطط التوسع في التعليم المجاني الجامعي. صارت الأغلبية الكاسحة من طلاب الجامعات المصرية قادمة لتوها من الريف، مشبعة أساسا بالثقل الثقافي “الأساسي” للحركات الإسلامية. ما نسميه في مصر ثقافة الكتاتيب. ثقافة الكتب السلفية والفتاوى الشرعية التي تحكم تصرفات الناس وسلوكهم.
وهذه منطقة لعب الإسلاميين. كتاب سيد قطب يجذب الأفندي إلى الفاترينة. يدخل المحل فيجد عشرات من الكتب السلفية الصرف، من أول عذاب القبر ونعيمه وعظة الموت إلى أحكام ليلة الدخلة. يستهلك هذه الكتابات المألوفة بعد أن يضع كتابا لسيد قطب على قمتها.
نجوم هذه المرحلة كانوا بشكل أساسي كتابا، بالمعنى الواسع للكلمة. سنجد سيد قطب ومحمد قطب ومحمد الغزالي ومحمد ناصح علوان وغيرهم من المحسوبين على الإخوان المسلمين. لكننا سنجد أيضا شكري مصطفى من التكفير والهجرة. وسنجد من الجماعة الإسلامية (الفرع الجهادي من الإخوان المسلمين الذي نشأ في الجامعات المصرية في إطار ترتيبات السبعينيات) عاصم عبدالماجد وناجح إبراهيم وعبود الزمر وعصام دربالة ومحمد عبدالسلام فرج وآخرين. إلى جانب عشرات الشيوخ المهتمين بالإفتاء.
بالإضافة إلى هذا هناك كتب تنظير تنتمي إلى الجماعات لا الأفراد. مثل حتمية المواجهة، وبحث قتال الطائفة الممتنعة، وميثاق العمل الإسلامي (كلها من الفرع الجهادي للإخوان المسلمين) والقول السديد في بيان أن مجلس الشعب مناف للتوحيد، عن جماعة التوقف والتبين.
أما أنجح مراحلها ثقافيا فكانت الثمانينيات والتسعينيات. في تلك المرحلة كان الريفيون الأفندية الذين تربوا على تلك الكتب في الكتاتيب قد وصلوا في مجتمعاتنا إلى مواقع قيادية. ليس مهما أن يكونوا إسلاميين تنظيميا. لكنهم كانوا منتجا ثقافيا لثقافة الكتاتيب تلك. فعملوا على طبع هذه الكتب ونشرها والترويج لها براحة ضمير. وبراحة ضمير أيضا رأوا أن مهمتهم يجب أن تتسع لمنع انتشار الكتب التي تحمل أفكارا لم يكن معلمهم الأول في “الكُتَّاب” ليرضى عنها.
دون أن يدروا تحول شيخ الكتاب هذا إلى “الأنا الأعلى”. ودون أن ندري صار “الأنا الأعلى” في ذهن المجتمع ككل. ضمير المجتمع الذي يراقب سلوكه، ويلومه، ويشعره بالذنب، إن خالفه – إن تصرف ظاهريا وكأنه متحرر من قيوده وجد نفسه يعود فيكفر عن الإجراء الواحد الذي قد يغضب “شيخ الكتاب” بعشرات الإجراءات التي ترضيه.
كل تلك الخناقة السلفية، صبت في الأخير في اتجاه واحد. تمهيد الأجواء لأصحاب السلاح الإسلامي لكي ينقضوا على السلطة. فيترجموا ما حازوه من سلطة اجتماعية ترجمة سياسية.
كان آخر الوجوه البارزة من هذه المرحلة أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة. بالخلاف الشهير بينه وبين أبي مصعب الزرقاوي نستطيع أن نؤرخ لمرحلة جديدة. في مقال جديد.