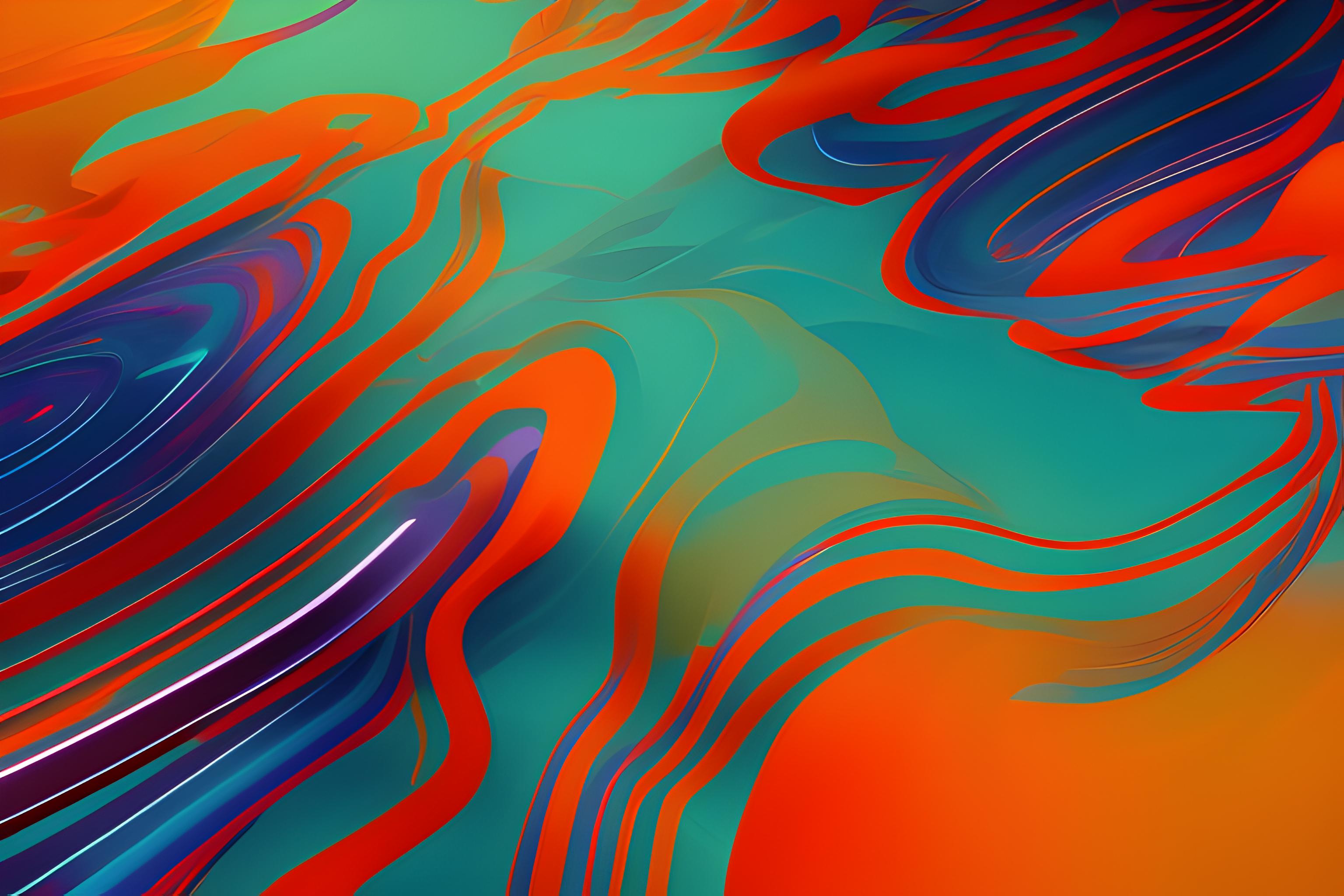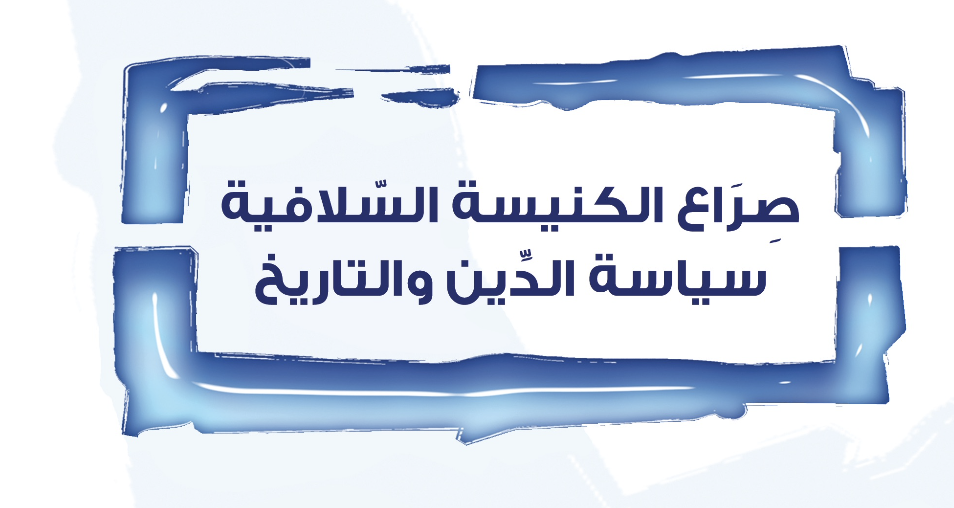ريتا فرج، باحثة لبنانية، عضو هيئة التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث
تضم فرنسا اليوم أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا. سعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة إلى دمج المسلمين في محيطهم الاجتماعي الأوسع، لكن العديد من المحاولات تعثرت لأسباب متداخلة وعلى رأسها غياب الاستراتيجية الجادة لحل أزمة الضواحي (2005-2017).
إثر اعتداءات باريس الإرهابية عام 2015 التي نفذها إسلاميون متطرفون، تعاطت الحكومة الفرنسية بحذر شديد لاستيعاب الصدمة الجرحية، ساعية إلى الفصل بين الإسلام والإرهاب، ولم تقارب غالبية الإنتلجنسيا الفرنسية ما وقع انطلاقاً من ثنائية ثقافية صدامية: “إما نحن وإما أنتم”. لقد بدأت الجهات الفرنسية المعنية بعد هذا الحدث الزلزالي بالعمل على تأسيس “مؤسسة إسلام فرنسا” من أجل إسلام ينسجم مع قيم الجمهورية الفرنسية وفي طليعتها العلمانية، وأتت هذه الخطوة استكمالاً لخطوات سابقة استُهلت منذ ثمانينيات القرن المنصرم.
يطرح اليوم موضوع “الإسلام في فرنسا” قضايا قديمة جديدة ترتبط بتحديات بارزة أهمها: إشكاليات الاندماج، صراع الفضاءات بين الديني والمدني، العلمانية الرادعة، تأهيل أئمة المساجد، التوجس من تنامي اليمين المتطرف، يترافق ذلك مع تنامي الخطاب الشعبوي المعادي للمهاجرين، في ظل أكبر حركة هجرة غير شرعية يشهدها هذا القرن باتجاه القارة العجوز من ضفاف جنوب المتوسط. ومن أجل فهم أعمق لهذه القضايا وغيرها، أجرى مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي حواراً مع البروفيسور محمد الشريف فرجاني.
يهتم فرجاني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليون الثانية (فرنسا)، بالحقول البحثيّة المعنية بالعلوم السياسية، والدراسة المقارنة للأديان، وتاريخ الأفكار السياسية والدينية في العالم العربي. ويعد من أبرز المتخصصين في موضوع العلاقة بين الديني والسياسي في المجال الإسلامي. وقد حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية عن أطروحة «العلمانيّة وحقوق الإنسان في الفكر السياسي العربي المعاصر» (بالفرنسيّة) من «جامعة ليون الثانية» عام 1989. وصدر له بالفرنسية: “Le politique et le religieux dans le champ islamique” ” Islamisme, laïcité, et droits de l’homme”.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
- تركت اعتداءات باريس الدامية التي وقعت عام 2015 جرحاً في الذاكرة الجمعية الوطنية في فرنسا، وتعاطت معها الدولة الفرنسية بإحاطة وطنية لافتة كُتب عنها الكثير. وفي المقابل تعالت بعض الأصوات الداعية لتعامل السلطة الفرنسية بحزم مع المهاجرين، وترافق ذلك مع ارتفاع منسوب الخوف من الإسلام. بعد مرور أقل من ثلاث سنوات على هذه الاعتداءات الإرهابية، هل نجحت فرنسا في تجاوز خوفها من الإسلام؟
– الخوف من الإسلام سابق على هجمات باريس سنة 2015، ويرتبط هذا الخوف بعوامل عدة لعل أهمها تفكك الاتحاد السوفيتي، وكان قد مثل لعقود العدو الذي بنى عليه المعسكر الغربي هويته باعتباره عدوه الفعلي أو الوهمي. وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية قال فلاديمير فيديروفسكي (Vladimir Federovski) وهو أحد المتخصصين الروس في الشؤون الغربية: “نحن بصدد تسديد ضربة قاضية لركن من أركان وجودكم، نحن بصدد حرمانكم من العدو الذي قام عليه كيانكم”.
فما إن انهارت المنظومة الشرقية حتى بدأ البحث عن عدو جديد، بدأت ملامحه تتحدد منذ نهاية السبعينيات مع الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، وشيئاً فشيئاً، بدأ “العدو الأخضر” يحل مكان “العدو الأحمر”، والخوف من الإسلام في أوروبا بدأ منذ ذلك الوقت. ففي بداية تسعينيات القرن المنصرم كتب جان فرانسوا بونسي (Jean-François Poncet)، وزير خارجية فرنسا آنذاك، في جريدة لوموند يقول: “إن بناء أوروبا يواجه تحديات ثلاثة: تحدٍّ إيكولوجي، وتحدٍّ اقتصادي تمثله اقتصادات جنوب شرق آسيا، وتحدٍّ أيديولوجي يمثله الإسلام”. فهو لم يقل الحركات الإسلاموية بل قال الإسلام، ورداً عليه ما انفككت أكتب منذ مطلع العقد الأخير من القرن المنصرم عن خطر الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام.
لم تتكلم السلطات الفرنسية عن الخوف من الإسلام إلا بعد تنامي خطر هذه الظاهرة بعد قرابة ربع قرن من سقوط جدار برلين، والعوامل التي كانت وراء ظهور الخوف من الإسلام في نهايات القرن العشرين ستظل قائمة ما لم تنجح الأنساق السياسية والاقتصادية والثقافية، ليس فقط في أوروبا بل في العالم بأسره، في إيجاد أنماط جديدة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لأن النماذج التي بُنيت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لم تعد قادرة على الاستجابة لحاجات الإنسان لإضفاء معنى على وجوده، وإيجاد تضامنات تسمح له بأن يقبل على الحياة وكله ثقة في نفسه وفي المستقبل. وهنا يكمن الداء. وما لم يتم التصدي لهذه المعضلات وإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع الإنساني، فإننا سنظل دائماً ننتقل من خوف إلى خوف ومن أيديولوجيات تدعو إلى أيديولوجيات تلوح بخطر “حرب الثقافات” و”صدام الحضارات” للفت الأنظار عن الأسباب الحقيقية لمآسي الإنسانية.
- أطلق وزير الداخلية السابق برنار كازنوف “مؤسسة إسلام فرنسا” من أجل إسلام ينسجم مع قيم الجمهورية الفرنسية وفي طليعتها العلمانية. ما الخطوات التي اتخذتها هذه المؤسسة حتى الآن؟
– في الواقع ليست مؤسسة إسلام فرنسا التي أطلقها برنار كازنوف سوى محاولة جديدة في مسلسل مساعي السلطات الفرنسية منذ نهاية الثمانينيات، والتي بدأت مع بيار جوكس عندما كان وزيراً للداخلية، وبعده جان بيار شوفينمون وساركوزي والعديد من الوزراء الفرنسيين. وما قام به كازنوف يأتي في إطار التفاعل مع هجمات باريس. هذه المحاولات تسعى –كما ذكرتِ- إلى دمج المسلمين في الجمهورية، علماً أن فرنسا بدءاً من الثمانينيات قطعت مع وهم الحضور المؤقت للإسلام في فرنسا ومع وهم عودة المهاجرين المسلمين إلى بلدانهم. في هذه الفترة تأسس وعي جديد سعى إلى تطوير آليات دمج الجاليات المسلمة، وقد حصلت تجارب سابقة مثل تدريس اللغات والثقافات الأصلية للمهاجرين لتأهيلهم للعودة إلى بلدانهم، ولاحقاً تم القبول ببناء المساجد ومن ثم محاولات إدخال المسلمين في القوائم الانتخابية… إلخ.
تواجه المؤسسات الإسلامية في فرنسا مشكلة تكمن في كيفية تكوين الأئمة، خصوصاً أن هؤلاء يقدمون خطباً دينية في المساجد ليس لها علاقة بمفاهيم الاندماج، وهي خطب تُبعد المسلمين عن محيطهم فتزيد من عزلتهم واغترابهم في المجتمعات الأوروبية. وهذه المؤسسات التي أشرت إليها تستند إلى رؤية إقصائية تضع المسلمين في حالة من الصدام مع الجماعات الدينية الأخرى والثقافات الأخرى. وأدركت السلطات الفرنسية خطورة ذلك؛ فعملت على التخفيف من وطأته عبر دعوة المشرفين على الجوامع وعلى مؤسسات الإفتاء إلى تبني خطاب يوائم بين المعتقدات الدينية للمسلمين والحياة المدنية في مجتمع علماني متعدد الأديان والتوجهات الفكرية والروحية. في هذا الإطار حاولت “مؤسسة إسلام فرنسا” أن تساعد على تكوين الأئمة في مؤسسات جامعية خاصة، إذ يصعب القيام بذلك في الجامعات العمومية بحكم ما ورثته من علاقات تشوبها الريبة إن لم يكن العداء تجاه الأديان، لهذا لجأت السلطة إلى الجامعات الخاصة الكاثوليكية لوضع دورات لتكوين الأئمة. إن أعضاء هذه المؤسسة التي يرأسها جان بيار شوفينمون أغلبهم من المسلمين العلمانيين مثل غالب بن الشيخ، الذي طالب منذ الثمانينيات بأن يُعترف بالمسلمين كبقية الجماعات الدينية الأخرى مثل المسيحية واليهودية، ومعاملتهم على قدم المساواة مع الآخرين لتطبيق العلمانية الصحيحة التي لا تميز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم الدينية، وهذه المؤسسة تساعد على إنتاج برامج تكونية وإعلامية تتعامل مع منظمات حقوق الإنسان والجمعيات؛ لتقلل من حدة التوتر في علاقة المسلمين مع المجتمعات التي يعيشون فيها في فرنسا، وعلاقة المجتمع الفرنسي بالمسلمين، من أجل إقناع المسلمين بأنهم فرنسيون، وأن مكانهم إلى جانب بقية الفرنسيين، وبأن الإسلام لا يمكن ولا يجب اختزاله في التوجهات السلفية والراديكالية التي ترفض اندماج المسلمين في مجتمعاتهم. هذا ما تسعى إليه المؤسسة، ولكن لا بد أن تجد هذه العملية سنداً من قبل المؤسسات الإسلامية لتجاوز الخطاب المتقوقع الذي يرى في اندماج المسلمين خطراً على إيمانهم.
- رأى المؤرخ الفرنسي جان بوبيرو (Jean Baubérot) في كتابه (Les laïcités dans le monde) (العلمانيات في العالم) أن العلمانية الفرنسية هي “علمانية رادعة” كونها تتعاطى بقسوة مع الرموز الدينية في المجال العام، وهذا ما يتناقض مع حرية التعبير الديني التي أباحها قانون 1905، حيث أعطى مكانة خاصة للأديان على الرغم من عدم اعترافه بأي ديانة، أي إن حرية المعتقد تكفلها الجمهورية الفرنسية للجميع. ما رأيكم في توصيف جان بوبيرو حول العلمانية الرادعة وتعارضها مع قانون 1905؟
– جان بوبيرو هو صديق، ونحن نعمل معاً، وهو مؤرخ وعالم اجتماع متخصص في سيرورات العلمنة والعلمانية. وبقدر ما توجد في فرنسا -كما في العالم العربي- مقاربات مذهبية للعلمانية، يحاول بوبيرو أن يتباين مع هذا التعامل المذهبي الذي يعتبر العلمانية أيديولوجية معادية للأديان بصورة عامة، وتوصيفه للعلمانية الفرنسية بأنها علمانية رادعة فيه شيء من الإجحاف، لأن العلمانية في أوروبا وفرنسا تشقها تيارات مختلفة، وحتى قانون 1905 هو في حد ذاته تباين مع أطروحات إرنست رينان وإميل كومب وغيرهما من الذين اعتبروا أن العلمانية تحارب الدين. وفي طليعة الأديان التي أرادوا مقاومتها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نجد المسيحية ذاتها. إن قانون 1905 أتى لوضع حد للحرب بين فرنسا الكاثوليكية وفرنسا العلمانية، وهذا القانون يضمن حرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية دون تمييز، ويسمح للجمهورية بالتعامل بحياد مع كل الطوائف الدينية.
تخلت الجمهورية الخامسة تدريجياً، تحت ضغط العولمة والتغيرات الدولية، عن الدور الاجتماعي للدولة، وهذا ما أدى إلى إنتاج ظواهر من التفقير والتهميش ما انفكت تتفاقم إلى الآن نتيجة التخلي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعن المصالح المؤمّنة لتلك الحقوق، وما ترتب على ذلك من إقصاء للفئات المهمشة، ومن بينهم المهاجرون، مما أدى إلى ظهور نوع من الارباك في توجهات كل أنساق الاندماج السائدة منذ عقود، وهذا الارباك أنتج ردود فعل من بينها العلمانية الرادعة. وقد أصدرت لي دار التنوير كتاباً تحت عنوان “العلمنة والعلمانية في الفضاءات الإسلامية” أعود فيه إلى هذا النقاش، وأبين فيه أنه لا يمكن للعلمانية أن توجد وتستقر من دون أوفر شروطها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فلا بد من أرضية مكتملة تستند إليها العلمانية، وإذا ما تقلصت مثل هذه الأرضية فلا مناص من تراجع العلمانية تحت ضغط قوى مضادة، وسيلجأ الناس إلى التضامنات القديمة المتناقضة مع العلمانية: العشائرية والقبلية والطائفية، لأن الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعيش إنسانيته منفرداً، وهو بحاجة لارتباطات اجتماعية؛ إذ هو “مدني بالطبع “ -كما يقول ابن خلدون وأرسطو.
- ثمة ظاهرة عرفتها فرنسا في العقود الأخيرة، وهي ظاهرة ما يطلق عليه البعض “الفلاسفة الجدد” من أمثال أندريه غلوكسمان، وبرنار هنري ليفي، وغيرهما من الذين يتبنون خطاباً سياسياً حاداً، على عكس الفلاسفة السابقين من أمثال ميشال فوكو، وجاك دريدا، وبيار بورديو الأكثر التصاقاً بخلق الأفكار وتشكيل الوعي. كيف تفسرون هذه الظاهرة؟
– إن مثل هؤلاء الذين نسميهم الفلاسفة الجدد ليسوا بفلاسفة وإنما كهنة النظام القائم، والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي هو من يسميهم كذلك، وهم نظير من نسميهم عندنا فقهاء السلطة، ويسميهم جان بول سارتر وبول نيزان بكلاب حراسة النظام القائم، ولعل ما ذكرته حول تأزم النماذج التي قامت في أوروبا في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر والعشرين من مظاهره أيضاً أزمة الفكر الفلسفي، وعندما يتراجع الفكر الفلسفي تولد أرضية لظهور الأيديولوجيا. فالأيديولوجيا تترعرع على أرضية تراجع الفلسفة. والأيديولوجيا هي وظيفة كهنة السلطة وليست وظيفة الفلاسفة الذين يساعدون الإنسان على تنمية قدرته على النقد والتفكير بنفسه، لا أن يتبنى الحلول الجاهزة. ومن نسميهم الفلاسفة الجدد هم فصيلة الكهنة الذين يريدون أن يوجهوا فكر البشرية عوض أن يقدموا الأدوات كي يفكر الناس بأنفسهم. لا بد للفلسفة من العودة لأخذ مكانها في تكوين العقل وتنمية قدراته على أن يفكر بنفسه؛ وهذا يقتضي أن يكون للفلسفة في برامجنا التربوية مكانة مهمة، وللأسف ليس هذا ما يتم العمل به في كل البلدان، فحتى في فرنسا تراجعت مكانة تدريس الفلسفة، ولا أتكلم عن البلدان العربية حيث تكاد الفلسفة أن تكون معدومة في البرامج التربوية، وإذا وجدت تكون محاطة ببرامج أخرى هدفها الحد من تأثيرها؛ لأن الدول العربية لا تريد تكوين ناشئة يفكرون بأنفسهم وبشكل نقدي.
- يلاحظ المراقب تنامي أصوات وحضور اليمين المتطرف في أوروبا في العامين الأخيرين، ولم تكن فرنسا بمنأى عن ذلك، وقد تصاعد هذا اليمين مع اضطراب في القيادة الدولية للعالم، وانهيار القيم السياسية العالمية، وبروز رؤساء دول لا يملكون مرجعية أو تاريخاً سياسياً مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كيف تفسرون صعود اليمين المتطرف والخطاب الشعبوي في أوروبا؟ وإلى أي حد يعكس هذا اليمين صراع الهويات؟
– فعلاً يدخل اليمين المتطرف في إطار صراع “الهويات القاتلة” -كما يقول أمين معلوف- وهي هويات يتحصن بها دعاة “صدام الحضارات”، ومن أهم ممثليها في العالم الإسلامي الحركات الإسلاموية التي هي أيضاً، كاليمين المتطرف، تتبنى خطاباً هوياتياً يقوم على الإقصاء وعلى كراهية الآخر دينياً وعرقياً وثقافياً وفكرياً. وقد تنامت هذه الهويات وصارت ملاذ ضحايا الرأسمالية المتوحشة، التي تتحكم في نظام العولمة اليوم بمساعدة من ينتفعون منها لدفع ضحايا العولمة للاقتتال فيما بينهم عوض التضامن والاتحاد لمقاومة المتسببين في مأساتهم.
إن فرنسا ليست بمعزل عن سيرورات العولمة الليبرالية، التي تحرم الإنسان من مقومات ما يساعده على إضفاء معنى على وجوده. كل المهمشين في العالم ومن بينهم المهاجرون وغيرهم من الفئات الاجتماعية الواسعة التي كان لها ما يسمح لها بأن تكون لها مكانة ما في المجتمع، يعانون اليوم من شتى أنواع الحرمان بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة التي تفرضها الرأسمالية المتوحشة، وهذا ما يؤدي إلى إنتاج العصبيات والهويات المتناحرة في ظل التراجع الملحوظ للدور الاجتماعي للدولة. وتبحث الهويات المتصارعة عبر الأفراد والجماعات عن ملاذات تساعدها على مواجهة صعوبات الحياة. وبسبب فقدان التضامنات القديمة، في ظل تقلص فرص العمل وتفاقم ظاهرة الفشل في الدراسة وتدني شروط المعيشة، توافرت الأرضية التي غذت الانتماءات العرقية والقبلية والدينية.
إن ظاهرة اليمين المتطرف هي التي أنتجت رؤساء دول من أمثال دونالد ترمب، ولا فرق عندنا بينه وبين مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا، وزعماء أحزاب اليمين المتطرف في النمسا وغيرهم من الشعبويين على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم. ولا يجب أن تنسينا الهويات القاتلة عند المسلمين الهويات القاتلة في إسرائيل وأمريكا وأوروبا. فهذه الهويات تغذي بعضها البعض، واليمين في أوروبا يأخذ قوته من الحركات الإسلاموية، ونحن نعلم أن هذه الحركات تحالفت مع الولايات المتحدة الأمريكية والاستعمار البريطاني سابقاً، وتواصلت بأشكال مختلفة مع القوى الاستعمارية بما فيها إسرائيل.
نحن إزاء ظاهرة صراع هويات –كما ذكرت في السؤال- ولكنها هويات منغلقة ومشوهة، وصراع قوامه أيديولوجية لا تخدم سوى المتطرفين والمستفيدين من تهميش الفئات الاجتماعية في كل العالم، وهو صراع يندرج في إطار آليات الرأسمالية المتوحشة. وقد أوضح عالم السياسة بنيامين بربار في كتابه (Jihad vs. McWorld) كيف أن العولمة، التي هي أساساً عولمة لنمط الاقتصاد والاستهلاك والعيش في أمريكا –وهو ما يرمز له McWorld – تساعد على تنامي أنواع من المقاومة –يشير لها بكلمة Jihad– لأن أساسها الرغبة في العودة إلى الانتماءات الدينية والعشائريات الجديدة الرافضة للديمقراطية وللحرية وللمساواة ولقيم حقوق الإنسان؛ وهذه الهويات القاتلة تندرج في سياق استراتيجية هدفها منع التقاربات بين الشعوب وكل القوى التي من مصلحتها التقارب والتضامن للانعتاق من أغلال هذه العولمة المتوحشة.