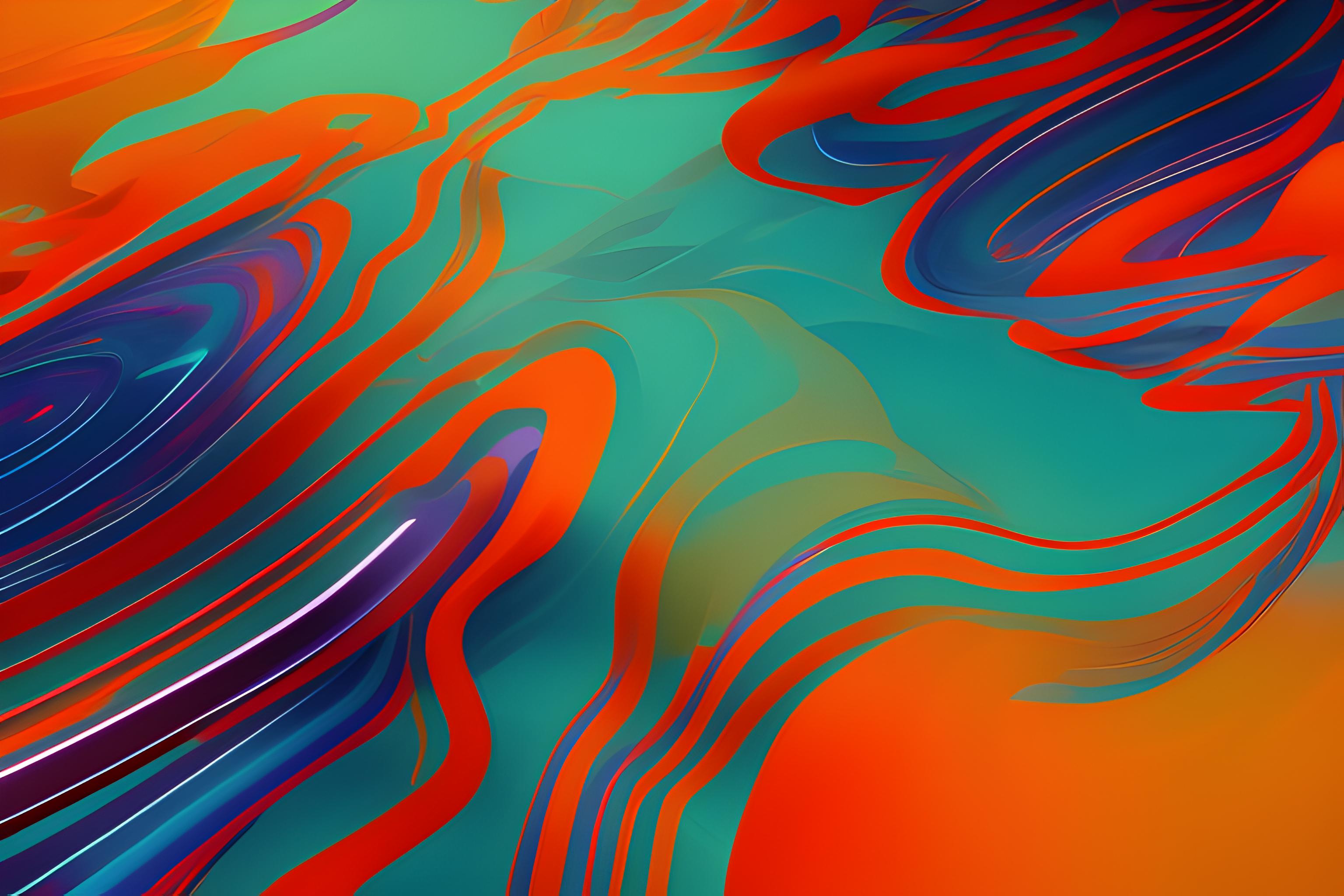منذ عام 2000، عام التحرير من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، يتساءل كثيرون عن نظرية حزب الله في مسألة الدولة، وبالتحديد في صيغة الدولة اللبنانية أي الدولة/ الوطن، وليس الدولة مبتسرةً بانتخابات برلمانية يشارك فيها الحزب بأدوات الطائفية السياسية اللبنانية وهندستها الانتخابية، أو بحكومة أقدم على المشاركة فيها بعد انسحاب الوصي السوري في عام 2005، ثم عاد فانسحب منها خالقاً أزمة بنيوية في النظام السياسي اللبناني.
إشكالية «الحزب الوطني»
كتبت في غضون شهر سبتمبر (أيلول) من عام 1998، سلسلة مقالات بعنوان “أزمة العمل الحزبي في لبنان”، ناقداً انحباس الأحزاب اللبنانية، حتى بعض من يعلن العلمانية في برامجه منها، في البنى الاجتماعية/السياسية للطوائف. وهي البنى التي يكرسها النظام السياسي اللبناني عبر قانون الانتخاب وتوزيع الوظائف وقوانين الأحوال الشخصية الحصرية بالمجالس الملِّية.
وفي هذه السلسلة خصصت مقالاً عن “حزب الله” بعنوان حول “مأزق التحوّل إلى حزب وطني”[2] ، وكنت أعني –ولا أزال- بالحزب الوطني، الحزب العابر للطوائف، والقادر على أن يعبّر في خطابه النظري (أو العقدي)، كما في خطابه السياسي، وفي بنيته التنظيمية كما في برامجه وخططه، عن تطلعات ومصالح فئات واسعة من المواطنين (المواطنين في دولة/وطن، لا الرعايا أو التابعين في طائفة أو مذهب). والتعبير عن المصالح الشعبية والتطلعات الوطنية، لا يقتصر على استدعاء التعاطف وكسب المشاعر، أو استدعاء الاحترام والتقدير لمسلكياتٍ وأخلاقيات، كما حصل ويحصل حيال استبسال مقاومة مسلحة شجاعة وجريئة.
إن التعبير الوطني لحزب سياسي ومقاوم هو مشروع وطني متكامل الأبعاد، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومحور وحقل هذا المشروع هو الدولة، بناءً وإصلاحاً وتطويراً، لا حقل منطقة معينة أو طائفة بعينها، هذا في حين أن البعض فهم أن صفة “الوطني” تعني “حب الوطن والموطن” فحسب، فاستغرب واندهش أن تقابل مقاومة الحزب وتضحياته بالرأي القائل إن “مأزقاً” يمر به الحزب في التحوّل إلى “حزب وطني”.
وإذ أكرر اليوم أن “الوطنية” لا تعني فقط التضحيات والبطولات والاستشهاد كما حصل في معارك التحرير قبل 2000، وكما حصل في حرب يوليو (تموز) 2006، في عملية التصدي للعدوان الإسرائيلي وإرباك آلته وأدائه العسكري، وإنما تعني وتشمل أيضاً اندراج التضحية والشهادة والبطولة في مشروع وطني. أي في مشروع دولة/ وطن، تكون فيه المواطنة هي الأساس والركيزة، والعلاقة بالدولة ومؤسساتها عبر القانون، لا عبر وسيطٍ فرد (زعيم)، ولا عبر وسيط متمثل بجماعة أهلية لها خصوصياتها، ولا عبر حزب مسلح ولو كان هذا الأخير حزباً مقاوماً وبطلاً.
ولا بأس أن نكرّر اليوم “أن مأزق التحوّل الوطني” لا يشمل فقط “حزب الله” وإنما أيضاً كل الأحزاب اللبنانية ذات الخلفية السوسيولوجية الطائفية. ولكن مع تمايزات بل فروقات، تفرّق “حزب الله” عن أمثاله من الأحزاب اللبنانية ذات الطابع السوسيولوجي الطائفي كما سنبين.
وقد يعترض البعض فيقول إن حزب الله ليس “حزباً طائفياً”، إنه حزب عقدي ديني. ورأيي أن هذه “العقدية الدينية تقدّم عنصراً مأزقياً إضافياً في الممارسة السياسية للحزب في حقل الاجتماع السياسي اللبناني، وفي مسار العمل من أجل تمكين وتطوير مشروع الدولة المدنية اللبنانية. وهذا ما يحاول المبحث التالي أن يشرح إشكاليته المعقدة.
دولة هشة وحزب قوي
كانت فرضية المقالة في عام 1998، تشير إلى “عائقين” أو صعوبتين تحدّان وربما تمنعان الحزب من صياغة وإقامة دولة بالمعنى الحديث، أي دولة مواطنين وليس دولة طوائف، أو دولة مؤجلة إلى ما شاء الله، حتى تصبح “عادلة وقادرة”. وبالانتظار تبقى الدولة هشة والحزب قوياً. السببان اللذان أشير إليهما واللذان لا يزالان قائمين حتى اليوم (أعود فأكرر)، هما:
السبب الأول: مرتبط بالمنطلق التأسيسي، وهو الإيمان بولاية الفقيه المطلقة أو العامة ممثلة بآراء وفتاوى وأحكام وإرشادات الولي الفقيه، المؤسس الإمام الخميني، وحالياً بالسيد علي خامنئي مرشد الدولة الإيرانية “وولي أمر المسلمين”، ووفقاً لهذا الإيمان يجري دمج كامل بين الدين والسياسة، بل تتأسس السياسة على المعتقد الديني والتكليف الشرعي، أي أن التقليد الواجب على المكلَّف المسلم الشيعي حيال “مرجع تقليد مجتهد” في مسائل العبادات، يسري أيضاً في مسائل السياسة حيال ضرورة طاعة الولي الفقيه العام، ومرشد الدولة في إيران، الذي هو الآن السيد علي خامنئي.
وإذا كنا قد تطرقنا في أماكن أخرى لإشكاليات الاندماج بين الدين والسياسة، ومخاطرها ومفارقاتها، فإننا نضيف هنا أن هذا الدمج يستتبع على المستوى الاجتماعي/الثقافي إشاعة ثقافة اجتماعية مذهبية واحدة، تجد تربتها القابلة لإخصابها في ذاكرة جماعية شيعية، كما أنها تجد اليوم من يغذيها ويحميها على مستوى المؤسسات، وتكنولوجيا الإعلام والصورة والصوت، ومواهب خطباء حزب الله ومتكلميه ومشايخه من المعمَّمين، الذين يتخرجون بالعشرات من الحوزات الدينية التابعة للحزب.
فعلى مستوى المؤسسات الاجتماعية والنوادي الحسينية والمدارس التي يشرف عليها حزب الله وجمعياته وأجهزته، يجري جهد مُمنهج وكثيف وهادف لإرساء ثقافة خاصة جداً ومؤثرة في سيكولوجيا الفرد والجماعة، بدءاً من أجواء مجالس العزاء ذات الأسلوب الإيراني في الأداء (اللكنة واللطم المُوقّع على الصدور)، إلى اعتماد برامج تثقيفية وتعليمية تاريخية، تجهد في إبراز وتوظيف رمزية الذاكرة التاريخية الشيعية في خطاب وموقف سياسي راهن، وبأساليب سيكولوجية نافذة في سيكولوجية الجماعات.
السبب الثاني: الارتباط بالتحالف الاستراتيجي الإيراني/السوري. وهذا التحالف، وبمعزلٍ عن أحقيته المبدئية في مواجهة التحالف الأميركي/الصهيوني، يرى أن لبنان ساحة صراع. هو أرض مواجهة انطلاقاً من استعدادات لبنان البشرية والثقافية التي يتيحها انفتاحه وديمقراطيته، التي أنجبت أحزاباً متعددة ومقاومات عديدة، من بينها المقاومة الفلسطينية ثم المقاومة الوطنية، وأخيراً المقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله. وإذا كانت المقاومة الوطنية قد أخذت درساً من تجربتها في مرحلة الهيمنة الفلسطينية على الحركة الوطنية، ليتحول بعضها إلى العمل من أجل بناء الدولة/الوطن، فان ارتباط حزب الله بالمحور الإيراني/السوري، سلاحاً ومالاً، يتم اليوم على حساب مشروع الدولة/الوطن، في حين تسكت كل الجبهات العربية.
كان من المتوقع بعد التحرير الذي أنجز في عام 2000 أن يبذل الحزب جهداً نظرياً وتنظيمياً وثقافياً للتحوّل إلى حزب سياسي مشارك في الدولة، ليس على مستوى البرلمان الذي سبق أن دخله عبر الانتخابات البرلمانية على امتداد التسعينات، بل في الحكومة وعبر برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وسياسات مصالحة وطنية. ولنتذكر أن مثل هذه السياسات (سياسة المصالحة الوطنية) كان قد بادر إليها أقطاب لبنانيون: البطريرك الماروني، وليد جنبلاط، الرئيس رفيق الحريري وأيضاً الرئيس نبيه بري.
وإذ أغفل الحزب مشروع المصالحة الوطنية، مكرساً ترك تيار “قرنة شهوان” المسيحي معزولاً ومحاصراً، بسبب مطالبة هذا الأخير طيلة عقد التسعينيات بانسحاب القوات السورية من لبنان (وفقاً لبنود الطائف)، ومكرّساً أيضاً ترك ميشال عون (حليفه اليوم) بسبب نشاطه وتحريضه المجتمع الدولي، ولاسيما الكونغرس الأميركي، على مساءلة ومحاسبة سوريا لـ”احتلالها” لبنان، وإذ أغفل الحزب كل هذا، جرى التركيز في خطابه الدعوي على تحرير مزارع شبعا وإطلاق سراح الأسرى، وعلى اعتبار أن أهداف المقاومة لم تنجز بعد، واستمرّ الزهد بعضوية الحكومة قائماً حتى رحيل القوات السورية وجلائها عن لبنان بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
بعدها وجد الحزب أن من الحكمة المشاركة في الحكومة، بعد أن شارك باحتساب مقاعد في البرلمان عبر التحالف الرباعي مع وليد جنبلاط و”تيار المستقبل” وحركة “أمل” في انتخابات 2005، أي عبر اللعبة الطائفية السياسية المعتمدة في قانون الانتخاب اللبناني، والمرتكزة على القاعدة الزبائنية (المحسوبية) التي أصبحت آلية عضوية من آليات العمل السياسي اللبناني، سواء مارسَ هذه الآلية زعيم طائفة أو حزب لطائفة. ويستوي في ذلك حزب الله والأحزاب “الحاكمة” حصرياً في طوائفها، في هذا المجال من العمل السياسي.
هكذا احتكر الحزب بعد إلحاقه “أمل” به، التمثيل الشيعي في الحكومة، ودشَّن نهجاً جديداً في سياسته اللبنانية: تعطيل فعالية الأكثرية الحكومية باستخدام سلاح “الديموقراطية التوافقية”. ومن المعروف أن الديموقراطية التوافقية لا تعني ولا تستتبع حق النقض (الفيتو) لتعطيل عمل السلطة التنفيذية في النظام الديموقراطي التوافقي المنبثق عن الوفاق الوطني (ميثاق 43 واتفاق الطائف 89).
إن حق النقض عبر موقف تعليق عضوية “وزراء طائفة”، كان بدعة دستورية، وهو فضلاً عن ذلك دفع بالطائفية السياسية اللبنانية المتفاقمة إلى حدود الطائفية الفيدرالية. وكأنّ الميثاق الوطني المتمثل بالعيش المشترك هو فيدرالية طوائف تستطيع “فيدرالية الشيعة” أو أي فيدرالية طائفة أخرى أن تعلّق عضويتها فيها ساعة تشاء دعماً لموقفها السياسي. والأمر الذي فاقم هذا المنحى، أو عبر عنه على الأقل، تدخل أحد المعممين في الطائفة الشيعية للإفتاء بـ”عدم جواز استبدال وزراء الشيعة المقاطعين مجلس الوزراء”.
كان هذا –حين حصوله– مؤشراً لانتقال الحزب إلى مرحلة جديدة في العمل السياسي: الانخراط في الطائفية السياسية اللبنانية واستثمارها، بعد أن زال الغطاء الداعم المتمثل بالدعم السوري أمنياً وسياسياً وعسكرياً، واستكمل هذا الانخراط بالتفاهم الوظيفي بين الحزب والتيار الوطني الحر (لأسباب مختلفة) حيث امتص التفاهم لاحقاً حدّة انخراط الحزب في شيعيته السياسية. وذلك أن الحزب كان يصر في أدبياته على النأي عن الطائفية ليؤكد على عقديته وليس على طائفيته، وسنتطرق إلى هذه المسألة لاحقاً.
ومع ذلك، شكل التجاذب الطائفي والتنافر الطائفي في الوقت نفسه، الحال السائد في العلاقة القائمة بين طوائف لبنان وأحزابها الكبرى الحاكمة ومنها حزب الله.
لقد شكّلت التحالفات بين الأكثريات في كل طائفة، أداةً انتخابية لإيصال اللوائح إلى البرلمان. فلمّا انفرط عقد التحالف الرباعي الانتخابي وخرج العماد عون من منظومة 14 آذار، تشكل اصطفاف جديد بين أكثريتين طائفيتين لا هو بالحِلف ولا هو بالتحالف، إنه “تفاهم” على غطاء مشترك لخصوصيتين وهدفين يسعيان لتغيير الأمر الواقع: طموح عنيد للرئاسة من جهة، وإيمان عتيد بـ”قدسية” السلاح والحفاظ عليه. أما التفاهم فيصاغ باعتراف متبادل: “العماد عون مرشح جدي للرئاسة” يصرّح السيد حسن نصرالله، وأما عن الموقف من السلاح فيتدرج الموقف منه من “النزع” إلى “التسليم” إلى البحث عن منظومة دفاعية واستراتيجية دفاعية كما تشير ورقة التفاهم وكما ذهبت تصريحات السيد ميشال عون.
لكن متابعة سياقات الأحداث منذ عام 2000 وحتى انفجار حرب يوليو (تموز) 2006 كانت تؤشر إلى حيزين أو مستويين في استراتيجية حزب الله: المستوى السياسي اللبناني، حيث استمرت بامتياز طائفية العمل السياسي اللبناني، إذ تم توحيد الطائفة الشيعية حول الحزب تأسيساً على المخاوف المتبادلة بين الطوائف، وحيث نُظر شعبوياً إلى سلاح حزب الله كحامٍ للطائفة ومتراسٍ وحصنٍ لها. وهذا هو المنظور الشعبوي الشيعي للحزب، إلى جانب منظور قومي ووطني كمقاومٍ ومتصدٍّ لإسرائيل.
أما على المستوى الثاني، المستوى الاستراتيجي، فغلبت العقدية الدينية على توجهات الحزب واستراتيجيته. لقد كشفت حرب يوليو (تموز) 2006 أن استعدادات حزب الله من زاوية عسكرية وعلى قاعدة عقيدته القتالية الجهادية، تتجاوز الاستعدادات لتحرير مزارع شبعا واستعادة الأسرى، ولاسيما أن قوى سياسية لبنانية كانت تعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى هذين الهدفين بالوسائل الدبلوماسية والعلاقات الدولية. هذا في حين كان الحزب يراكم بعد الـ2000 عتاداً عسكرياً هائلاً، وكان يجري الترميز إلى أهميته بشعار “توازن الرعب”، وبمشهدية استعراضية عسكرية كانت تقام بالمناسبات. وكان أكثر هذه المشاهد دلالة في الترميز إلى القوة العسكرية “المتجاوزة” للجيش اللبناني المشهد الذي احتفل فيه بتطيير طائرة بلا طيار. وكان من الإشارات للاعتزاز والتفاخر بذاك الإنجاز، عرض أمين عام حزب الله على وزير الدفاع السيد عبدالرحيم مراد الذي كان جالساً في مقدمة الحضور (ومن قبيل المزاح الهادف) استعداد الحزب لأن يبيع الطائرة للجيش اللبناني بسعر خاص!
لقد أضحت صيغة “توازن الرعب” إذن، استراتيجيةً برّرت بدورها عدم إرسال الجيش إلى الجنوب بحجة حمايته (حماية الجيش)، ولكي لا يوضع في فم التنين أو “بوز المدفع” على حد قول أمين عام حزب الله، وقُدّمت هذه الحجّة –على لسان أنصار الحزب- كحكمة سياسية وعسكرية. ولكن كان من نتائج هذه الحكمة إبقاء الدولة ضعيفةً وهشة في الجنوب، ولاسيما في المنطقة الحدودية حيث حصرت المواجهة بالمقاومة الإسلامية التي يقودها حزب الله.
وكان من نتائج هذه “الحكمة” أيضاً أن اندرجت تداعياتها ومفاعيلها ووظيفتها في سياق علاقات دولية وإقليمية متوترة بل متفجرة. وكانت السياقات كلها من إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا، تذهب إلى التقاطع في لبنان وفي جنوبه لتحوّله ساحة صراع بين كل هذه القوى وتحت شعارات وخطابات ذات وقع إيديولوجي معبِّئ: “أمة” غير محدّدة المعالم يدّعي خطاب الحزب الدفاع عنها والنطق باسمها، “وشرق أوسط جديد” يروِّجه خطاب أميركي مستفز، وقصير النظر، لا يملك أي تحديد أو تعريف أو أي شرط من شروط تحققه (إن وجِد). فيسهل على إعلام الحزب إعطاء معركته وسلاحه بعداً عربياً وإسلامياً ضد الهيمنة الأميركية والمشروع الصهيوني انطلاقاً من لبنان. الأمر الذي يعيدنا إلى سؤال مصيري رافق معظم التجارب التاريخية التي مرّ بها لبنان، بدءاً من ثورة (1958) والموقف من المشروع الناصري، إلى الموقف من المقاومة الفلسطينية وعملها في “الساحة اللبنانية”، إلى الموقف اليوم من المقاومة الإسلامية التي يقودها حزب الله: السؤال: ما دور لبنان؟ هل هو مجرّد ساحة لمشاريع المنطقة؟ أم هو دولة/وطن. فما هو موقف حزب الله من هذه المسألة؟
«حزب الله» وولاية الفقيه العامة
يتساءل كثر -ولاسيما في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ لبنان المعاصر، وبعد الهزّة العنيفة بل الزلزال الذي ضرب لبنان- أي دولة يمكن أن تجنبنا الحروب الأهلية الدورية، كما الحروب الإقليمية التي يسهل أطرافها تحويل لبنان إلى ساحة حربية، أو مختبر قوة؟ وأي إصلاح يمكن أن يؤسس لدولة/وطن، لدولة مواطنين، لا لدولة/طوائف.
يرفع حزب الله، ومنذ انطرحت موضوعة سلاحه على بساط الحوار، شعار “الدولة العادلة والقادرة”، ثم لا بأس أن يضاف لها بعد مقالة غسان تويني “الدولة المقاومة”[3] . على أن هذه الصفات (القدرة، والعدالة، والمقاومة) هي صفات نسبية تاريخية، أي هي نتائج لمسار تاريخي يتشكّل ويتكون. هي مشروع لا يهبط مُنجزاً من السماء، بل هي جملة من البرامج والخطط والمنطلقات القانونية والدستورية، وهي إلى ذلك محكومة بنظرية معينة للدولة وبثقافة معينة في المجتمع الذي تنبثق عنه الدولة.
وإذ لا يكفي أن يقال إن الدولة “ضرورة” للاجتماع الإنساني، وهو مبدأ اتفقت حوله جميع الفلسفات والأدبيات ومذاهب الفقه في الإسلام. كالقول الذي يشدّد عليه السيد حسن نصرالله في مقابلته في السفير “لابد من إمام…” أي لابد من دولة، وهو قول سبق للإمام علي أن واجه به الخوارج الذين رفعوا شعار (لا حكم إلا لله..). وإذ لا يكفي هذا القول العام، كما لا يكفي انخراط حزب الله في مؤسسات الدولة اللبنانية، في البرلمان كما في الحكومة، وبصيغ ما أتاحته وتتيحه الطائفية السياسية اللبنانية من أشكال المشاركة وتوزيع الحصص، إذ لا يكفي كل هذا، لأن المقصود هو غير هذا، فالمقصود هو كيف نعيد بناء الدولة/الوطن، دولة المواطنين، الدولة ذات السلطات المدنية، بعد كل هذه التجارب المريرة، ولكي لا تتكرر لا حروب الداخل، ولا الحروب من أجل الخارج؟
السؤال معنيّةٌ به كل القوى السياسية اللبنانية، وكلها أو معظمها ذات سوسيولوجيا طائفية، كما يعني كل الكُتّاب والمثقفين. وإذا كنا نتحدّث في هذا السياق عن حزب الله، فلأنه اليوم “بطل الساحة” ولأن خلفيته الثقافية والفكرية والفقهية تثير إشكالات لابد من طرحها حول مدى التلاؤم بين الاعتقاد بولاية الفقيه العامّة، ومشروع الدولة الوطنية الحديثة المرتجاة وليس واقع الدولة اللبنانية القائم، وهو قائم بشكل أساسي على أعراف الطائفية السياسية والمشاركة الطوائفية وفهم خاص للديمقراطية التوافقية، التي تكاد تتحوّل إلى “فيدرالية طوائف”. ورأيي أن الحزب منتظم في هذا المنطق وهذا الواقع مع القوى اللبنانية الأخرى منذ عام 1992، مع إضافة مهمة تميزه عن كل القوى، وتتمثل في البعد السياسي والإيديولوجي الذي يَعْبُر الطوائف عبر دلالات ما تحمله المقاومة من تداعيات القومية العربية والإسلامية وفلسطين.
وبالعودة إلى الخلفية الفقهية لمشروع الدولة والتي يشير إليها السيد حسن نصرالله، تلك الخلفية التي تتمثل في نظرية ولاية الفقيه العامة، فماذا تقول هذه النظرية؟
يقول الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله: “… يحتاج المسلم المكلَّف في القسم الأول (أي قسم العبادات والمعاملات) إلى مرجع تقليد لمعرفة الأحكام الشرعية وضوابطها، وفي القسم الثاني (القسم العام المرتبط بالأمة ومصالحها وحربها وسِلمها وتوجهاتها العامّة) إلى قائد هو الولي الفقيه لتحديد السياسات العامة في حياة الأمة ودور المكلفين العملي في تنفيذ أحكام الشرع المقدّس والسهر على تطبيقها في حياة الأمة. وقد تجتمع المرجعية والولاية في شخص واحد(..) كما حصل بالنسبة للإمام الخميني مع انتصار الثورة، وللإمام الخامنئي بعد اختياره للولاية”[4] .
والحزب يلتزم –منذ تأسيسه- بمبادئ ثلاثة:
أولا: “الإسلام هو المنهج الكامل الشامل الصالح لحياةٍ أفضل”. وفي مكان آخر يدعو الحزب إلى إقامة الدولة الإسلامية في “الرؤية الفكرية”، وإذا كانت الظروف المحلية لا تسمح الآن بهذا الخيار، “فالحزب معذور في أنه بلّغ وأعلن موقفه، وعلى الناس أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في نظام الحكم الذي يختارونه”[5] .
ثانيا: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي كخطر على الحاضر والمستقبل(…)
ثالثا: “القيادة الشرعية للولي الفقيه كخليفة للنبي والأئمة، وهو الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة وأمره ونهيه نافذان”[6]. وفي سياق شرحه لـ”ارتباط الحزب بالولي الفقيه” يقول: “لا علاقة لموطن الولي الفقيه بسلطته، كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته. فقد يكون عراقياً أو إيرانياً أو لبنانياً أو كويتياً أو غير ذلك (…) فالإمام الخميني كولي على المسلمين، كان يدير الدولة الإسلامية في إيران كمرشد وقائد وموجِّه ومشرف على النظام الإسلامي هناك، وكان يحدد التكليف السياسي لعامّة المسلمين في البلدان المختلفة في معاداة الاستكبار، والحرص على استقلال الموارد الذاتية لبلدان المسلمين عن سطوة المستكبرين، والعمل من أجل الوحدة… ومواجهة الغُدة السرطانية المزروعة عنوة في فلسطين..الخ…”. هذا “والارتباط بالولاية تكليف والتزام يشمل جميع المكلَّفين، حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر في التقليد، لأن الإمرة في المسيرة الإسلامية العامة للولي الفقيه المتصدِّي”[7] .
أما الولاية فهي “مُطلَقة وعامة”، وهي تشمل كل صلاحيات النبي والأئمة المعصومين من دون نقصان أو استثناء. يقول الإمام الخميني: “فتوهُّم أن صلاحيات النبي في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين، وصلاحيات أمير المؤمنين أكثر من صلاحيات الفقيه، هو توهم خاطئ وباطل. نعم إن فضائل الرسول بالطبع هي أكثر من فضائل جميع البشر، لكن كثرة الفضائل المعنوية لا تزيد في صلاحيات الحكم. فالصلاحيات نفسها التي كانت للرسول والأئمة في تعبئة الجيوش وتعيين الولاة والمحافظين، واستلام الضرائب وصرفها في مصالح المسلمين، قد أعطاها الله تعالى للحكومة المفترضة هذه الأيام. غاية الأمر لم يعين شخصاً بالخصوص وإنما أعطاه لعنوان العالم العادل”[8]. أي للولي الفقيه، ومن الملاحظ أن الشيخ نعيم قاسم يستعيد النص نفسه.
هذا “الحجم من الصلاحيات المنوطة بالولي الفقيه” يترجم عملياً حسب رأي الشيخ قاسم برسم السياسات العامة للأمة الإسلامية جمعاء، أي بتعبير قديم “دار الإسلام” وبتعبير معاصر “العالم الإسلامي”، أما “التفاصيل” فمتروكة للأحزاب الإسلامية القُطرية المرتبطة بالولي الفقيه. ولما كان حزب الله لبنانياً بعناصره وكوادره وتياراته وأنصاره، فإن “التفاصيل” اللبنانية متروكة له. يعالج الشيخ نعيم قاسم هذا الإشكال في العلاقة بين المستويين بطرح مسألتين، لتحديد حقل تلك التفاصيل وطبيعتها.
“الأولى: تطبيق الأحكام الشرعية وعدم القيام بما يخالفها.
الثانية: الظروف الموضوعية والخصوصيات لكل جماعة أو بلد تؤثر على دائرة التكليف وساحة الاهتمام”.
إذن متروك للحزب المحلي، وفي حالنا لحزب الله اللبناني “الإدارة والمتابعة ومواكبة التفاصيل والجزئيات، والقيام بالإجراءات المناسبة والعمل السياسي اليومي، والحركة الاجتماعية، بل والجهاد ضد المحتل الإسرائيلي بتفاصيله. وتكون هذه الأمور “من مسؤولية القيادة المنتخبة من كوادر الحزب بحسب النظام الداخلي، والتي تتمثل بالشورى التي يرأسها الأمين العام، والتي تحصل على شرعيتها من الفقيه، فيكون لها من الصلاحيات الواسعة والتفويض ما يساعدها على القيام بمهامها ضمن هامش ذاتي وخاص ينسجم مع تقدير الشورى للأداء التنفيذي النافع والمفيد لساحة عملها..”[9].
المشكلة تبقى عملياً كامنةً في طبيعة العلاقة وصيغة آليتها ما بين الجزئي والعام، ما بين التفصيلي والكلي. فإذا كانت الكليات، والسياسات العامّة أي ما اصطلح على تسميته في العصر الحديث بالاستراتيجيا، هي من صلاحيات الولي الفقيه، الذي هو مرشد وقائد الدولة والأمة الإيرانية بحكم المنشأ التاريخي لولاية الفقيه وموجِبات الدستور الإيراني، فما هو حجم “الهامش” المتروك للحزب اللبناني، عملياً، أي للمواطن اللبناني المؤمن بولاية الفقيه وإرشاداته وسياساته العامّة الملزِمة بحكم التكليف الشرعي؟
يجيب الشيخ نعيم قاسم على هذا الإشكال بالصيغة القطعية التالية: “المواءمة بين إسلامية المنهج ولبنانية المواطَنة”، ولكن لما كان المنهج يقول بتأسيس السياسة على المعتقد الديني، وبما أن المنهج ديني وسياسي معاً، يظل السؤال قائماً: من يرسم سياسة المنهج؟ ومن يرسم سياسة المواطنة؟
كانت “المواءمة” مستحيلة في تجربة الأحزاب الشيوعية بين مركز الأممية في موسكو من جهة، والخصوصيات الوطنية لدى الأحزاب الشيوعية في دولها الوطنية. ولقد كلّفها هذا كثيراً عندما حاولت أن تستقل عن وصاية المركز وإرشاداته. وأحسب أن الحزب ومن زاوية عقدية دينية يمر بإشكال مماثل. ومن تجارب التاريخ القريب التي تذكرها أدبيات حزب الله صراحةً موضوع المشاركة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في عام 1992. هذا الموضوع استلزم كما يقول الشيخ نعيم قاسم نقاشاً داخلياً موسعاً. فكُلفت لجنة من 12 عضواً لنقاش هذا الأمر. وبعد نقاش جملة من الفرضيات، ارتأت أكثرية اللجنة من 10 12- أن المشاركة في الانتخابات تحقق جملةً من المصالح التي ترجِّح الإيجابيات على السلبيات. لكن مشروعية الاقتراح أو شرعيته لم تأخذ حيز الاقتناع الكامل والتنفيذ إلاّ بعد “أن استُفتي الولي الفقيه”.
يقول الشيخ نعيم قاسم بعد سرده الوقائع: “ثم جرى استفتاء سماحة الولي الفقيه الإمام الخامنئي (حفظه الله) حول المشروعية في الانتخابات النيابية بعد تقديم اقتراح اللجنة، فأجاز وأيَّد. عندها حُسمت المشاركة في الانتخابات النيابية، ودخل المشروع في برنامج وآلية الحزب…”[10].
الحقيقة أن إشكالية علاقة حزب الله بولاية الفقيه التي مركزها طهران اليوم هي إشكالية معقدة، وتطرح علينا مستويين من الإشكالات:
أولاً: صعوبة الانتظام في دولة/وطن تنحو بحكم حركية الاجتماع السياسي المدني وضرورات الإصلاح وبحكم تركيبها التعددي والطوائفي لأن تتحوّل إلى دولة مدنية، أي دولة مواطنين تنفصل فيها السلطة المدنية عن السلطة الدينية، وتتساوى فيها المواطَنة في الحقوق المدنية والشخصية والسياسية، هذا إذا شئنا أن تكون لنا دولة في لبنان، دولة مواطنين لا دولة طوائف.
ثانياً: أن الإيمان بولاية الفقيه المطلقة (وأيّاً كان موطن هذه الولاية مستقبلاً ولو حتى كان افتراضاً لبنان) يشكل قطيعة، أو على الأقل افتراقاً، مع منهج الإصلاحية الشيعية الذي شهده التاريخ الإسلامي/الشيعي. ورأيي أن هذه الإصلاحية التي بدأت مع النهضة الإسلامية الحديثة، حملت المخرج النظري والفقهي للتكيف مع الدولة المدنية الحديثة، والاندماج في اجتماعها الوطني، أي لـ”المواءمة” بين التديُّن في المجتمع والعيش كمواطنة في دولة مدنية.
حزب الله والطائفية السياسية
يعلن حزب الله في أدبياته، أنه حزب عقدي وغير طائفي كما أشرنا، وعلى رغم أن عقديته تنطلق من عقيدة الشيعة الإمامية، أي من عقيدة فرقة من فرق الإسلام، وعلى وجه أخص من الالتزام بولاية الفقيه العامة أو المطلقة، فإنه يراهن في خطابه الإيديولوجي على محور المقاومة الإسلامية، كمحور جاذب لقوى غير شيعية، عربية قومية ويسارية وإسلامية عموماً، وعلى حرصٍ على أداء دور وطني لبناني من خلال “الحرص على الوحدة الداخلية”[11] .
لكنَّ المتابع لبرامج حزب الله ومناهج تثقيفه للأجيال الشيعية الجديدة في حوزاته ومدارسه، يلاحظ موجةً بل تياراً مذهبياً حدياً في التعبئة حول مذهبية أحادية في تكوين الذاكرة التاريخية الجمعية وشحنها. بل إن “أسْطرة” الماضي، لجعله مرجعية للحاضر وبناء المستقبل، يحمل إلى وعي الحاضر كل شحنات الاختلاف والصراع من ذاكرة الماضي. حيث تستحضر الذاكرة من الماضي لتحيي هوية مذهبية عقيدية في الحاضر.
فما هو الحد الفاصل بين عقيدة مذهبية تستحضر من نصوص فرقة دينية، وبين طائفية سياسية هي طريق العمل السياسي اللبناني المؤدي إلى السلطة في النظام السياسي اللبناني؟ ونعني بالسلطة أيّ موقع من مواقع هذه الأخيرة، سواء في مواقع السلطة الأهلية في المجتمع، أو في مواقع السلطة التشريعية أو التنفيذية في الدولة.
في الواقع العملي، أي في الممارسة السياسية العملية، يزول الحد بين العقيدة المذهبية والسياسة العملية. فعندما تكون العقيدة هي عقيدة فرقة دينية، وعندما تكون السياسة نابعة منها أو مؤسسة عليها، وعندما تكون مواقع السلطة اللبنانية ومؤسساتها قائمة على تمثيل طائفي، وتوزيع مذهبي، ومحاصصة مناطقية/طائفية، وعندما تكون أعراف العمل السياسي اللبناني أعرافاً طائفية، فإن التطابق بين الحزب العقدي والحزب الطائفي يصبح أمراً واقعاً لا محال، بل إن الحزب العقدي يصبح حزباً طائفياً بل مذهبياً بامتياز.
ومنذ خوضه معارك الانتخابات البرلمانية الدورية في لبنان، بدءاً من عام 1992 وإلى مشاركته في حكومة الرئيس السنيورة القائمة اليوم، وإلى تحالفاته الانتخابية أو تفاهماته قبل يوليو (تموز) 2006 وبعده، كانت آليات التحالف بين الأكثريات الطائفية، في لبنان -وباعتباره أكثرية طائفية شيعية- هي آليات عمله السياسي وخططه، وهي آليات أي حزب طائفي أكثري في لبنان: من التحالف مع أكثرية سُنية في الانتخابات، إلى التحالف مع أكثرية مسيحية ضـد حكومة السنيورة.
على أن حزب الله دخل معترك الحياة السياسية اللبنانية من بابين: من باب الطائفية السياسية التي لابد منها لممارسة السياسة في لبنان، ومن باب العقدية الدينية التي هي في أساس نظرية الحزب، ومنطلق مبادئه وثقافته من أجل مشروعه في المقاومة الإسلامية المتجاوزة لحدود لبنان.
لكن اللافت في برنامج الحزب الذي خاض على أساسه انتخابات 1992، هو إيراد مطلبين: إلغاء الطائفية السياسية، واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. وحتى اليوم لم نقرأ في أدبيات الحزب تعديلاً لهذين المطلبين. فماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية بالنسبة لحزب الله، (الحزب الديني)، ثم اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة؟
في الممارسة، لنقل إن الطائفية السياسية أداة عمل سياسي “مفروضة” بحكم طبيعة النظام السياسي، وإن الحزب يمارسها “اضطرارياً”، وهو إذ يطالب بإلغائها نتساءل: ما هو البديل؟
العلمانيون وذوو الثقافة السياسية المدنية يقولون إن العلمانية، وبالتحديد فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية، أو توسيع الدائرة المدنية في حقوق المواطنة بعيداً عن دائرة الانتساب السياسي للطائفة، هو البديل. فماذا يقول حزب الله عندما يطالب بإلغاء الطائفية السياسية، وهو الحزب الذي يعتبر نفسه عقدياً دينياً؟ هل سيقول: “الإسلام هو البديل” على مذهب أهل البيت، ووفقاً لنظرية ولاية الفقيه، وكما هو الحال في التجربة الإيرانية، ليبقى منسجماً مع عقيدته و”رؤيته الفكرية”؟.
طبعاً يستدرك حزب الله ليؤكد أنه لا شيء يتم بالفرض أو القسر، وأن أسلوب الدعوة والتبليغ بالحسنى هو الأسلوب المتبع والأنجع. ومع التسليم بصدقية النوايا وجميل الخطاب والقول، فإن التاريخ، كوقائع ومسارات ومآلات كان دائماً -ولا يزال– تاريخ الصراع على السلطة، وإن عوامل حراكه هي بشكل أساسي التحولات والطفرات الديموغرافية والتغيرات الاقتصادية في الإنتاج وتوزيع الثروة، والقفزات العلمية والتكنولوجية، ومدى القدرة لدى قوى اجتماعية ناشئة، تحمل دعوة، أي إيديولوجيا، تستقوي بها في مسار الصراع والتغلب، أو المناجزة والمطالبة بين عصبية دولة قديمة أو دولة حادثة، أو بين مركز وأطراف… الخ.
مشاهد ومسارات مرتقبة
لا يستقيم التحليل التاريخي من غير الأخذ بالاعتبار معطيات الصراع الدولي والإقليمي، وفي محيط لبنان، ومآلات ذاك الصراع. ومن خلال رصدنا لتحولات طبيعة السلطة في التجربة التاريخية اللبنانية، ومنذ عهد الإمارة أو الإمارات في الدولة السلطانية العثمانية، إلى عهد متصرِّفية جبل لبنان، إلى نشأة دولة لبنان الكبير، إلى الجمهورية إلى الاستقلال وفقاً للميثاق الوطني (1943)، إلى تعديلٍ في موازين العلاقة بين أطراف الميثاق (وثيقة الطائف 1989)، يمكن أن نتوقع المسارات التالية:
أولاً: أن يرتضي حزب الله بالتعايش مع الطائفيات السياسية اللبنانية، فيستمرّ بممارسة العمل السياسي اللبناني، وفقاً لآليات التحالفات البرلمانية والحكومية التي تقتضيها شروط نموه كحزبٍ سياسي لبناني، وكما تقتضي أيضاً شروط المشاركة في بناء دولة ووفقاً لمنطق ومضمون الدستور اللبناني وفي إطار محطتيه الرئيسيتين: الميثاق الوطني (1943) ووثيقة الوفاق الوطني (1989).
وفي هذا السياق أو المسار، قد يشكل حزب الله مع حركة أمل ثنائية شيعية متحالفة أو متنافسة. ولكن في هذه الحالة، وإذا ما أراد حزب الله أن يسير في مشروع إصلاحي لـ”الدولة اللبنانية” على قاعدة الميثاق الوطني اللبناني وإصلاحات الطائف، فإن الخلفية الفكرية والفقهية لحركة “أمل” والمتمثلة بشكل أساسي في فكر السيد موسى الصدر وفكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الإصلاحيين، تصبح المرجعية الأصلح لبنانياً، أي أنها الأصلح من زاوية منطلقها اللبناني ومن زاوية استيعابها الخصوصية الكيانية الوطنية اللبنانية، وليس ولاية الفقيه العامة الإيرانية التي تترك لحزب الله “هامش الجزئيات والتفاصيل” في السياسات العامة، التي يرسمها “الولي الفقيه”.
والقول بفكروية موسى الصدر أو محمد مهدي شمس الدين، كمرجعية إصلاحية في الاجتماع السياسي اللبناني، لا يعني حصرية هذا الفكر من جهة في مجال الإصلاح، كما أن الانخراط في الصيغة اللبنانية الميثاقية، لا يعني تجميداً وتأبيداً لطائفيتها. فأفكار الصدر وشمس الدين تفتح على مشروع إصلاحي أوسع، كانت وثيقة الطائف قد لحظت بعض توجهاته واستدخلت في نصها بعض نقاطه.
ثانياً: أن يذهب حزب الله بالدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية إلى آخر مدى، فيكون حينذاك أمام اعتراضين يصدران من موقعين: الطوائف الأخرى، والعلمانيين.
-2 الطوائف الأخرى:
إن إلغاء الطائفية السياسية دون علمنةٍ للدولة والمجتمع، يعني عملياً ومن منظور الطوائف الأخرى سيطرة الأكثرية العددية على الدولة. وقد وُوجه مشروع الشيخ محمد مهدي شمس الدين المعنون: “مشروع الديموقراطية العددية القائمة على مبدأ الشورى” معارضة لبنانية من هذا القبيل، جعلته يتراجع عن موقفه في سنوات عمره الأخيرة، ليقول بالإبقاء على الطائفية السياسية -أي التمثيل الطائفي- مرحلياً، مع إصلاح ضروري لقانون التمثيل، ودون أن يستتبع هذا “التأجيل” منع التداول والنقاش في مسألة إلغائها كهدفٍ بعيد (انظرْ وصاياه).
أما بالنسبة لحزب الله، وأخذاً بالاعتبار عقيدته التي تقول بالدولة الإسلامية ومرجعية “الولي الفقيه” في رسم السياسات، فقد يشكّل مطلب إلغاء الطائفية السياسية في لبنان، بالنسبة للحزب، التمهيد الفعلي لتمكين عنصر العدد في الاجتماع السياسي اللبناني من خلال الديموقراطية العددية، وكبديل عن الديموقراطية التوافقية.
ولكن نرجّح أن تبقى سياسة الحزب، تتراوح بين القول بالديموقراطية التوافقية -على أساس الوفاق الوطني الطائفي وهذا منهجه الآن- وبين الديموقراطية العددية التي يستبطنها مطلب إلغاء الطائفية السياسية على المدى البعيد.
على أن حزب الله يستمر الآن، وبدعم إيراني كبير، ومن خلال الاستمرار باعتقاده بالولاية العامة والمُطلقة للفقيه، القائد والمرشد، وبما يستتبع هذا الاعتقاد من ثقافة وطقوس وتعليم وتأهيل وتقليد، يستمر في تعميق وتمكين نفوذه في مناطق الشيعة الأساسية: الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وبعض أحياء بيروت، وعلى كل المستويات وفي كل الميادين: من الصحة إلى التعليم، إلى مؤسسات الشهداء واليتامى والعجزة، إلى الحوزات الدينية لتخريج طلبة العلم الديني وهم حملة المشروع السياسي الإسلامي/الشيعي في المجتمع اليومي، والقائمون بدور المثقفين العضويين فيه[12].
-2 العلمانيون:
وقد يأتي الاعتراض –على مطلب إلغاء الطائفية السياسية دون علمنة– من موقع العلمانيين والقائلين بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية، لكي لا يستقوي “السياسي” بالديني، ولا يستقوي الديني بالسياسي، وليكون حقل المواطنة في الدولة/الوطن، ممركزاً في الدائرة المدنية لا الدائرة الطائفية. وإذا كان هؤلاء جماعة مهمّشة، ولكن ليسوا قلّة، فلأن “هامشيتهم” يسببها استئثار الطائفيات السياسية بـ”الجماهير” وبـ”الرعية”، وبما أضحى يسمى في القاموس السياسي اللبناني “الشارع” المليوني الذي يحدد بدوره من هو “أكثرية” ومن هو “أقلية” بديلاً عن مؤسسات الديموقراطية. على أن صفة “الهامشية” للقائلين بالفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية لا تعني أن ما يطرحونه غير ذي أهمية وغير ذي وزن ومستقبل. ذلك أنه لا إمكان لدولة حديثة في لبنان إلا بتوسيع الدائرة المدنية في حقل العلاقة بين المواطن والدولة، دون وسيطٍ ديني أو وسيطٍ طائفي يقوم بينهما في الحياة السياسية اليومية.
لذا فإن حزب الله الذي ينتقد الطائفية السياسية من موقع المعتقد الديني، لا يلبث أن يستخدمها بوعي في الممارسة السياسية، ولا يلبث أن يُغرق مجتمعه بها وذلك من خلال برنامج ومخطط اقتصادي وثقافي وسياسي واجتماعي رعوي شيعي (من رعاية ورعية)، ومن خلال تحالفات أو تفاهمات متبادلة ومتغيرة بينه وبين الطائفيات السياسية الأخرى.
إذن بين علمنة يراها الحزب مستحيلةً (لأنها مناقضة لعقديته الدينية كما يرى) وبين إسلامية شيعية، يعترف الحزب بأنها صعبة التحقيق في لبنان ولكنها ممكنة على المدى الطويل، أي على مستوى الدعوة والتبليغ، تبقى الطائفية السياسية هي الحقل الممكن للعمل السياسي اليومي أي للتحالفات والتكتيكات والتفاهمات بين الأكثريات الطائفية ذات الوزن، وخاصةً ذات الوزن في “الشارع”، وذلك وفقاً للظروف والشروط. وكل هذا أمره متغير باستمرار، ولكنه لا يغير في أمر العقيدة شيئاً، حكم الولي الفقيه “الممهد للدولة الإسلامية ولظهور المهدي المنتظر”، كما تقول الأدبيات الملتزمة بهذه العقيدة.
في ظل هذا الإشكال الذي يراوح بين العقيدة والطائفية السياسية اللبنانية كيف خاض حزب الله معركته السياسية بعد حرب يوليو (تموز)؟
من «النصر الإلهي» إلى المعركة السياسية
جواباً على سؤالٍ يكثر طرحه عن أرباح حزب الله من الحرب التي شنتها إسرائيل في يوليو (تموز) 2006، بهدف إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في جنوب لبنان، يمكن التشديد على نقطتين مركزيتين:
أولهما: صمود حزب الله في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية، وصدّ مقاتليه الهجوم الإسرائيلي البري. وكان هذا إنجازاً عسكرياً كبيراً بمقاييس التجربة العربية النسبية في تاريخ الصراع العربي/الإسرائيلي.
وثانيتهما: الخسائر الكبرى الكارثية التي تكبّدها اللبنانيون من جرّاء الانتقام الوحشي الإسرائيلي. على أن أخطر الخسائر يكمن في تفكك الاجتماع السياسي اللبناني، وتفاقم الانقسام السياسي حتى شفير الانهيار.
هذا وكان يمكن للخسائر المادية والبشرية أن تعوَّض من خلال احتمال تحقق شرطين:
أولاً: من خلال صمود اللبنانيين واجتماعهم ووحدتهم في مواجهة آثار العدوان، وذلك عبر احتضان النازحين من الجنوب ومن ضاحية بيروت الجنوبية، أي من أمكنة التعرّض لأبشع انتقام تدميري وأشد المعارك عنفاً. ولنتذكر أن هذا الشرط قد تحقق في حينه في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء، وبغض النظر عن الاختلافات السياسية بين جبهتي ما يسمى “معارضة” و”موالاة”، أي بين قوى 14 مارس (آذار) و8 (مارس) آذار.
ولنتذكر أيضاً، وبالمناسبة، أن هذا الأمر هو الذي دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو أحد أبرز أقطاب المعارضة، والمفوّض من قبل حزب الله ليكون ناطقاً باسمه حيال الحكومة اللبنانية وحيال الهيئات الدبلوماسية الدولية، أن يصرّح في موقفين لافتين ومعبرين عن احتمال توحد وطني: إرسال شكر للزعيم الدرزي ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط على حُسن استقبال أهالي منطقته للنازحين الجنوبيين، ثم توجيه تحية لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة وحكومته على صحة أدائهما السياسي والدبلوماسي في الأوساط والمحافل الدولية، وهي “صحةٌ” عبّر عنها بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السنيورة، حيث أعلن الرئيس بري موافقته الكاملة على ما أدلى به رئيس الحكومة، بل ذهب إلى وصف هذه الحكومة بأنها “حكومة المقاومة السياسية”.
شكّلت هذه المحطّات الوفاقية -خلال الحرب- نقاط إشعاع واعدة أمام اللبنانيين لإمكانية توافقٍ حول مشروع مواجهة وطنية مشترك، في طليعته مواجهة نتائج الحرب العمرانية والاقتصادية بسياسة واحدة وبرنامج واحد. وكانت وعود مؤتمر إعادة إعمار لبنان- باريس 3- تنتظر دفعاً لبنانياً لها باتجاه التوافق على برنامج مواجهة وإنماء.
ثانياً: أما الشرط الثاني الذي لم يتحقق، والذي نسف وعطّل معنى ودلالات الشرط الأول الذي تحقّق مؤقتاً، فهو وعي ماذا تعني “دولة”، وما الفرق بينها وبين “حكومة” و”سلطة”، وما الفرق بين “معارضة” و”خروج”، وبين عمل سياسي وأساليب استيلاء وتغلّب.
من يعرف تاريخ لبنان والمنطقة العربية، ولاسيما المشرقية فيها، ومن يعرف إتنولوجية مجتمعاتها، أي تراكيبها الإثنية والطائفية والقبلية والعشائرية، وماذا يعني ذلك على صعيد أنماط العقلية والذهنية والثقافة، يعرف أيضاً أن هذه المجتمعات تختزن كل أنواع الممانعات، وفي طليعتها ممانعة الدولة، باعتبار هذه الأخيرة مجرّد أهل سلطة أو جماعة حكم. إنها كما قلنا مراراً مجتمعات “اللادولة”.
على كل حال، ومن باب النظرية والمبدأ في نظام ديمقراطي محكوم بدستور وميثاق وطني، كان هذا الشرط يقضي إعطاء الأولوية في الخيارات بين السياسات والولاءات ومراتب المشاركة في السلطات لما يسمى “المصلحة العليا” للدولة، أو لما يسمى بتعبير آخر “المصلحة الوطنية”، والتي تتأسس على إجماعات مشتركة تُبعد تحوّل الخلافات السياسية والإيديولوجية إلى انقسامات عمودية تهدد المجتمع الأهلي والمدني، كما تهدد العقد الاجتماعي الوطني- الميثاق الذي تقوم عليه الدولة في حالة لبنان- بالانفراط وبالتالي بالتقسيم أو بحربٍ أهلية أو بكليهما.
ومع أن العارف بإتنولوجيا الأقوام والطوائف في المشرق العربي، يميل إلى ترجيح غلبة الولاءات الأهلية والفرعية الوسيطة في الخيارات لدى النخب الطائفية وأحزابها، إلا أن الرهان على “حكمة السياسة” التي تقضي بدورها تغليب منطق التسويات والمصالحات بفعل منطق المصالح نفسها، كان يقدّم بعض الأمل في ألا تلجأ الأطراف اللبنانية إلى تدمير مصالحها ومصالح طوائفها و”جماهيرها” من خلال تدمير ما تبقى من مؤسسة الدولة. إلا أن الانبهار بألق الإيديولوجيا المُطلقة أيا كانت، كان يُعمي ويدفع بالسياسة والعمل السياسي إلى ركوب شتى المخاطر والانجرار نحو شتى المزالق، واستخدام كل الوسائل: الدين، والطائفة، والشرف، والمقدّس، بل الأشرف والأقدس، والإلهي، والأسطوري والغيبي، والشياطين والملائكة. فكل شيء دنيوي وسماوي تسمح به الإيديولوجيا والعقيدة، مسموح استخدامه في السياسة.
“النصر الإلهي” على العدو الإسرائيلي، أضحى يقضي إذن نصراً لصاحبه في السياسة اللبنانية، أي في الصراع على السلطة وحجم المشاركة فيها. وبين عشية وضحاها، أضحت حكومة السنيورة، حكومة عميلة للأميركيين، في حين كانت خلال الحرب “حكومة مقاومة سياسية”، ولم تعد المقاومة دفاعاً عن لبنان من أجل تحرير الأسرى وتحرير مزارع شبعا فحسب، بل مقاومة وممانعة للمشروع الأميركي في الشرق الأوسط برمته، والحقيقة أن إدارة بوش أرادتها كذلك، وكذلك “ولاية الأمر” في إيران.
خرج وزراء “أمل” و”حزب الله” من الحكومة، وتم الحرص في الإعلام على وصف خروجهم على أنه خروج وزراء الشيعة، أي خروج الطائفة الشيعية بكاملها من الحكم -كما أشرنا- الأمر الذي يوظف في دعوة مناقضة الميثاق والدستور: أي تعطيل المشاركة. وهو الأمر الذي يبرر إسقاط الحكومة بأي وسيلة في الشارع، عبر التظاهر والاعتصام الدائم، والعصيان الذي يقف عند تخوم الحرب الأهلية، فيذكر بها عبر التلويح ببعض مقدّماتها ونذرها في عدة مناسبات، والتي تتمثل بنماذج من التجاوزات الدموية، وتقديم بعض الأضاحي البشرية.
لكن الأدهى خطراً في معركة إسقاط الحكومة، كان اتخاذها الطابع المذهبي: سُنية سياسية تقود معركة الدفاع عن الحكومة، مقابل شيعية سياسية تقود معركة إسقاطها، أما الموقف المسيحي فانقسم –على حد قول بعض الإعلاميين الظرفاء– إلى مسيحي شيعي ومسيحي سُني!
هذا على أن حزب الله عاد فأدرك بعد تجربة الشوارع المنفلتة أن لعبة السياسة من خلال قواعد اللعبة الطائفية والمذهبية، لعبة خطيرة لا يمكن ضبطها والتحكّم بنتائجها مهما بلغت قدرة الحزب على الضبط والتنظيم والاحتواء. بل إنها تفقد الحزب رصيده التاريخي ورأسماله الرمزي كمقاومة عربية وإسلامية.
ومع ذلك فإن مرحلة جديدة واجهها ويواجهها الحزب بعد عام على حرب يوليو (تموز) عنوانها الرئيسي: توطيد سلطته الفعلية في الدولة. ولكن، بعد تجربة عام من السجالات والخلافات السياسية واستخدام شتى المعطيات اللبنانية في السياسة، يصبح السؤال: كيف؟ وبأية نظرية؟ ولأية دولة؟ وما الموقف من عدد من المسائل المصيرية التي ستكون لها تداعيات خطيرة: الطائفية السياسية؟ اتفاقية الطائف واستتباعاتها؟ ناهيك عن دور سلاحه المرتبط دائماً بهدف استراتيجي لا يقتصر على الدفاع عن لبنان وتحرير فلسطين، بل يتجاوز ذلك لوجوب التصدّي للمشروع الأميركي الصهيوني على امتداد “الأمة” والعالم الإسلامي برمته. فهل يمكن لبنية لبنان المتسمة أصلاً بالتعدد (لكي لا نقول بالانقسام والتجزؤ) أن تتحمّل ذاك العبء الاستراتيجي الكبير؟
إطلالة على المستقبل
في ظل الانقسام الحادّ القائم بين القائلين بأولوية “المقاومة” مهما كان ثمنها، وأنَّى كان توظيفها السياسي، وبين القائلين بأولوية الديموقراطية مهما كان وقعها وتداعياتها وأهدافها في مجتمعات منقسمة على نفسها، فإن الزمن الآتي، وربما المعيش الآن، هو زمن انعدام الحياة السياسية التي شرط وجودها وجود مواطن يعي معنى وجوده في دولة قانون، دولة حق وواجب. فلمّا انعدم وجود المواطن وأضحى البديل –كما كان الحال قبل وجود الدولة– هو الطائفة أو القبيلة وهواجسها وتهويماتها ومخاوفها لدى الشيعة كما لدى السُّنة، كما لدى المسيحيين، أمسى “الإسلاميون التكفيريون” هم البديل. أي بمعنى آخر أمسى الرفض المطلق لكل شيء، للدولة الوطنية، كما للمجتمع السياسي والمدني، كما للمواطن الفرد، كما للإنسان، هو البديل، أي هو العدم.
في لبنان، حيث اتخذ الانقسام ولأسباب تاريخية وإنثربولوجية وسياسية راهنة، طابع الانقسام السُّني/الشيعي، أي طابع مخزون ما نسميه في تاريخنا العربي والإسلامي “ذاكرة الفتنة”، تتموضع الجدلية التاريخية الراهنة في العلاقة المتبادلة بين قوتين أساسيتين معاصرتين: شيعية سياسية تتمثّل في قوة حزب الله، وسُنية سياسية تتمثّل في قوة تيار المستقبل. فإذا افترضنا أن القوتين هما قوتان لبنانيتان مسؤولتان عن مصير الدولة/الوطن، أي عن مصير مواطنين، فإن مسؤوليتهما تكون مسؤولية تاريخية ومصيرية ليس في المحافظة على الدولة/الوطن من ناحية الشكل فحسب، بل على فسح المجال لإصلاح هياكلها وتطوير قوانينها. بل قبل هذا وذاك تقع المسؤولية الكبرى في التصدّي لإرهاب الأصولية والسلفية الإسلامية التكفيرية التي تنمو على هوامشهما، ومن خلال تشققات انقسامهما في جذوع طائفتيهما، حيث نلاحظ تعبيرات فظيعة من التعصب والتنابذ بين العوام والدهماء في كلا الطائفتين.
وما ظاهرة “فتح الإسلام” التي يسهل على بعض الإعلام تسميتها “عصابة شاكر العبسي” من قبيل التبسيط، إلا التعبير عن أزمة بنيوية في الاجتماع والثقافة والسياسة في مجتمعاتنا العربية أوَّلاً، وفي مجتمعنا اللبناني ثانياً.
لذلك فإنه، وبمعزل عن صراع المحاور الإقليمية فإن الأولوية التي تتحكّم في سياسات الطوائف اللبنانية وكتلها، أو على الأقل تخترقها وتؤثر فيها، أضحى أمرها لا يحتمل تأجيلاً أو مناورات أو سجالات ومناكفات.
على أنه لا يبدو أن الفرقاء اللبنانيين “الفاعلين”، مستعدون لأية مراجعة، ولذلك أيضاً فنحن لا نتوقع حلاًّ للمسألة اللبنانية بأبعادها الإقليمية والدولية المعقدة في مداها البعيد والطويل. بل إن استثمار الوقت القصير في الشد والجذب، والتصعيد المتبادل في الخطاب السياسي الإعلامي، هو ما يُمارس حين كتابة هذه السطور.
وتبقى الصورة حتى اليوم مهتزّة ومتجاذبة بين لبنانية جمهور حزب الله من جهة، وبين إيرانية إيديولوجيته وسلاحه من جهة أخرى!
[1] مؤرخ لبناني، له عدة مؤلفات، صدر له مؤخراً كتاب: بين فقه الإصلاح الشيعي وولاية الفقيه: الدولة والمواطن، بيروت، دار النهار، 2007.
[2] السفير، 12/9/1998.
[3] راجع الحوار الذي أجرته السفير مع أمين عام حزب الله، 5/9/2006.
[4] راجع كتاب الشيخ نعيم قاسم: “حزب الله، المنهج، التجربة، المستقبل”، 2002، ص70-69.
[5] المرجع السابق، ص23 وص39.
[6] المرجع السابق، ص23.
[7] المرجع السابق، ص75.
[8] الخميني: الحكومة الإسلامية.
[9] الشيخ نعيم قاسم، مرجع سابق، ص76.
[10] المرجع السابق، ص273.
[11] المرجع السابق، ص42.
[12] من المفيد مراجعة كتاب وضاح شرارة في الموضوع: دولة حزب الله لبنان مجتمعا إسلاميا، 1996. وإذا كانت الأرقام والمعطيات والشهادات التي يوردها شرارة على أهمية دلالاتها تعود إلى ما قبل 1996، فإنه خلال السنوات العشر اللاحقة، ازداد عدد الحوزات والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية، كما تضاعف عدد المعمَمين.