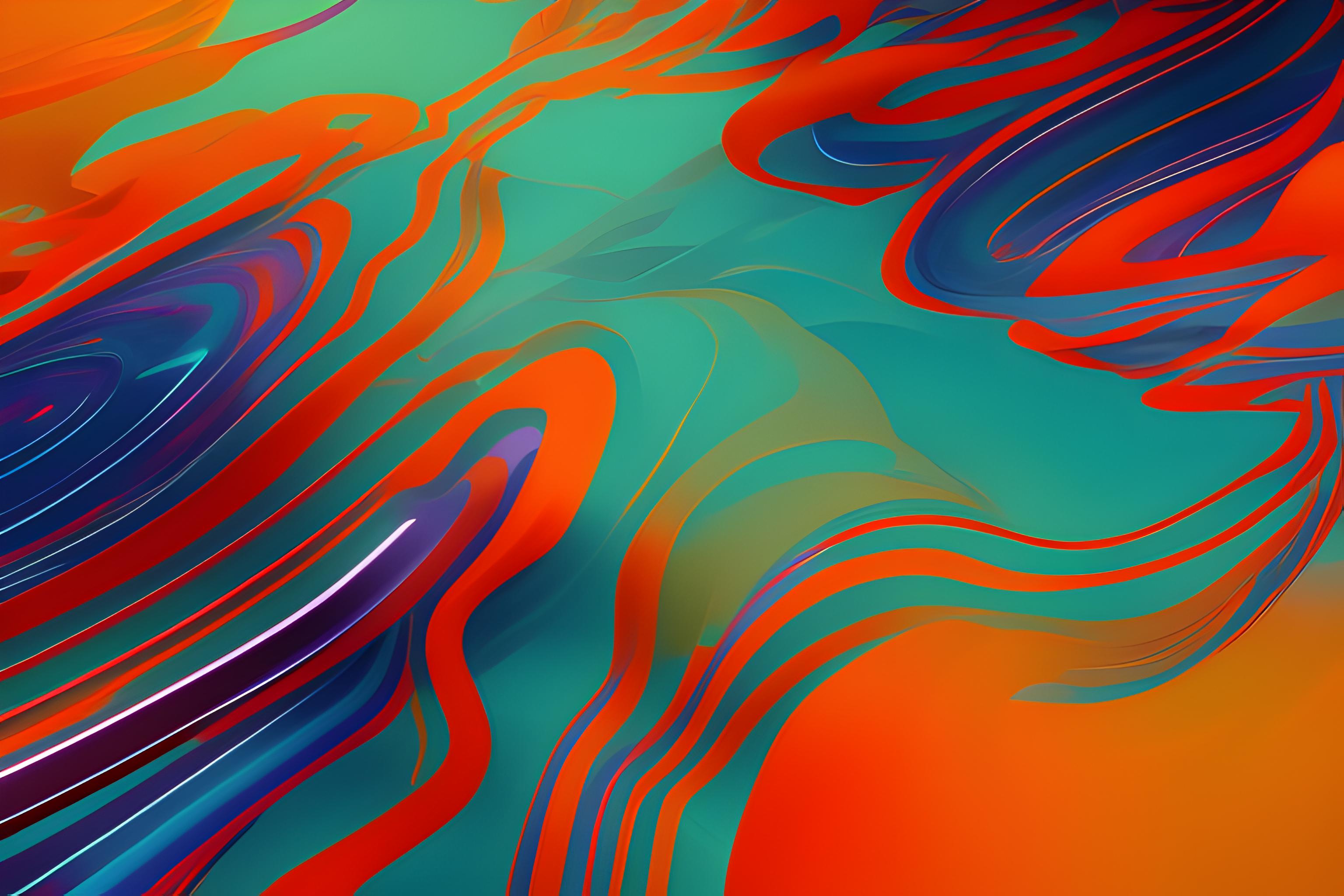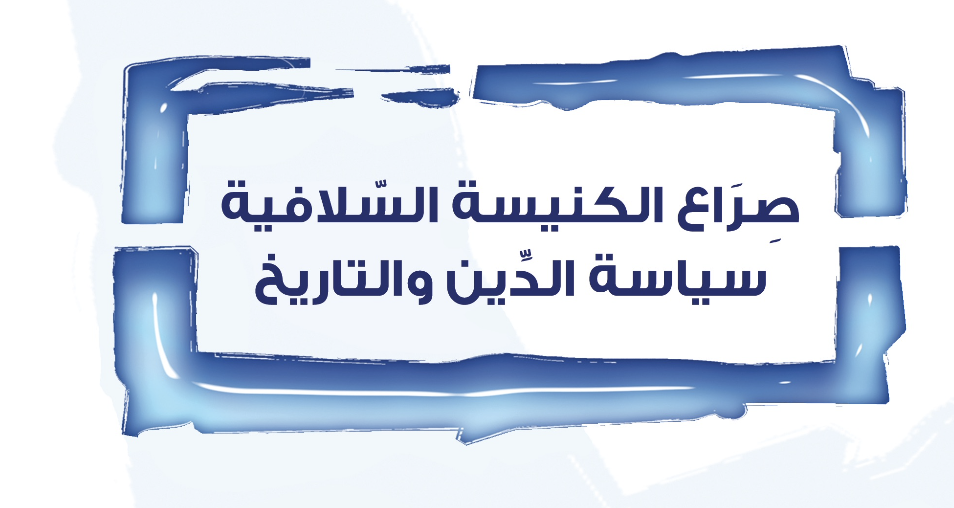قد يخلد جثمان رامسفيلد إلى سكون في مرقده الأخير، إلا أن من المرجّح ألا يكون التوفيق حليفاً لسمعته.
آدام جارفينكل*
مات دونالد رامسفيلد في يوم 29 يونيو (حزيران) 2021 عن عمر يناهز الثامنة والثمانين في مدينة تاوس بولاية نيو مكسيكو. وقد أثار موته عاصفة من التعليقات ولا غَرْوَ في ذلك، خصوصاً في تلك الحقبة التي شهدت وتيرة متسارعة من أوجه الضعف الذي اعترى الذاكرة التاريخية للأمة الأمريكية فضلاً عن التناحر الحزبي الشرس والصراع السياسي المحموم والتوجه المزاجي العام الذي يحفل بالمشاهد “السيريالية” والتحليق بالخيال والقفز إلى ما فوق الواقع. لقد تفاوتت التعليقات بين انتقاد يشوبه الحذر على الوسائط التي ترتادها النخبة، ولغو وهراء وترهات على الوسائط التي درج مرتادوها على التسرع في إبداء الرأي وإلقاء الكلام على عواهنه؛ وبين هذا وذاك تتواتر تباعاً شتى ضروب التحليلات والتعليقات التي تنحو كل منحى وتخبط في كل اتجاه على وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى. ولا غرو –أيضاً– أن تتمحور أغلب التعليقات حول دور رامسفيلد عندما تقلد منصب وزير الدفاع في إدارة جورج دبليو (والكر) بوش، ولا سيما دوره في حرب العراق وتداعياتها وعقابيلها.
لا غرابة في ذلك، وإن كان حريّاً به أن يفضي إلى تشويش ذاكرة القراء وتغبيش رؤيتهم ما لم يتم استجلاؤه وفق منظور أوسع ينفض عنه ما علق به من غبار ويزيل عنه عثار ما اعتراه من شوائب. فقد ارتكبت إدارة بوش -الذي شغل منصب الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية- ثلاثة أخطاء فادحة بخصوص الشرق الأوسط “الكبير”، وهي أخطاء ما انفكّت أصداؤها تتردد مجلجلةً في الأجواء حتى يوم الناس هذا، وليس خطأً واحداً فقط. يمثل دور رامسفيلد في الخطأين الآخرين جزءاً مما خلّفه وراءه من إرث مثقل.
أما الخطأ الفادح الثاني، فقد تمثل في تحويل المهمة في أفغانستان من تغيير لنظام الحكم بالبلاد على سبيل الحماية والدفاع والعمليات الاستباقية والإجراءات الوقائية الجزائية -باستخدام تشكيلات عسكرية أمريكية صغيرة الحجم ورشيقة الحركة- إلى غزو طويل الأمد وبعيد المدى وبطموح عالي السقف، باستخدام قوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بغية إعادة تشكيل الدولة الأفغانية والمجتمع الأفغاني على حدٍّ سواء. ففي مهمة التحويل المشار إليها أعلاه، يصبح تقديم خلاصة موجزة لدور رامسفيلد ضرباً من المحال. ومع هذا هنالك شيء واحد كان واضحاً ويظل واضحاً على الدوام: ذلك أن رامسفيلد كثيراً ما كان يُحْشَر عن طريق الخطأ ضمن زمرة “المحافظين الجدد (neoconservative)” أو يُدْرَج تحت معسكرهم أو في مدرستهم؛ وهو خطأ وجد طريقه إلى الظهور بإحدى طريقتين أو بطبيعة الحال بهما الاثنتين معاً، وهما: عدم الإلمام بأصول “مذهب المحافظين الجدد” وعدم الإحاطة بكُنْهِ ذلك المذهب، مما قاد إلى تعريفه بطريقة تنطوي على كثير من التوسع، مع تفسيره بصورة فضفاضة إلى حد بعيد؛ ومن الناحية الأخرى، عدم معرفة الكثير عن دونالد رامسفيلد. ومن عَجَبٍ أن ثمة قاعدة راسخة في جميع مناحي الحياة حَرِيٌّ بها أن تستلفت انتباهنا وتسترعي اهتمامنا وتستدعي إقرارنا بها في هذا المقام، ومفادها أن الجهل ينزع إلى استدرار العاطفة والجمع بين عناصرها وتصويبها تجاه المسائل التي تستحوذ على الاهتمام في حين أن العلم يميل إلى تحليلها واستثارة كوامنها لأجل التمييز بينها (أي إن الجهل يستدر العاطفة والعلم يستثير مكنونات الفكر وبواعث الاستدلال العقلي).
كان رامسفيلد من صقور الوطنية والقومية/ الواقعية (nationalist/realist) ولم يكن بأي حال من “حمائم” الديمقراطية أو من دعاة التوجه العلماني. فهو لم يكن من مناصري “بناء الأمة (nation-building)”، لدرجة إدراكه -بحكم تلقِّيه تعليمه في “برنستون”- أن المصطلح في حد ذاته ينطوي على مغالطة في التسمية وخطأ في المسمى: ذلك أن الناس إنما كانوا يقصدون “بناء الدولة (state-building)”، وليس “بناء الأمة (nation-building)”، وأن المشكلة تكمن في أنهم لم يقفوا على التمايز الدقيق في المعنى المعجمي للكلمتين في اللغة الإنجليزية. وأياً كانت الأوصاف التي أطلقوها في هذا الصدد، كان رامسفيلد مرتاباً أيما ارتياب كما أنه كان يشاطر وزير الخارجية “كولن باول” الرأي نفسه في هذا الخصوص على الرغم من أن ذلك قد لا يكون معلوماً لديكم من جراء السرد السطحي الضحل للأحداث التي جرت وقتها، وعلى الرغم من أن الرجلين كانا على طرفي نقيض في العديد من القضايا الجدلية وحالات السجال الأخرى في الأداء السياسي لإدارة بوش –الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة. لقد كان رامسفيلد ممالئاً للمحافظين الجدد في إدارة بوش عندما تصبُّ ممالأته لهم في خدمة غرضه المتمثل في التحويل المنشود للعسكرية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب، وهو الغرض المستمد من واقع تفسيره الضيق لدوره كوزير للدفاع –بيد أن ذلك لم يجعل منه أحد المحافظين الجدد الموسومين بالتعصب الشديد والثبات الأعمى على المبدأ- بل لم يجعل منه أحداً من المحافظين الجدد بأي درجة ومن أي نوع.
يصعب في هذه العجالة شرح الأسباب التي أفضت إلى إخفاق رامسفيلد في الحيلولة دون حدوث البطء والتعثر في المهمة الأمريكية في أفغانستان فيما بعد –مع أنه كان العقل المدبر والمصمم لخطة “الأثر الخفيف المميتة (lethal light footprint)” التي أسفرت عن الإطاحة بنظام طالبان. أفضى هذا التعثر الذي ظل ملازماً للغزو الأمريكي لأفغانستان إلى القرار الذي اتخذته إدارة بايدن أخيراً بعد قرابة العشرين عاماً بالعدول السريع عن تلك السياسة والقبول والإقرار بما يبدو انهياراً سريعاً ومريعاً لحكومة “أشرف غني” ووقوعها إما في قبضة نظام طالبان في نسخته الثانية، أو في أتون الحرب الأهلية التي يحتدم أوارها مجدداً، أو ربما فيهما كليهما وفي آنٍ معاً. فإذا كان رامسفيلد قد أيقن في قرارة نفسه أو قال لآخرين غيره في أسابيعه الأخيرة عند الرمق الأخير من حياته في هذا الخصوص ما مفاده “لقد كنت على علم بأن تلك المهمة التي لا لزوم لها ستبوء بالفشل وأن ما حدث كان سيحدث”، لكانت له مبرراته وقتها ولكان محقاً عندما قال ما قال.
أما الخطأ الفادح الثالث، فقد تمثَّل في السماح لحماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) 2006 على الرغم من حقيقة أن الانتخابات كانت قائمة على أساس اتفاقيات أوسلو التي رفضتها حماس جملة وتفصيلاً، ولم تقر حتى بالمبادئ الرئيسة المضمنة في تلك الاتفاقيات. كان القرار المفروض في الجانب الأمريكي من قبل كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية قد أدى –بدوره- إلى فوز هزيل لحركة حماس في الانتخابات مع جهود خجولة مبذولة بالكاد من أطراف عديدة لحرمان حماس من استحقاقها الانتخابي؛ كما تمخَّض في نهاية المطاف عن انقلاب يونيو (حزيران) 2007 وإبعاد السلطة الفلسطينية وطردها من غزة، وتَدَثُّر حماس بوشاح سوء الحكم منذ ذلك الوقت.
أدى ما سبق بيانه إلى النبذ السياسي والدبلوماسي للسلطة الفلسطينية ووضع قيود جديدة على الحوار الفلسطيني- الإسرائيلي وتقوية النزعات اليمينية في المشهد السياسي الإسرائيلي، وفتح مسار جديد للنفوذ الإيراني في أرض الشام وتقوية المد الإسلامي السياسي الاستبدادي على المستوى الإقليمي، مما تسبب -بطبيعة الحال- في اندلاع سلسلة من الحروب الخاطفة المدمرة التي عضَّدت ساعد الساسة صعبي المراس شديدي الشكيمة الذين مردوا على العصيان والعناد، وألحقت الأذى بالمدنيين في جميع أوجه معاشهم وسبل كسب عيشهم. ولعل من حسن الطالع أنه إذا كان لأحدنا أن يطلق العنان لخياله مستأنساً بكلمة من هذا القبيل في هذا السياق، فإن المأساة المتجددة والمتكررة منذ ذلك الحين في غزة لا تهدد بابتلاع مساحات شاسعة من الإقليم الغارق أصلاً في سموم وهموم أخرى تكفي لتفسير المشكلات الجمة التي يقع الإقليم تحت نيرها. فهي إذاً محض نازلة وفاجعة محلية.
بالإضافة إلى ما تقدم، وما يعنينا في هذا الصدد ويخدم غرضنا الذي نحن بصدده، هو أن دور دونالد رامسفيلد تراوح بين ضئيل ومعدوم في الأحداث التي عصفت بالقضية الفلسطينية في حوالي 2006 و2007. وقل مثل هذا عن جميع من كانوا يعملون معه في ذلك الوقت. أما المسألة الجوهرية في هذا الخصوص، فهي أن رامسفيلد لم يكن الوحيد من بين المسؤولين رفيعي المستوى الذين ارتكبوا أخطاء في إدارة بوش الذي تقلد منصب الرئيس الأمريكي؛ وقد ارتكب قلة من أخطائه بمفرده.
الصواب والخطأ والمفقود (الناقص أو الفراغات)
أما التعليقات الجديدة التي أوردت بعد موت رامسفيلد، فقد ورد جزء كبير منها متناثراً في ثنايا أخطاء التفسير ومتبعثراً في سياق مغالطات التأويل؛ بعضها جديد، وبعضها موجود منذ أمد بعيد. سنتطرق إلى بعضها لاحقاً. بيد أن ما يندرج تحت منزلة المفقود أوضح مما يندرج تحت بند الخطأ. ولعل العديد من الأسئلة الواضحة التي كان من المفترض أن يطرحها آنذاك الصحفيون الذين يتحلون بروح المسؤولية -ولكن قلَّما تم طرحها بل لم يتم طرحها من الأساس وبالمطلق– ما فتئت محجوبة عن العرض على شاشة الرادار طوال تلك السنين العديدة فيما بعد، على الرغم من الإضافات المستفيضة التي أُلْحِقَتْ بالأدبيات ذات العلاقة والصادرة عن كبار المسؤولين –من كتب ومذكرات من الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ومستشارة الأمن الوطني، التي أصبحت فيما بعد وزيرة للخارجية كونداليزا رايس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت، ومساعد وزير الدفاع دوجلاس فيث، وبطبيعة الحال دونالد رامسفيلد نفسه. من هذه المادة ومن الكثير غيرها مما هو متاح في المجال العام، تحصلنا على الكثير من المعارف ووقفنا على الكثير من المعلومات- بيد أن الثغرات والفجوات ما زالت موجودة. أما أحدث سلسلة من التعليقات –التي لا مراء في أنها ستكون مكررة بمعدل أربع مرات -على أقل تقدير- عندما ينتقل كل من جورج دبليو بوش وديك تشيني وكولن باول وبول وولفويتز إلى الدار الآخرة– فلن تضيف شيئاً ذا بال أو تضفي أمراً ذا شأن، وإنما تفضي فقط إلى تردد أصداء الحطام والأنقاض المتهالكة من بقايا الاعتقادات الواهية، والقناعات الهزيلة المهترئة التي تفتقر إلى أي سند وأساس.
من الواضح أن بعض الناس لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من معاودة القتال في حرب العراق. أما أنا، فلست بأَحَدٍ منهم –ذلك أنني أعتز وأعتد بالتماس المواساة والعزاء النفسي من النسيان الانتقائي عندما يكون النسيان أقل ألماً من تذكر الحقيقة، لولا أن إحساساً بالالتزام تجاه السجل السردي التاريخي ظل يلازمني الآن ويتملكني ويمسك بتلابيبي فلا أجد منه فكاكاً وأنا أتخطى عتبة السبعين من العمر، فأشعر بأنه يمسي لزاماً عليَّ أن أقول بعض الأشياء، وإن كنت سأتوخَّى الحرص الشديد –وهي أشياء ما كان لي أن أشعر بالارتياح لو أنني قلتها عندما كان رامسفيلد على قيد الحياة. لقد تعلمنا ألا نتحدث إطلاقاً بسوء عن الأموات؛ وهذه مناشدة غالباً ما يتم الإعلان عنها، بل والتبجح بها أكثر بكثير مما يتم بشأن مراعاتها والتقيد بها في الحياة السياسية. وبكل حال، أنا آخذ تلك المناشدة مأخذ الجد. لذا أرجو منك أن تكون مطمئناً كذلك -إن أنت كنت ممن يأخذون المناشدة المذكورة مأخذ الجد- أَنَّ ما اقتضى مني المقام قولَه لا يندرج تحت ذكر الموتى بالسوء أو التحدث عن مساوئهم. وإنما في الغالب على النقيض من ذلك.
فضلاً عما تقدم، سبق لي أن دفعت بمقارباتي النقدية عن رامسفيلد وأدائه في أوقات الحرب منذ زمن بعيد، في مقال منشور بمجلة “ناشيونال ريفيو” بتاريخ 4 أبريل (نيسان) 2011، مستعرضاً فيه مذكرات رامسفيلد التي قدّمها في كتاب تحت عنوان “المعلوم والمجهول” أو “المعروف وغير المعروف“: مذكرات (Known and Unknown: A Memoir)”. لقد كان رامسفيلد في أبريل (نيسان) 2011 على قيد الحياة وفي عنفوان نشاطه الحياتي، وكذا الأمر بالنسبة للكثيرين ممن عملوا معه، وكنتُ على علاقة وطيدة معهم. لست متأكداً مما إذا كان المحرر المسؤول بمجلة ناشيونال ريفيو ريتش لوري متوقعاً الآراء النقدية التي قدمتها، ولكن مما يُحسب له كمحرر يتصف بالأمانة أنه طلب نشرها ولم يشأ أن يغير نبرتها العامة، بل وأظهرها كموضوع غلاف أو مقال رئيس لذلك العدد من المجلة. وأنا على يقين من أن بعض زملائي الذين عملوا في وزارة الدفاع لم يستلطفوا ما أوردت في المقال ولم يكن أي منهم راضياً عنه.
ما ورد أعلاه يحدث في الغالب عندما يزعم كاتب ما أنه لن يحيد قيد أنملة ولن يغيّر كلمة واحدة مما سبق أن كتبه في الماضي، وبالنسبة لي يعود ذلك جزئياً إلى ذكرياتي عن رد الفعل المذكور؛ إلا أنه وبمنظور عقْد من الزمان (بعد مرور عشر سنوات) عَنَّ لي أن أغير بضع كلمات لكوني أرى الآن نمطاً متأصلاً في صميم شخصية رامسفيلد ما كان لي أن أستبينه إلا لماماً وبالكاد في ذلك الوقت. قطعاً، لن يغيِّر هذا من حكمي على أداء رامسفيلد في منصبه الرسمي، ولكنه حتماً يساعدني على تحقيق فهم أفضل لكيفية تصرفه وقتها، ولماذا تصرَّف على النحو الذي تصرَّف به.
من وجهة نظري:
دعوني أعمل على تهيئة المسرح مستهلّاً الأمر بوصف لما كنت أقوم به في أثناء استعراضي لمذكرات رامسفيلد على صفحات مجلة ناشيونال ريفيو، المجلة الأمريكية الرائدة الخاصة بالمحافظين، والتي تعنى بالشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية، لمؤسسها ويليام باكلي. قصارى القول: إن رئيس التحرير ريتش لوري سألني وعرض عليَّ مبلغاً من المال على الرغم من إدراكه أنني لم أكن وقتها مدرجاً في سجلات الجمهوريين التي لم أكن مدرجاً فيها إطلاقاً في أي يوم من الأيام.
بالعودة إلى ذلك اليوم، دعاني لوري للكتابة في ناشيونال ريفيو حيث استكتبني فيها ولم يكن مهتماً بصفة خاصة بآرائي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي كانت مُهْمَلَة إلى حد بعيد في مجلة ناشيونال ريفيو. وكانت تحدوني الرغبة في قبول الرهان مدركاً أن معظم الناس لن يفترضوا أنني محافظ ذرائعي (براجماتي) لمجرد أن اسمي ظهر في المجلة. أكاد أكون الوحيد في هذا الموضع وقتها. وقد كتبت عشر مرات لمجلة ناشيونال ريفيو خلال الفترة من 1991 إلى 2011، حيث غطت كتاباتي أربعة استعراضات أو أربع مراجعات لكتب وست مقالات وتقاضيت عليها أجراً، وجميعها كانت بناءً على طلب المحرر المسؤول باستثناء واحدة أو اثنتين. كنت أيضاً أكتب خلال تلك الفترة لمجلة ذات توجهات ومنطلقات فكرية مختلفة، هي مجلة ذي نيو ريببلك على سبيل المثال. وفي الحالتين -على حد سواء- كنت فقط أستظهر نصيحة صامويل جونسون وأحفظها عن ظهر قلب؛ لأن بعض الوصايا السديدة تظل خالدة أبد الدهر ولا تعبث بها أصابع الزمن: “وحده الأحمق هو الذي لا يكتب إلا مقابل المال”. وبدا لي أيضاً أن القراء على اختلاف مشاربهم يمكن أن يستفيدوا من التحليلات الصائبة الرصينة التي تظهر في مصادر يثقون بها، وهي ربما تعارضت مع بعض آرائهم.
أما استعراض مذكرات رامسفيلد في أبريل (نيسان) 2011، فقد كان آخر عمل تحريري طُلِبَ مني كتابته وتدبيجه لمجلة ناشيونال ريفيو. وبعد ذلك لم أعرض أياً من كتاباتي الخاصة. صارت الأشياء تتغير تدريجياً في بادئ الأمر ثم سرعان ما أخذت تتواتر تباعاً وبوتيرة متسارعة. قبل عام 2003 أو 2008 أو حتى في 2011، لم يكن الأمر خارجاً عن المألوف تماماً لكبار الجمهوريين أن يعملوا بين الفينة والفينة لدى إدارات الديمقراطيين (عندما يكون الحزب الديمقراطي على سدة الحكم) (ومن أمثلة ذلك ويليام كوهين وهو جمهوري تقلد منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس كلينتون) وللديمقراطيين أن يعملوا مع إدارات الجمهوريين وللمستقلين أن يعملوا في إدارتي الحزبيْن على حد سواء. لم تكن كل الأمور مسيَّسة أو مكسوة بالطابع السياسي إلى ذاك الحد. فمعايير الكفاءة والخبرة والجدارة والموهبة ما فتئت تحتل مكانتها ويتم الاعتداد بها لكونها من الأمور المهمة لشغل المناصب التي تتطلب مهارات معينة، بغض النظر عن الموقف أو التوجه السياسي. وبمثل هذا ولأجله، أصبحتُ كاتباً ومحرر خطابات ارتبط عملي بهيئة موظفي تخطيط السياسات لدى كولن باول، حيث تم تعييني “خبيراً”على الجدول (ب) في صيف 2003.
أبدى العديد من الأمريكيين آنذاك رغبتهم في أن يترشح كولن باول في الانتخابات الرئاسية. بيد أن باول لم يكن يرغب في خوض غمار الانتخابات إلا إذا كان يعتقد أنه سيفوز فيها –الأمر الذي أدى إلى استبعاد محاولة مستقلة للترشح فيما يتعلق به. ولأجل هذا واجه باول مشكلة: لم يكن بمقدوره أن يتحدث بصدق وأمانة وبأسلوب مقْنع عن الأشياء المتعلقة بشؤون السياسة الداخلية كما كان الجمهوريون يريدون منه أن يتحدث فيها بصفته حادي ركبهم وحامل لوائهم. وبالمثل، لم يكن بمقدوره التحدث بصدق وأمانة وبأسلوب مُقْنِع عن الأشياء المتعلقة بالسياسة الخارجية وسياسة الأمن الوطني على غرار ما كان الديمقراطيون يرجونه منه. فإذا كان بمقدوره أن يظفر بترشيح أحد الحزبين الكبيرين، لكان من الوارد أن يتم انتخابه رئيساً؛ إلا أنه لم يتمكن من كسب ود الجمهوريين تماماً كعدم تمكنه من خطب ود الديمقراطيين من غير أن يخون مبادئه الخاصة ويدوس على آرائه الشخصية. لأجل هذا لم يرشح نفسه ولم يخض غمار الانتخابات. وعلى الرغم من أن باول عمل مستشاراً للأمن الوطني في إدارة ريجان، ثم عمل رئيساً لهيئة الأركان المشتركة في أثناء عملية عاصفة الصحراء في عهد جورج بوش الأب –الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وكعسكري حاصل على رتبة رفيعة ومدجج بالأوسمة العسكرية، لم يكن ملفه السياسي زاخراً بالإنجازات. لذا عندما اقتربت انتخابات عام 2000 كان من المفهوم أن باول جمهوري بفضل ارتباطاته السابقة، ولكنه كان اسمياً ولم يكن رسمياً أو براجماتياً.
يوجد بيننا توافق وتناغم وانسجام: كلانا انتقائي ديدنه الاصطفائية؛ ونتخذ غالباً موقف يسار الوسط في القضايا والشؤون الاجتماعية والاقتصادية. ثم كلانا محافظ ثقافياً؛ كما أننا من صقور الانخراط الانتقائي –بدرجة عالية من الانتقائية- في السياسة الخارجية. وفي واقع الأمر، كنت معترضاً على بعض العمليات التي شارك فيها باول أو قام بتنفيذها –جرينادا 1983 وبنما 1989- كما اعترضت على التدخل العسكري في دول البلقان في تسعينيات القرن الفائت.
وفوق هذا وذاك، كان باول على إدراك بأن الحرب العراقية عندما بانت سوءاتها وأسفرت عن أهوالها بدأت ترشح الاتهامات المتبادلة بشأنها؛ وطفق المختصون يتقاذفون التهم، فَيُنْحِي كل منهم باللائمة على الآخر. وقد نجم ذلك عما يحمله بعض مسؤولي وزارة الدفاع من مشاعر بغض وكراهية ونفور بصفة عامة تجاه وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية؛ كما أدى ذلك في الوقت نفسه إلى تأجيج تلك المشاعر، وترددت أصداؤه مع خلاف دفين قديم بخصوص نهاية حرب العراق عام 1991. فكما هو ثابت من واقع السجلات العامة، كان بعض كبار المسؤولين يرغبون في الوصول إلى بغداد والإطاحة بنظام البعث عنوةً. كان من ضمن هؤلاء المسؤولين ديك تشيني وزير الدفاع وقتها، وبول وولفويتز مساعد وزير الدفاع للسياسات آنئذٍ. ولأسباب مختلفة اختلافاً طفيفاً اتضح فيما بعد أنها أسباب قوية، لم يوافق الرئيس جورج بوش الأب ومستشار الأمن الوطني برنت سكوكروفت ورئيس هيئة الأركان العامة كولن باول، فكانت الغلبة لرأيهم وقتها. لم تلتئم الندوب والبثور التي خلفها ذلك الخلاف ولم تبرأ تلك الجراح تماماً. أما مَنْ لم تكن الغلبة لرأيهم حيال القرار الذي اتُّخِذَ بشأن عدم الإطاحة بصدام حسين، فقد سنحت لهم الفرصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 لاسترجاع شريط الأحداث والوقائع وتسجيل نسخة جديدة منها بعد عشر سنوات، دعنا نقل، عن كيفية انتهاء عملية عاصفة الصحراء.
في كل الأحوال، كان باول يرى أن من الحصافة وحسن التدبير أن يكون لديه شخص يثق فيه للعمل معه كأمين سر وكاتب خاص إذا رغب ذات يوم في الذود والدفاع عن سجله المتعلق بالحرب والأمور الأخرى. وبدافع مما يمليه الضمير الحي، لم يستطع أن يطلب مسؤول خدمة خارجية –موظف على الجدول (أ)– للاضطلاع بتلك المهمة؛ ولم يكن يبدو أن من الحكمة أن يطلب موظفاً من المعيَّنين سياسياً– موظف على الجدول (ج). لذا طلب مني ذلك -فَمَنْ أنا حتى أرفض أو أعترض؟
في عدة أيام بعدما كان باول يعود في وقت متأخر من الظهيرة إلى مكتبه الصغير في الدور السابع بوزارة الخارجية، كان يستدعيني من أقصى القاعة في مكتب تخطيط السياسات، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة لاري ويلكرسون الذي جرت العادة على أن يكون حاضراً، حيث درج باول على استعراض آخر التطورات وأحدث المستجدات في الإخفاقات والإشراقات في إدارة بوش، بينما كنت أعكف على تدوين الملاحظات وتسجيل الوقائع. وبطبيعة الحال كنت أيضاً أقرأ المعلومات الاستخبارية حول ما كان يجري بتصريح وترخيص بخصوص (المعلومات الأمنية المصنفة الحساسة المحفوظة في الخزائن العسكرية “ SCI“) بحيث إن ما كنت أسمعه من وزير الخارجية كان يقع ضمن سياق أشمل. كان باول في العادة يتصف بالهدوء وكان يستخدم الأوصاف وينزع إلى التفاصيل ويتحلى بروح الدعابة. إلا أنه كان في بعض الأحيان يستشيط غضباً ويستبد به الإحباط؛ كما أنه ليس ببعيد عن استخدام اللغة الفظة والوصف الدقيق في المناقشات الخاصة.
هكذا أصبحتُ شخصاً هامشياً جداً ذا رؤية داخلية قوامها الإلمام ببواطن الأمور المتعلقة بأحداث العصر –وهي رؤية توصف بالكاد بأنها شمولية ولكنها متفردة ومميزة بكل المقاييس. فيا ليت شعري هل كنت أنا فورست غامب (Forrest Gump) السياسة الخارجية الأمريكية لبرهة من الوقت؟ يصعب أن أكون كذلك. بيد أنني أعرف بعض الأسئلة التي كان من المفترض طرحها داخل إدارة بوش وخارجها، وهي أسئلة من الواضح أنه قلَّما تم طرحها أو تم طرحها بصوت مكتوم أو لم يتم طرحها البتّة، عن ماهية العديد من الأحداث الكبرى التي وقعت وعن كيفية وقوعها.
ما زلت أحتفظ بملاحظاتي ومذكراتي وذكرياتي عن جلسات الإحاطة والاطلاع التي كانت تُعقد بعد الظهر؛ وهي ملاحظات ومذكرات لم توضع منذ ذلك الحين قيد الاستخدام الخاص بأي وجه بعد أن آثر باول ألا يكتب مذكراته بعد مغادرة المنصب الوزاري. ولم ترد إشارة قط مني إلى أي من تلك المذكرات والملاحظات في كتاباتي، بل ولم ترد أي إشارة إلى مجرد وجودها منذ أن ظهرت ولمدة ست عشرة سنة بعد ذلك وإلى الآن.
أنا الآن بصدد إزاحة الستار وإزالة الغطاء عن صندوق الذكريات والملاحظات بقدر يسير جداً. وفي الوقت الملائم ستعلمون كيفية حدوث ما تسبب فيه سجن أبي غريب من حرج بالغ ووضع كارثي بكل المقاييس. ستعلمون أيضاً كيفية حدوث الحرج البالغ والوضع الكارثي نتيجة للخطأ الفادح والفاضح لمجموعات الاستخبارات بشأن التكدس المزعوم لأسلحة الدمار الشامل في العراق، وأسباب اندلاع الحرب في العراق، ولماذا أدهشت انتفاضة العراقيين كبار المسؤولين الأمريكيين، وأسباب فشل الجهود التي بُذلت لاحقاً لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن و”إعادة تعمير” العراق. علاوة على ما تقدم، ستحصلون على بعض المعلومات عن كيفية انزلاق المهمة الأفغانية المشار إليها آنفاً إلى مهاوي الخيبة والإخفاق وتسللها رويداً رويداً إلى متاهات الفشل.
بالإضافة إلى ما سبق بيانه، ستحصلون على بعض المعلومات عن دور دونالد رامسفيلد في جميع ما تم التطرق إليه آنفاً؛ وبالتبعية، ستحصلون على بعض المعلومات بطريقة غير مباشرة عن النفوذ الفردي ونفوذ الشخصيات التي انخرطت في المهمة وتورطت في الأزمة، وقدرة شخصيات من هذا القبيل على التأثير في السياسات الخارجية للقوى العظمى.
ولكن ما عليكم ألا أن تنتظروا…
* آدام جارفينكل هو كاتب عمود لدى مركز المسبار، كما أنه عضو بهيئة تحرير مجلة “أمريكان بيربوس (American Purpose)” في واشنطن. عمل خلال الفترة من 2003 إلى 2005 كاتباً لخطابات وزير الخارجية –ملتحقاً بمجموعة تخطيط السياسات بالوزارة. هذا المقال هو الأول في سلسلة مخطط لها من خمسة أجزاء.