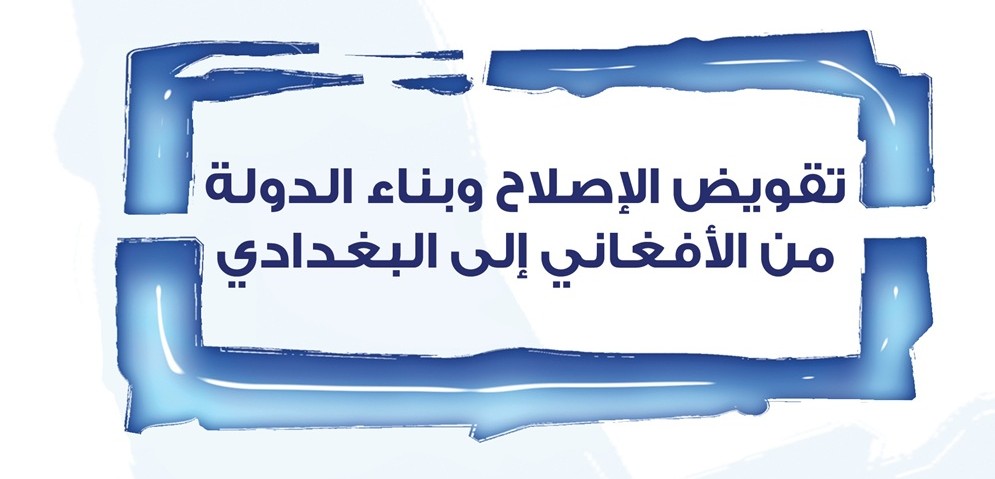يُعبِّر المرء -في كثير من الأحيان- عن فكرة يكون نطاق تطبيقها متجاوزاً لحدود الغرض المتوخَّى من توليدها. لعل هذا ما ينطبق على المقولة الشهيرة التي أدلى بها الشيوعي الإيطالي، “أنطونيو غرامشي” (Antonio Gramsci) قبل حوالي مئة سنة؛ حيث كتب في أوائل عشرينيات القرن الماضي ما يلي: “تتألّف الأزمة تحديداً من حقيقة أنّ القديم يموت والجديد غير قادر على أن يولد، وفي هذه الفترة الفاصلة تظهر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعراض المَرَضيَّة“. ولما كان “غرامشي” قد أورد مقولته المذكورة أعلاه بخصوص النظام الحضاري الأوروبي حينها، ربما لا يكون في وارد تفكيره أن يوافق على استعارتي مقولتَه تلك لوصف المأزق الحالي للاستراتيجية الأمريكية الكبرى، وكيفية تطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى انطباقها على تلك المنطقة. وبكل حال، تنطبق تلك المقولة على هذه الحالة بطريقة لا سبيل إلى تجاهلها؛ فكيف يا تُرى ذلك؟
لقد آلت الاستراتيجية الأمريكية الكبرى القديمة لمرحلة ما بعد الحرب العالمية إلى اندثار إثر ازدهار، فبادت بعدما سادت، ليس لأنها فشلت أو قوبلت بالرفض المتعمَّد، بل لأنها نجحت ثم تداعت مرتكزات نجاحها وتآكلت عناصره وتهاوت محاوره واحداً تلو الآخر، فضلاً عن فقدان فعاليتها تالياً ثم الخواء وفراغ المضمون لاحقاً. ولأن تلك الاستراتيجية آلت إلى ما آلت إليه بالطريقة المذكورة آنفاً، وانهارت وتوارت عن المشهد دونما جلبة أو ضوضاء، وانحسرت في ظروف اتصفت بالسكون والهدوء النسبي، لذا لم يظهر أي بديل ليحل محلها.
وإذا كان من السهل إيجاز الاستراتيجية الكبرى وتلخيص محتواها، فمن المهم جداً فهمها واستيعاب فحواها، إن كان لنا أن نغتنم تجليات اللحظة الراهنة وأن نتشبث بأهدابها:
- توفير مقوِّمات الأمن العام للعالم؛ لأجل الحيلولة دون هيمنة المناوئين للمفاهيم التحررية والليبرالية، ومنعهم من بسط نفوذهم سواء في أوروبا أو في شرق آسيا؛ وبذا يتسنى منع وقوع حرب كبرى أخرى في القرن العشرين.
- يجب أن يتم ذلك بالتماس السبل السياسية والدبلوماسية بالتوافق بين مجموعة من الشركاء، بطريقة رسمية أو من دونها، حتى يتأتى تأسيس ما أبدع المؤرخ النرويجي “غير لونديستاد” (Geir Lundestad) أيّما إبداع في تسميته عام 1968 بفطنة ودهاء، فأطلق عليه مسمى “إمبراطورية قائمة على توجيه الدعوة (Empire BY Invitation)”؛ كما يجب أيضاً أن يتم ذلك بالطرق العسكرية من خلال النشر المتقدم المسبق للقوات الأمريكية، بحيث يتمركز نشرها بصورة رئيسة على مشارف المنطقة الفاصلة بين القارتين الأوروبية والآسيوية لكبح جماح التنافس المحموم، المفضي إلى زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي، وهو التنافس الذي يمكن أن تستغله القوى المهيمنة المحتملة وأن تسخره لصالحها؛ مع درء الأخطار المصاحبة لذلك التنافس، والمتمثلة في سباق التسلح والعوامل المفضية إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل.
لقد كانت تلك الاستراتيجية الأمريكية الكبرى لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بمثابة امتداد لوسائل وأدوات أخرى في سياق الاستراتيجية الكبرى المزدوجة المناوئة لهيمنة الآخرين، وهي الاستراتيجية التي صيغت للوهلة الأولى في نهاية القرن التاسع عشر عند بداية ظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية لأول مرة. وقد كانت الاستراتيجية الأصلية من بنات أفكار “ألفريد ثاير ماهان” (Alfred Thayer Mahan) وثيودور روزفلت” (Theodore Roosevelt)؛ وكانت قائمة على احتذاء حذو البحرية الملكية والنسج على منوالها مع الاعتماد على المساعدة الذاتية، وليس على شبكة التحالفات أو النشر المتقدم المسبق للأصول العسكرية والحربية. وقد انطوى خيار الاقتداء بالبحرية الملكية والاستهداء بنموذجها على بناء صرح ضخم وهائل للقوات البحرية الأمريكية واستكمال إنشاء قناة بنما؛ التي تمثل حلقة وصل مفصلية للربط بين الأساطيل البحرية الأمريكية الموجودة في المحيط الأطلسي وتلك التي تمخر عباب المحيط الهادي.
لئن كانت هذه النسخة من الاستراتيجية معقولة بما يكفي من الناحية النظرية على الورق، إنها سجلت إخفاقين من الناحية العملية على أرض الواقع: تمثَّل الإخفاق الأول في التعامل مع التهديد المتمثل في الهيمنة الألمانية على منطقة شبه الجزيرة الأوروبية، مما دفع قادة الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى خوض غمار الحرب العالمية الأولى في صفوف الحلفاء؛ ثم مرة أخرى في مستهل حرب المحيط الهادي، وبعد ذلك الحرب العالمية العامة للمرة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) 1941. من الملاحظ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يكن لها أي دور فعلي يُذكر في الفكر الاستراتيجي الأمريكي قبل الفترة من 1945 حتى 1948. أما شبه الجزيرة الأوروبية، ثم ثانياً منطقة شرق آسيا، فقد شكلتا لبنات الاستراتيجية الأمريكية التي حازت على حرص القادة والمخططين الاستراتيجيين الأمريكيين واستحوذت على اهتمامهم. كانت تلك هي المناطق التي يمكن أن تكون مصدر تهديد لانطلاقة “جزيرة العالم” الأمريكية. أما منطقة الشرق الأوسط، فلم تكن ذات أهمية تُذكر لدى الاستراتيجيين الأمريكيين قبل عهد النفط. وبكل حال، كانت بريطانيا العظمي، أكبر حلفاء الولايات المتحدة، مسيطرةً على معظم ما يتطلب السيطرة ويقتضي الهيمنة في المجالات البحرية ذات العلاقة. أما ما تبقى، فكان أمره متروكاً لنشاط البعثات التبشيرية وبعض النشاط التجاري، ولم يكن أي منهما ذا أهمية تذكر بالنسبة لراسمي الخطط الاستراتيجية في الولايات المتحدة.
الخطأ الفادح
كما ورد آنفاً، انتهى الأمر بالنسخة المزدوجة للاستراتيجية الكبرى لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والنسخة المزدوجة لتلك الاستراتيجية المناهضة للهيمنة، إلى أن أصبحت في عداد الأموات؛ فهي ميتة على الرغم من الوجود المخادِع للقشور الخارجية الجافة للنظام القديم وآثاره المضلِّلة في الميزانيات العسكرية وميزانيات الأجهزة الاستخباراتية التي يعتريها القصور الذاتي، وعمليات نشر القوات الموروثة من مخلفات الماضي، وما جرى إبرامه من المعاهدات غير الفعالة، وما تم بناؤه من المؤسسات المهترئة التي عفّى عليها الزمن وتجاوزتها الأحداث، والتي كان وجودها لازماً وقتها في ظل ظروف مختلفة بقدر كبير، وإلى حد بعيد عمّا هو سائد الآن.
يشتمل ذلك الوجود في منطقة الشرق الأوسط على المنشآت والقواعد العسكرية الكبرى للولايات المتحدة في كل من البحرين وقطر، والأصول العسكرية وأصول جمع المعلومات الاستخباراتية الموجودة، بقدْر أقل في العديد من الدول العربية الأخرى. وقد ظلت الأصول العسكرية الأمريكية موجودة في تركيا على الرغم من المشكلات السياسية التي اكتنفت العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت هنالك أصول عسكرية كبرى موجودة في إيران قبل عامي 1978/ 1979. أما إسرائيل، فهي حالة خاصة من التعاون الثنائي في مجال جمع المعلومات والعمليات الاستخباراتية، ولكن دونما وجود ملحوظ لأي أصول وموجودات عسكرية أمريكية معتبرة داخل البلاد (داخل إسرائيل).
لعل ذلك الوجود أو تلك البصمة بوجه عام، وتحديداً ما يتعلق منهما بتجليات المظاهر المادية المحسوسة للأغراض الاستراتيجية الأمريكية، هو ما دفع بعض المراقبين إلى أن يظلوا مصرّين بإلحاح، ولعشرات السنين، إما على عدم فهم تلك الأغراض أو تعمُّد تحريفها وتشويهها عن قصد. أما مفهوم السلام الأمريكي (Pax Americana)، فهو لم يكن بأي حال معنياً بتعظيم الذات مادياً؛ وإنما أفضى هذا المفهوم إلى خدمة مرئيات مَنْ أنشأه ومَنْ رعاه لاحقاً فيما يتعلق بالمصلحة الذاتية المستنيرة للولايات المتحدة الأمريكية؛ مما حال دون قرع طبول الحرب بين القوى الكبرى في عهد الأسلحة النووية؛ كما أدى في الوقت نفسه إلى التمكين لما كان يراه المنشئون السابقون للمفهوم المذكور أعلاه ورعاته اللاحقون، من ضرورة نشر ما يرونه قيماً تحررية (ليبرالية) أصيلة ومتأصلة ومتجذرة، ومناهضة لإفرازات الدوافع العسكرية والأمنية لنظريات العقيدة السياسية الانضباطية التي ترى في الحرب والتحدي الأمني محفزاً تاريخياً للتقدم والتنظيم وصعود الدولة الحديثة، حيث إن صناعة الحرب تفضي إلى بناء الدولة، وبناء الدولة يفضي إلى صناعة الحرب حسب تلك النظريات (Bellicist Theories). وتتمثل تلك القيم في قيم التجارة الحرة والديمقراطية المناوئة للنتائج المتقدم ذكرها (Anti-Bellicist Liberal Values)، وهي القيم التي ينبغي أن تعم وتسود لعموم الفائدة والمصلحة لجميع المجتمعات، التي تختار بمحض إرادتها الحرة أن تتمسك بها.
كان من الطبيعي أن يقع العديد من المراقبين الأجانب، بمن فيهم مراقبون في الشرق الأوسط، في حبائل سوء الفهم لتلك المقاصد والغايات الأمريكية. فقد كان الأمريكيون غربيين ومسيحيين، كشأن البريطانيين والفرنسيين، وسابقاً البرتغاليين والهولنديين، ولاحقاً الإيطاليين والألمان. وبينما كانت الإمبراطوريات الغربية عبارة عن قوى احتلال تقليدي تحركها المصالح التجارية، وخاضت غمار تنافس محموم فيما بينها، لاستغلال خيرات الأمم الأدنى نفوذاً والأقل تقدماً من الناحية التكنولوجية، أسس الأمريكيون أول حركة وطنية للتحرر ومكافحة الاحتلال في العهد الحديث: ففي 1776، ظهرت في أمريكا حركة وطنية مدنية نهلت من معين ثقافة مهاجرين، وهي ثقافة مصهورة في بوتقة التنوير وممهورة بخصائص الاستنارة، وليست حركة وطنية قائمة على نعرات قبائلية والنسل والسلالة، على غرار ما كان سائداً في “العالم القديم”- أوروبا.
أما مفهوم المصلحة الذاتية المستنيرة ذاته، الذي يعني أن المرء يمكن أن يكون فعالاً ومفيداً لنفسه ولغيره في آنٍ معاً، وأن العلاقات الإيجابية المفيدة للجميع “العلاقات ذات القيمة الإيجابية” (Positive-Sum Relationships) هي علاقات تقع في نطاق الممكن كوقوعها في سياق المرغوب سواء بسواء، فقد خرج من رحم الثورة المزدوجة للتنوير والإصلاح والبروتستانتي؛ وهو الرحم ذاته الذي تخلَّق فيه الجنين الذي أصبح أمريكا فيما بعد.
لقد حل المفهوم المذكور محل الذهنية القديمة ذات القيمة الصفرية (Zero-Sum) لمرحلة ما قبل دارون، حيث البقاء للأفضل؛ وهي العقلية التي كانت سائدة في معظم الأزمنة والأمكنة العتيقة. بيد أن هذه الأفكار لا تحظى -في كثير من الأحيان- بالتعظيم اللائق، فلا تجد من يقدرها حق قدرها لأنها لم تُفهم بشكل جيد، ولكونها دخيلة وغريبة على أغلب قاطني منطقة الشرق الأوسط، بمن فيهم الصفوة.
لذا ينظر هؤلاء الناس، وكذا النخبة منهم، إلى القوة الأمريكية كقوة بغي وقهر واحتلال، كشأن سابقاتها من قوى الاحتلال البريطانية والفرنسية سواء بسواء.
هذا هو الأصل الذي استند عليه المنتقدون، بمن فيهم بعض الأمريكيين، ممن درجوا على تسمية السياسة الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بأنها سياسة احتلال، ودأبوا على وصفها على هذا النحو على طريقة ممارسي الشعائر الطقوسية، مع النزوع في العقود الراهنة إلى اقتباس الأرقام على سبيل الاستشهاد على كيفية أن ميزانية القوات البحرية الأمريكية -على سبيل المثال- تجاوزت ميزانيات نظيراتها البحرية لست أو سبع دول مجتمعةً، من الدول التي تلي الولايات المتحدة مباشرة على قائمة الدول الأقوى. وبذا فكأنما كانوا يشيرون إلى الطبيعة العسكرية الجامحة مطلقة العنان للسياسة الأمريكية. عديدة هي المصادر والأسباب المفضية إلى مناهضة الأمريكانية؛ فهي تشتمل على أخطاء السياسة الأمريكية (فيتنام مثلاً) وخطايا الغطرسة والانكباب على الذات. إلا أن ما سبق بيانه أفضى إلى حقيقة أن المنتقدين لم يلحظوا إطلاقاً دور الولايات المتحدة في توفير مقومات الأمن العام على المستوى الدولي، ولم يلقوا بالاً لأن هذا الدور يقتضي النشر المتقدم المسبق للأدوات الأمريكية الرئيسة –القوات الجوية والبحرية– بوصفها الأدوات القادرة على تحقيق الإنجازات على الأرض من خلال بث الطمأنينة، والعمل على استتباب الأمن وتوفير قوة الردع بصورة لا تتأتى لقوات الدول الأخرى.
كذلك لم يلحظ المنتقدون إطلاقاً أنه بسبب الارتفاع النسبي للإنفاق الأمريكي على الدفاع، يمكن أن يكون الإنفاق على الدفاع من قبل العشرات من الدول الأخرى والحلفاء والشركاء، بل وحتى غير المشاركين في الأحداث، منخفضاً نسبياً وبشكل كبير وأقل بكثير مما كان ينبغي أن يكون عليه.
دعنا نؤكد أن هذا كان يصب –قطعاً- في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة: ففي عالم توازن القوى المحض، كان ينبغي أن يكون إنفاق الولايات المتحدة على ميزانيات الدفاع أعلى بكثير لتحقيق حدٍ أدنى من الأمن للولايات المتحدة ولحلفائها؛ ولكن كان هذا أيضاً في مصلحة آخرين كثر، ويشمل ذلك المنتفعين دونما عناء. لقد طُبِخت “مشكلة” المنتفعين بلا عناء في المطبخ الذي شهد عمليات تطبيق الاستراتيجية الكبرى في الحرب الباردة عن قصد وعلم؛ فقد أُوثِق رباط الشريك المحظوظ بمزيد من الإحكام مع النظام الدبلوماسي الأمريكي، سواء في أروقة الأمم المتحدة أو في محافل أعم ومجالات أوسع نطاقاً.
وقل مثل ما سبق عن الاتفاقيات التجارية، التي كانت تصب قصداً وفي كثير من الأحيان في مصلحة الشركاء. لعل هذا أيضاً مما أدى إلى ارتباط هؤلاء الشركاء أكثر فأكثر بالقيادة الاستراتيجية الأمريكية، لئلا تغريهم مغريات وتغويهم للقفز من السفينة أو التلفت يمنةً ويسرةً، أو التخبط أو الاحتماء بالغير في سياق الحرب الباردة ثنائية القطبية. وقتها، كانت أمريكا على درجة كبيرة من الغنى والثروة والثراء بالمقارنة مع غيرها، بحيث كان استغلال رخائها وسخائها التجاري لمساعدة حلفائها، يعد ثمناً بخساً ضئيلاً للأغراض والأهداف الكبرى، ويعد دفعه قراراً حكيماً في ذلك السياق.
أما الآن، وحيث إن المزايا الاقتصادية الأمريكية أصبحت في حالة ملحوظة من الانحسار بعد المد، فإن الوجود السابق للمنتفعين بلا عناء ممن كانوا في كثير من الأحيان يتمتعون أيضاً بالمزايا والمنافع التجارية المتفاوَض عليها قبل سنوات، وينتفعون بتلك المزايا دونما ثمن يدفعونه، قد أصبح بمثابة بؤرة ملتهبة وموضوعاً ساخناً للطرق عليه وإثارته من قبل غوغائية الدهماء والرعاع، وصار هدفاً لسهام الشعوبية السياسية كما يتضح جلياً، وبما لا يدع مجالاً للشك، من سلوك إدارة ترمب ومن مواقفها تجاه ألمانيا واليابان والحلفاء الآخرين.
يشار إلى أن هؤلاء المنتقدين الذين طالما دأبوا على الانتقاص من القيم الليبرالية والحط من قدر تلك القيم، التي لأجل الترويج لها تم تصميم هذا الترتيب، إما إنهم كانوا منخرطين في حملات الدعاية أحادية الجانب، أو أنهم كانوا من دعاة فكر أيديولوجي مستقل. أما أولئك الذين اعتنقوا تلك القيم بالفعل، أو زعموا أنهم من معتنقيها، ولكنهم دأبوا على ترديد مزاعم انتقاصية من قبيل ما تقدم بأي شكل كان، فقد كانوا -في العادة- في حالة تجاهل مقصود أو جهل متعمد أو غباء بواح.
ما الذي تغيّر
أصبحت الاستراتيجية القديمة في عداد الأموات لأربعة أسباب، خارجية أو عرَضية؛ وهي أسباب وصفها العالم خارج الولايات المتحدة بأنها تغيرات، ولسبب داخلي أو جوهري واحد متعدد المصادر.
لقد أصبحت الاستراتيجية في عداد الموتى؛ والسبب الأول والأهم هو أن دافع الخوف الذي أدى إلى بلورة الاستراتيجية بصيغتها في مرحلة ما بعد الحرب –والمتمثل في الشيوعية السوفيتية– لم يعد قائماً ولم يعُد له وجود؛ ولم يظهر له بديل موحد متجانس ذو شأن ويمكن اتخاذه دليلاً أو الاعتداد به منذ عام 1991؛ إذ لا يمثل ما يسمى “الإرهاب الإسلامي” بديلاً؛ ولم تظهر الصين، حتى الآن، بالهيئة التي تجعلها الأغنى والأقوى والأكثر نفوذاً والأشد بأساً وذات التوجه المختلف كلياً.
أصبحت الاستراتيجية في عداد الموتى لأن كتلة التحالف الغربي الرئيس في أوروبا؛ فقدت دورها القيادي وافتقدت نشاطها وحماسها الجمعي وحميتها وحيويتها، بل وحتى مبرر وجودها في سياق تمددها وتوسع نطاق تدابيرها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة –كما افتقرت إلى أن تصبح النموذج التنظيمي الأمثل للقارة الموحدة الحرة التي تعيش في سلام وأمان. وربما كان الأسوأ من جميع ما سبق بيانه أن أوروبا تعاني حالياً من التمرغ في أوحال مستنقع من الأزمات المفصلية الحاسمة التي ترتبط جميعها بالارتباك الذي ضرب مسيرة الاتحاد الأوروبي، والحيرة التي أوقع الاتحاد الأوروبي فيها نفسه بنفسه، فلم يعد يستطيع التقدم إلى الأمام ولن يجرؤ على التراجع أو التقهقر. لا يمكن لما دبّ في أوصال القارة من يأس وقنوط، ظهرت تجلياته حالياً في مجموعة النزعات الشعوبية، أن يؤثر إلا على الجرس الخفي والإيقاع الأساسي لمجمل العلاقة بين ضفتي المحيط الأطلسي التي لم تكن إطلاقاً مجرد علاقة معاملات إجرائية أو عسكرية أو أمنية بحكم تعريفها، وإنما كانت دائماً وأبداً ذات بعد حضاري من حيث المدى والنطاق.
وفي غضون ذلك كان هيكل التحالف الأمريكي في آسيا في عهد الحرب الباردة دائماً أقل ضبطاً وإحكاماً، وأقل تكاملاً وانسجاماً بين عناصره الداخلية، وأقل تناغماً وتناسقاً من الناحية الثقافية بالمقارنة مع التحالف الأمريكي في أوروبا. ولم يكن التحالف الأمريكي في آسيا بأي حال في مستوى تحدي الأمس بشأن مصير الصين في الغد.
أما فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد كانت حصيلة العلاقات الأمريكية في ذلك الجزء من العالم أقل ضبطاً وإحكاماً، وأقل اتصافاً بالطابع الرسمي، وأقل انسجاماً من الناحية الثقافية، حتى بالمقارنة مع شرق آسيا -ذلك أن الولايات المتحدة لم تنضم إطلاقاً لحلف بغداد الذي آل إلى مصير بائس، كما أنها لم تفلح مطلقاً في إنشاء حلف على غرار حلف شمال الأطلسي في منطقة الشرق الأوسط، أطلق عليه مسمى حلف المعاهدة المركزية (CENTO)؛ وإنما كانت بدلاً عن ذلك منقسمة في أوقات مختلفة بين الاعتماد على حلفائها، بريطانيا بصفة رئيسة، والاعتماد على نفسها في التكفل بالمهام؛ وبين العلاقة الخاصة مع إسرائيل وفقاً لمراحل تطورها، وبصفة خاصة بعد فترة ما بين 1967 و1970، ورغبتها في إقامة علاقات طيبة في الوقت نفسه مع الدول العربية للحد من اختراقات الاتحاد السوفيتي في المنطقة؛ وبين إيران ما قبل الثورة الإسلامية والطبقة الطائفية المزدهرة من العدائيات والصراعات التي تطورت في حقبة ما بعد الثورة. فضلاً عما تقدم، أصبح الملمح العسكري للسياسة الأمريكية أكثر وضوحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مرور الوقت، على الرغم من حقيقة أن تلك المنطقة كانت دائماً مجرد إضافة ذات طابع إجرائي لمجموعة الأبعاد الاستراتيجية الحقيقية في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى.
لم تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية على نطاقها الأوسع إلا بعد انسحاب بريطانيا وجلائها من “شرق السويس” عام 1971، ثم أصبحت أهم بعد “حرب أكتوبر” 1973 في الشرق الأوسط، وبصفة خاصة بعد عام 1979 –ذلك العام الملحمي الذي كان يعجُّ بالأحداث الصاخبة المثيرة. فقد شهد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، واندلاع الثورة الإيرانية، واقتحام المسجد الحرام في مكة المكرمة من قبل متطرفين راديكاليين دينيين، وإن كان اقتحاماً مؤقتاً لكنه كان صادماً، ومن ثم الغزو السوفيتي لأفغانستان في يوم عيد الميلاد. ولم تكتسب تلك المنطقة أهمية في المقام الأول ومن الدرجة الأولى إلا بعد مجيء عهد النفط كمصدر إمداد بالطاقة بتكلفة زهيدة، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الاستدامة الحيوية لاقتصادات الدول الحليفة للولايات المتحدة في أوروبا الغربية والشرق الأقصى؛ فهي لم تكن ذات أهمية ولم تصبح ذات أولوية من الدرجة الأولى قبل عام 1979. احتلت المنطقة موقعاً محورياً في دائرة اهتمام الولايات المتحدة بعد ذلك، فأصبحت عالقة في المشجب الأمريكي، وانتهى بها الأمر إلى أن صارت محفزاً للمزيد من النشاط العسكري المحموم والمتنوع بصورة فاقت أي نشاط عسكري للولايات المتحدة في أوروبا، بل وحتى في آسيا حيث خاضت الولايات المتحدة غمار الحرب الكورية ثم حرب فيتنام. ولهواة التعبيرات الساخرة المنطوية على المفارقات، فإن هذه الأخيرة –أعني حرب فيتنام- يصعب أن يُعْلى عليها.
أما السبب الثالث لكتابة شهادة الوفاة للاستراتيجية القديمة، فيكمن في النهضة المتجسدة في العديد من قصص النجاح ذات الأوجه المتعددة، والتجليات المتنوعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ وهي نجاحات غير محسوبة على الغرب، مما يتيح للدول النامية مزيداً من الخيارات والبدائل والنماذج ومصادر العون والمؤازرة والسبل والأساليب الرامية إلى حماية الرهانات الدبلوماسية. لا توجد قصص نجاح من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، وهي صغيرة وذات طبيعة فريدة، وفي الواقع لا تصلح لأن تكون نموذجاً. بيد أن العديد من دول الشرق الأوسط يسعها أن تنظر حالياً فيما يفترض أنه نموذج صيني، لتحقيق النجاح الاقتصادي تحت سطوة القبضة الاستبدادية المتسلطة. لم يكن لهذا الخيار المتخيَّل أي وجود قبل عقدين من الزمان.
وأما السبب الرابع لموت الاستراتيجية القديمة، فهو أن النظام القديم المتمحور حول الدولة القطْرية بدأ يتوارى رويداً رويداً وبخطى وئيدة ولكنها أكيدة وبصورة حتمية، كما يبدو؛ كما بدأ يفسح المجال أمام عوامل دينامية انتقالية مفيدة وخطيرة في آن معاً؛ ولتلك العوامل، لا يوجد لدى منفذي الاستراتيجية القديمة مقابل فكري أو مؤسسي قابل للبقاء.
أما قوة الدفع الخاصة بتلك العوامل الدينامية المتنوعة والمتعددة التي لا حصر لها -والتي أطلق عليها المراقبون بنوع من التراخي والفتور مسمى “العولمة” خلال العقود الثلاثة الماضية؛ لأن تركيزها اقتصر حصراً على الجوانب الاقتصادية مع استبعاد جميع النواحي الأخرى- فلا يهم إطلاقاً أن تكون صادرة من الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر. لا غرابة البتّة؛ فهذه هي الطريقة المستديمة التي تعمل بها متناقضات النجاح، على المدى البعيد، لتقويض الظروف التي نشأت عنها تلك القوة الدافعة.
ما الذي يزعم فريق بايدن- هاريس أنهم يريدون إنقاذه؟
لأجل هذا كله، لن تتمكن إدارة بايدن- هاريس، إذا قدِّر لها أداء القسَم وتولي مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2021، من ضخ دماء الحياة من جديد في شرايين الاستراتيجية القديمة، حتى وإن كانت تلك هي رغبة الإدارة المذكورة؛ ولكن من واقع معرفتنا بطريقة تفكير تلك الإدارة في المجال السياسي، دعنا نقل: ستحاول إحياء تلك الاستراتيجية بصورة تنقصها البراعة، فقط لتكتشف أن افتراضاتها القديمة المنشرحة والمتفائلة لن تقوى على الصمود أمام واقع عالمي مختلف ومحفوف بالكثير من المكاره والمطالب الملحّة. دعنا نَرَ كيف يكون ذلك.
نعرف شيئاً عن تلك الافتراضات بفضل ما يتصف به بايدن من طبيعة متقلبة، ولأن مساعده الذي لازمه لفترة طويلة أنطوني بلينكن –وإن كان قد تسبب في تآكل تلك العلاقة بأن أصبح نائباً لوزير الخارجية في إدارة أوباما– وآخرين تحدثوا أخيراً وكتبوا عن أشياء من المأمول أن تحدث (انظر: وولتر روسيل ميد “الماضي يعصف بسياسة بايدن الخارجية” صحيفة وول ستريت جورنال، 13 يوليو/ تموز 2020، وكيرت كامبل وجيك سوليفان “منافسة بلا كارثة”: كيف يمكن لأمريكا أن تتحدى الصين وأن تتعايش معها في آن معاً”، فورين أفيرز”، سبتمبر/ أيلول-أكتوبر/ تشرين الأول 2019).
لعل أول ما يمكن المبادرة إلى تسجيله لصالح تلك الاستراتيجية القديمة أن “فريق بايدن” يفكر بلغة أهل الكفاءة والحنكة السياسية، والعارفين بأصول الحكم وذوي القدرة السياسية على إدارة شؤون الدولة –أي فن الحكم والإدارة. يشار إلى أن تعبيري “فن الحكم والإدارة” والدبلوماسية يُستخدمان في كثير من الأحيان كتعبيرين مترادفين، يحل أحدهما محل الآخر؛ وهذا غير صحيح؛ فالتعبيران غير مترادفين -ذلك أن الدبلوماسية تُعنَى فقط بالعلاقات مع الدول الأخرى. أما “فن الحكم والإدارة”، فيُعنَى بالجمع والدمج الواعي للأصول السياسية الداخلية والخارجية وصهرها في بوتقة واحدة. وبهذا يكون فن الحكم سابقاً للدبلوماسية وضرورياً لنجاحها.
لا يمكن أن تكون لدى قوة عظمى سياسة خارجية متماسكة إلا إذا كانت لديها استراتيجية –إذ إن السياسة هي أداة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. بيد أن الاستراتيجية –بدورها- تعتمد على الوضوح حيال الأهداف والمقاصد والغايات العامة عالية المستوى: ما نوعية الأمة التي ينشدها الأمريكيون في تموضعهم على خارطة العالم في الخارج، وما نوع المجتمع الذي يودون بناءه في الداخل؟ هذان السؤالان لا يمكن الفصل بينهما؛ وبالمقابل، فإن الإجابة عنهما إنما تمثل -أو ينبغي أن تمثل– الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية.
بناء على ما تقدم، تُرى ما فحوى الفكر السياسي لدى بايدن كرجل دولة يفكر بلغة الملم بأصول الحكم وفنونه؟ إنه الفكر التقليدي العتيق للحزب الديمقراطي؛ والمطبَّق يداً بيد مع التفاؤل التقليدي إزاء قدرة الأمريكيين على الفعل والإنجاز. أما أساس سياسته الداخلية، فينطوي على النص على اقتصاد سوق تحكمه ضوابط تنظيمية، وحكومة بالحجم نفسه أو بحجم أكبر (ومن ثم بتكلفة أعلى)، ومنصة تحكم سياسية تشغيلية وإجرائية تضم جميع ألوان الطيف السياسي بجميع تدرجاته لجماعات المصالح بتيار يسار الوسط أو وسط اليسار أو اليسار الأوسط بالحزب الديمقراطي.
وقد تم افتراض أن هذه المعادلة بمقدورها تحقيق نمو اقتصادي كبير، والحيلولة دون اتساع نطاق التصدعات في الحزب لئلا تغدو عصية على الإصلاح؛ وبذا تصبح المعادلة المذكورة بمثابة الأساس المحلي الداخلي للترويج للمبادئ العالمية للمفاهيم الليبرالية ونشر تلك المفاهيم في الخارج.
إلا أن هذه النسخة من المبادئ العالمية للمفاهيم الليبرالية هي نسخة ذات ثقل توازن يتصف بالواقعية –ذلك أن بايدن بصفته كاثوليكياً تلقى تعليماً كنسياً يسوعياً في المؤسسات التعليمية للرهبنة اليسوعية، يدرك أن المؤسسات العالمية متعددة الأطراف لا تنتج السلام، وإنما السلام الذي تروج له القوى ذات العقلية الليبرالية هو الذي ينتج المؤسسات متعددة الأطراف. وعلى هذا، في حين أن خياره المفضل ينصرف إلى اختيار الدبلوماسية الناعمة عوضاً عن خيارات القسر والإكراه، فقد يلجأ إلى استعراض القوة العسكرية ونشر القوات العسكرية واستخدامها عند الضرورة. هذه هي المعادلة الصحيحة -عنده- لإدخال معظم الدول الكبرى في العالم إلى بيت الطاعة وحظيرة التوافق بطريقة جيدة، وبقدر كافٍ للتماهي مع لب الأهداف الأمريكية الرئيسة.
هذا هو الأساس والجوهر: في هذا المجال من أحلام السياسة الخارجية وأشواقها، إذا أعدت بناءها، سيأتون إليك سعياً.
بعبارة أخرى، يرى بايدن أن جميع العناصر الضرورية لصوغ سياسة فعالة لمرحلة ما بعد ترمب، ظلت قائمة كما هي طوال الوقت. فالمشكلة لم تكمن في صحوة الصين؛ وهذا لم يحدث أي تغيير في السياق الاعتيادي المعهود للسياسة الدولية. وإنما كانت تكمن فقط في غياب المساندة الأمريكية التي لا مندوحة عنها لدعم النظام الذي ظلت القوة الأمريكية تتبناه، وما انفكت تثابر عليه وترعاه بعد الحرب العالمية الثانية.
أما فيما يتعلق بالفرضية المباشرة غير المعلن عنها وهي: أن السياسة الخارجية لإدارة أوباما كانت رائعة؛ لم تكن هنالك مشكلات كبرى.
وعليه تحتوي قائمة “ما ينبغي القيام به” بعد يناير (كانون الثاني) 2020 ببساطة على ما يلي: تقوية النظام الحالي للتحالفات وتعزيزه وتوسيع نطاقه عند الضرورة وبقدر الإمكان –وترتيب عناصره وتوطيد أركانه وترسيخها، وحشد موارده وتسخيرها لردع السلوكيات الشريرة، وتحفيز السلوكيات الخيرة من جانب الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، والدول الأخرى التي من المحتمل أن تكون مثيرة للمشكلات. يمكن استخدام النظام أيضاً للتصدي للتحديات العالمية التي تتجاوز قدرات النظام التقليدي المتمحور حول مركزية الدولة القطْرية وأجهزتها المركزية.
ليس هنالك أي خطأ في المقاصد في هذا المقام، بيد أن جميع الأسس المنطقية للمقاربة المطروحة من بايدن تعد مثار شك ومدار تساؤل، وتتمثل أهم الإشكاليات فيما إذا كان الأمل في إعادة المياه إلى مجاريها هو أمل ممكن وقريب المتناول بالفعل.
الأمر ليس كذلك. فالمحصلة النهائية لغياب عدو “شرير” منذ عام 1991، في أوروبا على سبيل المثال، هي ما أصاب العلاقة بين ضفتي المحيط الأطلسي من تراخ وفتور وضمور، وهذا ما لا يمكن علاجه في سياق الاتحاد الأوروبي الذي يفتقر بالفعل إلى القيادة ويظل مضطراً في الوقت الحالي لمواجهة معضلاته الوجودية. أما في آسيا، فالصين ليست أكثر ثراء وغنى وأمضى قوة فحسب، بل أيضاً ذات ذهنية مختلفة في نظرتها للعالم فيما وراء الصين؛ ومن المثير للجدل هي أيضاً وفي الوقت نفسه أقل استقراراً من حيث الوضع الداخلي. والأهم من هذا كله أن الاستراتيجية القديمة الكبرى والناجحة المتمثلة في توفير مقومات الأمن لحماية المشتركات العالمية، تقتضي توافر شرطين لتكون مستقرة على مر الزمن؛ ولا يلوح في الأفق أي احتمال لتحقق أي من هذين الشرطين.
الاستخدام ببراعة
أولاً يجب الإكثار من استخدام القوة الأمريكية، ويجب استخدامها بفعالية، لأن مصداقيتها تكون على المحك وتعتمد على الحكم الحصيف على استخدام القوة الأمريكية، وعلى القوة في حد ذاتها. ومن حين لآخر، يلزم تذكير الحلفاء والأعداء والمحايدين -على حد سواء- بأن الولايات المتحدة شديدة البأس وصعبة المراس وقوية التحمل في الميدان. ثانياً: يجب دعم السياسة الأمريكية داخلياً عن طريق البرهنة بطريقة معتمدة على أن تلك السياسة تنطوي على أغراض أخلاقية سامية المرتقى ومتسامية المبتغى. لن تنخرط أمريكا بصورة مستديمة في مواجهة الأخطار وتقديم التضحيات، لمجرد أغراض الدفاع عن النفس وتحقيق المكاسب. وهنا تكمن المشكلات الحقيقية التي تكتنف التفاؤل لدى فريق بايدن.
لم يتم إظهار القوة الأمريكية واستعراض العضلات الأمريكية بطريقة فعالة في السنوات الأخيرة. وبينما تبدو القوة العسكرية الأمريكية الضاربة مثيرة للإعجاب من الناحية النظرية وعلى الطروس والقرطاس والورق، فهي تكون أقل بصورة مضطردة عند إخضاعها للفحص الموضوعي الدقيق الذي يتم إجراؤه عن كثب؛ حيث يكون ذلك مهماً بحق وحقيقة، دعنا نقل: حول المناطق الساحلية للصين، ووثيق الصلة بحماية الممرات المائية والمعابر البحرية للاتصالات من الخليج إلى شرق آسيا. وإذا كانت البحرية الصينية لا تستطيع توفير مستوى الأمن الذي ظلت القوات الأمريكية توفره منذ أمد بعيد، فقد تكون تلك البحرية قادرة في القريب العاجل على زعزعة الأمن في الممرات المائية بين الخليج وكبار حلفاء أمريكا الآسيويين الذين يعتمدون على الطاقة وهم: اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وغيرها؛ في حين أن احتياجات الصين من الطاقة يتم توفيرها عن طريق خطوط الأنابيب الأرضية، وهي حالياً قيد الإنشاء. يمكن أن يكون هذا المستوى من الكفاءة والمقدرة كافياً للأغراض المتوخاة منه في حالة نشوب أزمة تستهدف، ضمن أشياء أخرى، تقويض أركان الوضع الأمريكي غربي المحيط الهادي، من خلال الإضرار بخطوط الاتصال بين الولايات المتحدة وحلفائها.
ومن موجبات الأسف أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تضخ استثماراً رأسمالياً بالقدر المطلوب في القوات البحرية والقوات الجوية الأمريكية، وهما الذراعان الرئيستان أو الأداتان الرئيستان للاستراتيجية الأمريكية الكبرى، المنشورة بصورة استباقية متقدمة، بينما أغدقت تلك الإدارات الأموال النقدية بسخاء على الجيش لخوض حروب برية لا طائل من ورائها في آسيا الصغرى.
سوف تجري إدارة بايدن تخفيضات ملحوظة على ميزانية الدفاع لجملة من الدواعي والأسباب الداخلية المتعلقة بالمجالات السياسية والمالية والجوانب الحساسة، ولن يكون بمقدور تلك الإدارة التعويض سريعاً عن أموال أقل عن طريق نظام تحصيلات أقل كفاءة وأكثر تأثراً بآفة المحسوبية والمحاباة، ومن شأنه الإفضاء إلى وضعيات معيبة لانتشار القوات، ويشمل ذلك الأسطولين الخامس والسابع.
أما الأعراض الجيوسياسية المرضيّة، فهي عرضة لأن تظهر من جراء أي محاولة تُقدم عليها إدارة بايدن، بعدم المضي قدماً وعدم الإقدام بجرأة وجسارة على الذهاب بأمريكا إلى حيث كانت بالفعل من قبْل، وإلى حيث وصل العالم في أثناء التراجع الأمريكي. ولأن زوال السبل والأساليب القديمة على نحو لا يمكن تداركه أو لا يمكن منع وقوعه سيظل أمراً غير معترف به، ربما للسنوات ذوات العدد، فإن أزمة للتمنيات غير المجدية والرغبات العقيمة، ستحول دون ظهور استراتيجية أمريكية كبرى جديدة وتتصف بمزيد من الفعالية؛ وستمنع تلك الاستراتيجية من أن ترى النور وتخرج إلى حيز الوجود.
قد يُلوّح لنا “غرامشي” بقبعته، ولن يكون أمامه من خيار سوى الاعتراف بقابلية مقولته للتطبيق على حالة ما، كان له أن يتخيلها بالمطلق؛ غلبة السبب الداخلي الجوهري ورجحانه.
بيد أن السبب الأكثر عمقاً والأوسع شمولاً لفناء الاستراتيجية الكبرى القديمة وذهابها أدراج الرياح، هو السبب الجوهري الداخلي الذاتي الصميم؛ الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
فأمريكا هي “الأمّة التي تحيا بروح الكنيسة” كما أورد “جي كيه تشسترتون (G.K. Chesterton)” حسب العبارة التي صكّها، وهي –أي أمريكا- في مزاج آخر من أمزجتها المنطوية على إنكار الذات أو الإنكار الذاتي (Self-Deprecatory Moods). وكما ورد آنفاً -ولكنه أمر حقيق بالتكرار وحري بالترديد هنا لأهميته القصوى– لن تستطيع أمريكا أن تحتفظ لنفسها بدور عالمي بنّاء وفعال ما لم تستصحب فضيلتها ومأثرتها الداخلية المتمثلة في استثنائيتها، فتصبح نبراساً ومصباحاً ينير طريقها إلى رحاب العالم في نطاقه الأوسع.
أما العمل الدفاعي المتواصل والمزايا التجارية، فلن تكفي لتحقيق أمن بطريقة خارقة للعادة في “جزيرة عالم أو في عالم على هيئة جزيرة” بأطراف مترامية ومساحات شاسعة وثروات هائلة. لابد أن تكون هنالك مثل عليا وأغراض أخلاقية سامية؛ وهذا هو ضرب من ضروب القصص التقليدية التي تنشرح لها أسارير الأمريكيين، ويظل الأمريكيون يتوقون لها ويبدون الرغبة والاستعداد للتضحية وخوض غمار الأخطار لأجلها.
غير أنه لم تصدر أي لغة استثنائية ولم يبدر أي كلام عن الاستثنائية من البيت الأبيض لما لا يقل عن اثني عشر عاماً. فقد أحجم باراك أوباما عن تأكيدها بينما درج ترمب على الانتقاص منها وهو لا يلوي على شيء، وإن كان ذلك بلهجة عدائية.
يعاني الأمريكيون إذاً من انقسام حاد لدرجة أنه أصبح من الواضح أنه لا يوجد هدف عام يجمع بينهم للحياة معاً في كنف مجتمع سياسي واحد؛ ويمكن المجادلة بأن هذا يحدث لأول مرة في التاريخ الأمريكي، حتى بما في ذلك سنوات الحرب الأهلية. لقد ظل إحساس الأمريكيين برباط الوحدة وروح الشعب الواحد إحساساً تقدمياً على الدوام، وقوامه النظر إلى الأمام والتطلع إلى المستقبل، وكان يتعلق دائماً بما سنقوم به وما سنقوم ببنائه سوياً على قلب رجل واحد؛ كما كان يتعلق بالكيفية والطريقة التي نحدد بها جبهتنا التالية ووجهتنا القادمة. لم تعد مثل هذه الروح واضحة في يوم الناس هذا، في غمرة الجلبة والضوضاء والأصوات النشاز المنطوية على إطلاق الاتهامات جزافاً بسوء الطوية وبالنيّة غير السليمة.
سيكون من المفيد -لنا في أمريكا- أن نتخلص -بادئ ذي بدء- من بعض التوضيحات العامة التي لا تقوى على الصمود أمام التمحيص والتدقيق الجاد، وأن نستغني عنها. فكثيراً ما يسمع أحدنا -على سبيل المثال- أن الأمريكيين يشعرون بالخجل من الاضطلاع بدور عالمي فعال بسبب النوازل والمشاكل الاقتصادية؛ والإحساس بأنه لم يعد بمقدورنا أن نتحمل تبعات دورنا المتعاظم، وأنه توجد لدينا مشاكل كثيرة جداً في الداخل من الأحرى أن نلتفت إليها ونتعامل معها.
يرى كثيرون هذا الرأي بالفعل؛ ولكن هذا رأي غير صحيح: ذلك أن إنفاق أموال طائلة لدعم استمرارية استراتيجية عالمية ولاستدامتها -كما هو الحال سابقاً- من شأنه تمكين الولايات المتحدة من أن تكون فعالة ومفيدة لنفسها ولغيرها في آنٍ معاً.
ليس لدينا بنية تحتية متهالكة ومدارس ضعيفة المستوى وبرامج رعاية صحية باهظة التكلفة وسيئة الأداء؛ لأنه توجد لدينا قوات في ألمانيا أو قاعدة جوية في قطر على سبيل المثال. هذا محض هراء وهذه حسابات موغلة في الخطأ.
يشير البعض إلى أن “الحروب التي لا نهاية لها” بالشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، ويستدلون بها كعامل مؤثر في الإعياء والفتور الذي أصاب النزعة العالمية لدى الأمريكيين. يرى الكثيرون أن هذا صحيح.
إلا أن تلك الحروب في حقيقة الأمر ليست حروباً لا نهاية لها. كل ما في الأمر أن الأمريكيين كانوا أقل صبراً مما اعتادوا عليه وعرف عنهم؛ ويعزى ذلك إلى أسباب ثقافية. أيضاً لم تكن تلك الحروب وعمليات الانتشار التكتيكية أو الدبلوماسية الصغيرة المرتبطة بها، كما حدث في سوريا، قد أسفرت بصفة خاصة عن خسائر في أرواح الأمريكيين؛ وإنما لم يكن الانتصار في الحروب آنفة الذكر كاملاً وواضحاً (العراق وأفغانستان مثلاً) أو أُسيء فهمها ابتداءً، مما زاد الأمر ضغثاً على إبالة (كما في العراق أيضاً وليبيا)؛ كما أن القادة والزعماء الأمريكيين في الحزبين أخفقوا في الإفصاح عن أغراضهم وأهدافهم، في سياق وبأسلوب يرى فيهما الشعب مصداقية ومدعاة للقناعة. لقد كان من الممكن للأمريكيين أن يخوضوا غمار الحرب العالمية الثانية لمدة أربعة عشر عاماً بدلاً عن أربعة أعوام إذا كان ذلك ضرورياً؛ لأنهم كانوا على إدراك بالمحاذير الأخلاقية والأخطار العملية ذات العلاقة. لقد أسهم الإخفاق العريض للقيادة السياسية -وليس الفشل الطفيف للحروب على النحو المذكور أعلاه– في إشاعة الشعور بالخيبة والإحباط والكآبة والغم.
من الواضح أن الأمة ترزح تحت نير حالة من التراخي والركود وفتور الهمة. ولما كانت السياسة الخارجية تمثل انعكاساً للسياسة والثقافة في الداخل، كان لابد لهذا أن يؤثر في النظام السياسي -ولا سيما إذا كان نظاماً صاخباً مفعماً بالجلبة والضوضاء- وأن يؤثر في جسم سياسي مليء بالثقوب والمسام كما هو الشأن في الولايات المتحدة. لقد مررنا بهذه التجربة من قبل. ولعل البعض ما زالت تعشش لديهم ذكريات الحقبة “الكئيبة” للرئيس كارتر في أواخر سبعينيات القرن الماضي. كذلك، تصدر أمريكا حمماً عاتية من المقذوفات البركانية العالية من عدم العقلانية وغياب الواقعية لدى طرفي النقيض السياسي على حد سواء؛ إلا أن هذا أيضاً ليس بالأمر الجديد: لعل البعض يتذكرون الفترة بين 1968 و1970؛ ويتذكرون بالمثل كيف أن الأمة لم تتمكن من التخلص بالفعل من تبعات مزاجها السيئ ولم تنفض عنها غبار الكآبة وفتور الهمة، وتنهض من كبوتها وتستعيد زمام المبادرة والعمل مرة أخرى، إلا في أوائل ثمانينيات القرن الفائت. فالحقب التاريخية المتعاقبة لا تعمل على غرار مفاتيح الإضاءة؛ إنها تستغرق وقتاً لكي تصول وتجول عبر دروب الحياة السياسية.
من الوارد إذاً -وعلى الأرجح– أنه لن تظهر استراتيجية كبرى جديدة، وتتبدى عياناً بياناً وتكون جاهزة للاستخدام في تحقيق الأغراض العملية، إلا بعد أن تنتهي الفترة “الغرامشية” الحالية وتفسح المجال أمام الأمريكيين ليعيدوا اكتشاف أنفسهم من جديد على افتراض أن ذلك سيحدث بالفعل. أما كيف سيبدو ذلك، فهذا ما لا يمكن التنبؤ به في غياب المعرفة الكلية والإحاطة الشاملة بالظروف المستقبلية، التي ستتشكل حتماً وتتحدد ملامحها وترتسم حدودها الخاصة بها لا محالة. عفواً: أنا محلل ولست متنبِّئاً.
أما مغزى ما تقدم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو واضح تماماً ومباشر؛ ولكنه ليس مشجعاً: لن يكون هنالك منطق استراتيجي يحكم السلوك الأمريكي في المنطقة ويقوده. وحتى لو كان الخبراء في الحكومة يدركون ما يحدث ويعرفون مجريات الأمور ويبدون الاهتمام اللازم على المستوى المهني، لن يعني هذا أن القادة السياسيين سوف يصغون إليهم أو يأبهون أو يعبؤون ويكترثون بهم. وعليه سيتعامل القادة الأمريكيون على مختلف مستوياتهم بطريقة رد الفعل في قراراتهم ودوافعهم السياسية؛ كما أن سلوكهم عند النظر إليه برمَّته، قد يبدو غير متسق وعشوائياً وجزافياً ولا يمكن التكهن به؛ وسيكون كذلك بالفعل في المرة القادمة.
ماذا لو أن شيئاً، أي شيء، أصبح مختلفاً بشأن السياق الذي يحدث فيه الابتئاس والاستياء وعدم العقلانية في هذا الوقت؟ إن حصول ذلك بطريقة مباشرة هو الطريقة الوحيدة لتحليل الكيفية التي تنتهجها الولايات المتحدة لتعيد اكتشاف نفسها مجدداً، وتخرج أكثر قوة ومنعة وأعظم قدْراً وأشد بأساً من أي وقت مضى. وعلى هذا ففي حالة عدم جدوى السطحية وخدمة الذات في تفسير ما حدث من أخطاء، ما هو -إذن- السبب الحقيقي للغيبوبة الحالية للروح الوطنية الأمريكية ولغيابها؟
الصبر فضيلة. يلزم التحلي بفضيلة الصبر. كل شيء سيتكشَّف ويتبدَّى في المرة القادمة.