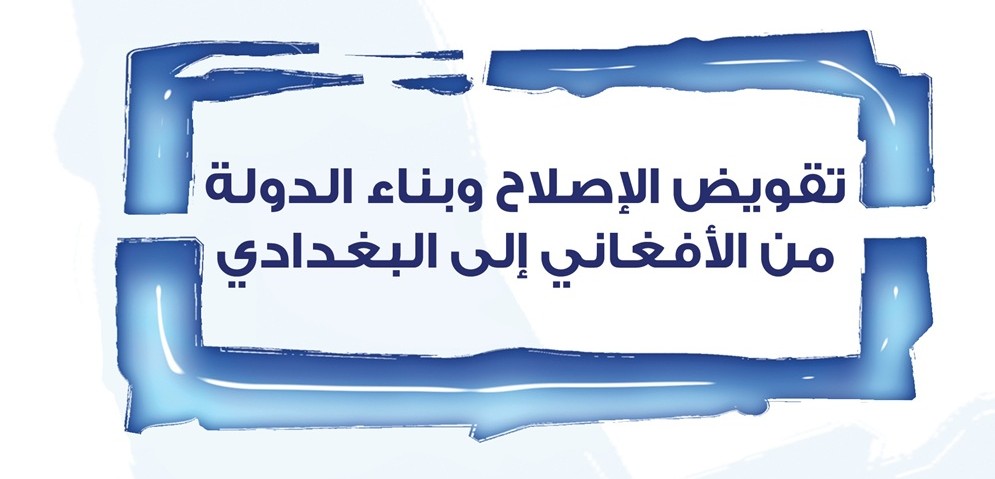لفرط تدليل أو قمع، هزال أو جبن، لم يكن خليقا بأن يكون مجرما. لكن نفسه كانت تحدثه دائما بالرغبة في الجريمة، وتدفعه إليها. فأطاعها. وها هو اليوم يقف أمام عواقب فعله، شاحبا، خائفا. لا ندما على الجريمة. بل هلعا من ساعة المسؤولية. المشهد الذي ما كان ليفكر في جريمة لو مر به طيفه. و….
بمجرد سقوط البعث العربي الاشتراكي، بعد غزو الكويت، كانت الفرصة سانحة لبعث جديد، يشارك البعث القيم “الوحدوية التوسعية” نفسها، مع اختلاف بسيط. استبدل البعث الجديد براية العروبية التوسعية، راية الإسلام السني التوسعي. وهو تحول سبق إليه الشق الشيعي من العروبيين واليساريين العرب بالتحاقهم بإيران.
الجيل الجديد لهذا “البعث الإسلامي الاشتراكي” نشأ على كتابات الإعجاب بإيران. الناصريون مثل محمد حسنين هيكل وجدوا فيها نكاية في السادات، والاشتراكيون الثوريون رأوا فيها أملا تغنوا به، “إيران يا مصر زَيِّنا، كان عندهم ما عندنا”، تقول كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان الشيخ إمام. والإسلاميون، مثل فهمي هويدي، وجدوا فيه ضالتهم.
كان سهلا ترويج هذا البعث الشيعي الاشتراكي شعبيا، ممهدا لنظيره السني. كتابات التراث التاريخي السني المكتوبة غالبا في العصر العباسي الهاشمي، قدمت رغبة الشيعة في توريث العرش في نسل إمام الشيعة الأول، علي بن أبي طالب، على أنه “ثورة من أجل الحق”، بينما قدمت توريث الحكم في بني أمية على أنه الظلم البين.
والنتيجة أن الناس اشترت الحزمة كاملة. ليس مصرحا لأحد أن يقول: إن فعل بني أمية كان أقل ضررا من فعل أبناء علي لو تم. لأن فعل بني أمية من أمور الدنيا والسياسة، في زمن كان توريث الحكم شائعا.
أما أبناء علي فأرادوا أن يجعلوا الجمع بين الحكم و”الإمامة الدينية” دينا لازما، وأن يختصروا القيادة الدينية والزمانية في نسل واحد.
وكيف يمكن لأحد أن يصرح برأي كهذا وقد تحصن الفقه العباسي من النقد؟ وتحصن الصحابة، حتى في أفعالهم السياسية، من النقد؟ فسرح الإسلاميون ومرحوا في حياتنا الثقافية. يقدمون “الأدلة” التي تحكم حياتنا. ولا يستطيع غيرهم أن يعترض.
سار الكتاب والمثقفون في هذا الاتجاه. المسرحي يكتب “الحسين ثائرا”، والمثقف ينحاز إلى علي وأبنائه في “الفتنة الكبرى”.
ينحاز -دون أن يدري- إلى الجمع بين الحكم والنبوة.
ينحاز -دون أن يدري- إلى ما رفضه اليهود منذ آلاف السنين، وما رفضه الصحابة أنفسهم لحظة وفاة النبي.
لكن هذا هو الاتجاه الوحيد المسموح، حتى للمنتقد، أن يسير عليه. لا بد في النهاية أن يخلص إلى أن عليا الفقير، البليغ، وابنه الحسين، كانا -لا شك- على الحق.
أحب اليسار العربي أن يرى نفسه في هذه القصة، وأن يتمثل بـ”شهيد كربلاء”. وورثت هذه الأمة تغليب المشاعر على الحكم السياسي العقلاني. وورثت تقديس المعارضة لمجرد أنها معارضة. ورثته من الفقه العباسي، نعم، لكن المفاجأة أنها ورثته أيضا من كتابات المثقفين العلمانيين في العصر الحديث.
كانت كل الظروف معدة -إذن- بمجرد سقوط البعث العربي الاشتراكي، أن ينشأ البعث الإسلامي الاشتراكي. لكن بمن يلتحق هذا البعث؟ نعلم أنه التحق “شعوريا” بإيران، وبحزب الله. نعلم أنه غنى لهما، وتظاهر من أجلهما. نعلم أنه سلمهما بيروت، ولم ينزعج من تحكمهما في دمشق، وحين سقطت بغداد في تلك القبضة لم يفهم الخطر. لقد رأى العمامة السوداء المتمددة فوق رأس الخليج غيمة “محملة بالمطر”، بالخير، والفرج. الأفكار المغروسة داخلنا تخدع حواسنا. هذه حقيقة علمية.
منذ منتصف التسعينيات، وبعد زلزال الغزو العراقي للكويت، كانت دويلة صغيرة في قلب جزيرة العرب تقدم إعلامها وإمكاناتها المادية لخدمة هذا “البعث الإسلامي الاشتراكي”. حولت الإخوانجي يوسف القرضاوي إلى نسخة سنية من الخميني. وصارت مصدرا مغريا لتمويل مشاريع الإعلام، والجمعيات الأهلية “الحقوقية”.
الحلف الوليد كان يجهز جيشه المسلح لكي يلتزم الحرب الاستراتيجية، فلا يستنزف قواه في معارك جانبية، بل يتحرك بأمر قيادة موحدة، في اللحظة المناسبة.
في هذا الإطار أطلق الجهاديون المصريون عام ١٩٩٧ مبادرة وقف العنف. وكمنوا حتى ٢٠١١. وفي هذا الإطار نشأت “الجبهة الإسلامية للجهاد” ضد اليهود والصليبيين. لاحظ تشابه التسمية بينها وبين “الجبهة الشعبية لتحرير” فلسطين. الكلمات الثلاث الأولى مجرد تغيير إلى المفردات الإسلامية. تغيير يبلور بالضبط ما حدث من انتقال فكرة البعث العربي الاشتراكي إلى البعث الإسلامي الاشتراكي. لكن الخطف واحد، والعنف واحد، وإن كان أكثر دموية.
لم نجب. بمن يلتحق هذا البعث؟
لم يعد صدام حسين بعد غزو الكويت زعيما. والبعث السوري التحق بإيران. ومصر الرسمية لم تعد ترفع شعارات ناصرية. والجزائر غرقت في صدام بين جبهة الرفض القديمة وجبهة الرفض الجديدة. ربما تعجل الشاذلي بن جديد في محاولته تسليم الراية من الثورية العسكرية إلى الثورية الإسلامية.
بمن يلتحق هذا البعث؟
عام ٢٠٠٢ وصل إلى الحكم في أنقرة عمدة الأستانة: رجب طيب أردوغان. سياسي طموح قدمه الإسلاميون على أنه النموذج الجديد للإسلام السياسي، السني، العصري، لكن أيضا الإمبراطوري. السياسي الطموح لم يُضِع وقتا على الإطلاق. بل سعى مباشرة إلى مد نفوذه إلى المنطقة.
لكي يفعل هذا كان عليه أن يقدم نفسه بوصفه المتحدث باسم “المسلمين السنة”. وليس هذا ممكنا إلا باستحقاقين. أولهما: أن يثبت أن القوى التقليدية لم تعد تصلح.
ربما لو رأيت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في هذا السياق لرأيتها بعين مختلفة. لن يصير اختيار إرهابيين يحملون الجنسية السعودية، تحت قيادة شخص يحمل الجنسية المصرية، لتنفيذ تلك الهجمات، مجرد صدفة. كما لن يعود تركيز الهجمات على القاعدة العسكرية الأمريكية في السعودية، حتى تنتقل إلى قطر، مجرد صدفة. ولم يكن تقديم السعودية بوصفها راعية للإرهاب وسببا له إلا عملا منظما قاده البعث الإسلامي الاشتراكي، بتعمد. بالعربية سموا الإرهاب مقاومة ولم يمنحوا السعودية شرف رعايته. وبالإنجليزية سموه إرهابا وحملوا السعودية وزر انتشاره.
هذا غرض استراتيجي. تخريب العلاقات السعودية- الأمريكية. وتقديم تركيا إلى الرأي العام العالمي على أنها البلد الإسلامي الذي يجب تلميعه، والنموذج الإسلامي الذي يجب إبرازه. وكان هذا من مصلحة إيران وقتها. لأنها ستكسب مكاسب جانبية من إضعاف السعودية، منافسها الأهم.
حتى ذلك الوقت، كان المجرم الشاحب، الذي يوفر البوق العربي لطموح الحلف العثماني، ويقدم الأموال والرعاية الروحية، لا يحظى بما يستحق من القلق. فهو شاحب، صغير، متلون. كما أن التيار الصحوي العثماني في السعودية، والإخوان العثمانيين في مصر، قاموا بالواجب في حماية أغراضه. حتى حين تضاربت مصالح بلادهم الوطنية مع مصالح الحلف. لقد توغلوا في الإعلام، وسيطروا على المساجد، وتسللوا إلى النخبة.
لكن هذا لم يكن ليستمر طويلا. لقد حان وقت الاستحقاق الثاني من الحلف العثماني لكي يحل محل القوى التقليدية في المنطقة، أن يثبت أنه ممثل القوى الفاعلة في عواصم القضايا الساخنة.
في المقالات القادمة ننتقل إلى عواصم القضايا الساخنة تلك، لنرى ماذا فعل المجرم الشاحب فيها. لكن -أيضا- لنرى إلى أي خانة في رقعة الشطرنج وصل. وما هي خياراته الآن.
“كنت أريد أن يسيطر عليهم الجنون الذي يقضي عليهم كما قضى على هذا المجرم الشاحب”. هكذا تحدث زرادشت.