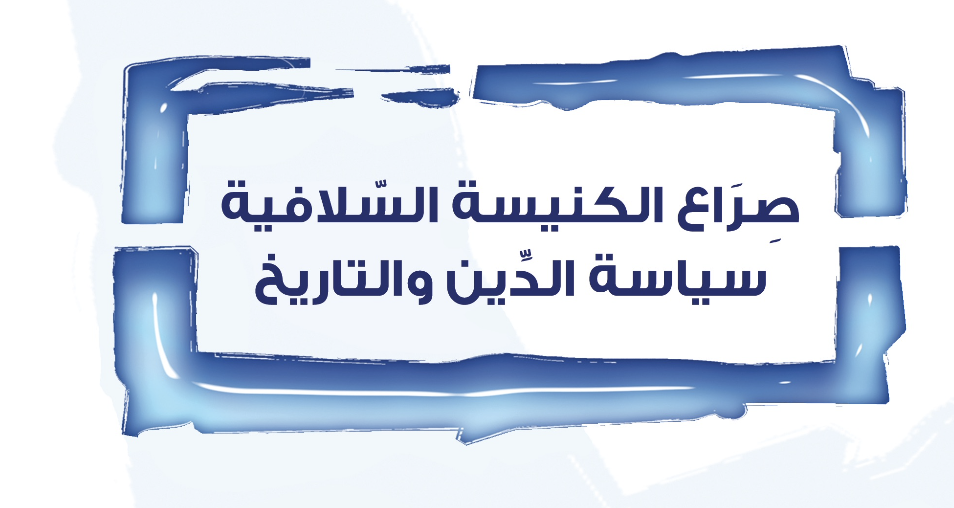تقديم
تقديم
يتناول مركز المسبار للدراسات والبحوث في كتابه المعنون: «الكنيسة الروسية، سجالات التاريخ» (الكتاب الخامس بعد المئتين، يناير (كانون الثاني) 2024)، السّجالات حول تاريخ الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، بدايةً من العلاقة بين الكنيسة والدولة في روسيا بين (1700-1917)، وتحديات الكنيسة بعد إصلاحات بطرس الأكبر التي أدخلت قيمًا غربية غريبة عن التقاليد الروسية. تطرّق إلى انقسام المسيحية الروسية بعد حقبة رومانوف وانبثاق طوائف مثل المؤمنين القدامى رافضي التحديث. وعرض لعلاقة الكنيسة باليهود منذ 1721، ودورها في مرسوم التسامح 1905. سلّط الضوء على نظرية «موسكو روما الثالثة» بعد سقوط القسطنطينية واعتبار روسيا وريثة البيزنطية وحامية للأرثوذكسية، وآثار ذلك على السياسة الخارجية.
فاتحة دراسات العدد، تناولت العلاقة بين الكنيسة والدولة بين سنتي (1700-1917)، على مدار التاريخ، فسلّط المؤرخ الضوء على تطور العلاقة بين الكنيسة الروسية والدولة منذ حقبة الإمبراطور بطرس الأكبر (1689-1725) مؤسس الإمبراطورية الروسية سنة 1721، حتى أسرة رومانوف (Romanov) (1613-1917).
تناولت الدراسة التحديات الداخلية التي واجهتها الكنيسة الروسية في رعاية الشعب الروسي بعد إصلاحات بطرس الأكبر (1672-1725) في القرن الثامن عشر. فقبل تلك الإصلاحات، كانت الحياة الأسرية والاجتماعية والدولة خاضعة لأنظمة الكنيسة، واستندت النظرة العالمية للروس على تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية. لكنّ الإصلاحات قوّضت جزئيًّا الأسس التقليدية للمجتمع الروسي؛ إذ أدخلت قيمًا وأفكارًا وصفت بالغربيّة وبدت غريبة عن التقاليد، أدّت إلى قسم المجتمع؛ وتعميق الفروق بين طبقاته المنفصلة ذات الحقوق والواجبات غير المتكافئة، وأفرزت تحديًا للكنيسة يستدعي تأهيل رجال الدين لمواجهته.
شكّل بطرس الأكبر سنة 1721 مجلس سينودس يديره رجل دين موالٍ للإمبراطورية، وجعل الإمبراطور رأسًا للكنيسة التي تحولت إلى جهاز من أجهزة الدولة، مما أثار المعارضة داخل الكنيسة ورفضًا لعمليات التحديث الأوروبية.
أثّرت تبعية الكنيسة للدولة على شعبيتها، حيث عدّها المعارضون أداة طيّعة بيد الدولة. أدى صمت الكنيسة تجاه القنانة، إلى اعتبار الدوائر الليبرالية إياها شريكةً للدولة في عيوب النظام الاجتماعي والسياسي. وسرعان ما تحوّل النقد الليبرالي للكنيسة من اتهامها بالمحافظة، إلى اتهامها بالرجعية ودعم الاستبداد، وصولًا إلى انتشار الأفكار المعادية للدين.
وقد مهّدت هذه التحولات في نهاية المطاف للثورة الروسية في أوائل القرن العشرين؛ إذ قوّض حرمان الفلاحين من حقوقهم سنة 1870، الأسس الأخلاقية للبنية الاجتماعية، لا سيما أنهم يشكلون ما يربو على (75%) من السكان، ولم يكن من السهل على الكنيسة إدراك ذلك قبل الثورة (1905-1906)؛ إذ أدخلت المزيد من الفوضى، ففي 1906 لاحظت لجنة امتحانات القبول في أكاديمية موسكو أن خريجي المدارس اللاهوتية لديهم جهل تام بتاريخ الكنيسة والأدب الروحي الآخر، وبقدر ما أدت استعادة بطرس الأكبر للكنيسة إلى مواءمتها مع الدولة، فإنّ بطء التعليم والاستيعاب أدى إلى فقدانها للموثوقية إلى حدٍ كبير، ولكنها لم تفقد وجهها المشرق بالكليّة، ولا الأمل في انتظار الإصلاحات الداخلية التي تواترت في العقود التالية؛ بعد إدراك الروس قيمتها.
عرض الباحث الأوكراني أندريه ميخالايكو (Andriy Mykhaleyko) (Андрій Михалейко) للسجالات الدينية بين كييف وموسكو، حول انتشار المسيحية في المنطقة السلافية الشرقية، والتطوّر الكنسي التاريخي للمناطق السلافية الشرقية بعد انهيار دولة كييف [كييف- روس] التاريخية. يبني الباحث نظريته حول الصراع بين كييف وموسكو، على الشرعية لأسباب سياسية، معتبرًا أنّ الاختلاف بين المؤرخين محدود، ويمكن بسهولة تبيان حقيقته، وهو ما عُنيَ بشرحه. مشيرًا إلى اعتناق السلاف الشرقيين للمسيحية زمن الأمير فلاديمير الأول، ثم يمرّ على المتغيرات الطارئة على النظام السياسي بعد الغزو المغولي، ووقوع أوكرانيا تحت الحكم البولندي -الليتواني، والفوارق السياسية والدينية، الجوهرية، بين الثقافتين، مع الحكم الروسي، والآثار المترتبة على سقوط القسطنطينية سنة 1453، وكيف فسّرت الكنيسة الروسية هذا الحدث، وتبنّيها لمصطلحات جديدة تبدو مغرقة في الغيبية، مقابل الحوارات والسجالات التي انخرط فيها الأوكرانيون مع بقية الطوائف الأخرى، في ظل الانفتاح الذي تميّز به الكومنولث البولندي -الليتواني. ثم يناقش الباحث المفاهيم الدينية الروسية، وانعكاسها على السياسة، وانتقاداته عليها، مجسّدًا الانقسام.
تناولت الباحثة يلينا بافلوفنا شيمياكينا (Елена Павловна Шемякина) (Elena Pavlovna Shemyakina) والباحث إيلين نيقولايفيتش فسيفولود (Ильин Николаевич Всеволод) (Ilyin Nikolaevich Vsevolod)، بشيء من التفصيل، آثار عملية التحديث الكنسي ودوافعها، وما أدّت إليه من انقسامات؛ إذ مرّت المسيحية الروسية بمراحل عدة منذ اعتناق الروس إياها نهاية القرن العاشر الميلادي، لكنّ حقبة أسرة رومانوف، التي بدأت مع ميخائيل فيدوروفيتش رومانوف (Mikhail Fyodorovich Romanov) (1613-1645)، وما أعقبها من فتوحات وتوسعات كبرى، فرضت على الأباطرة الروس، تبنّي قيم مسيحية بدت غريبة عمّا تعوّد عليه الروس في ظل روسيا القيصرية، لتعزيز مكانة البلاد السياسية، ومراعاة ثقافات الشعوب الجديدة المنضوية تحت مظلتها. اعتبر العديد من الروس هذه التحديثات «خروجًا» على الإيمان الحقيقي، واتّباعًا لهرطقات بأوامر من الأباطرة أو البطاركة «الضالّين»، وعليه انقسمت الأرثوذكسية الروسية إلى طوائف عدة، أبرزها طائفة المؤمنين القدامى، الذين حافظوا على الطابع الموسكوفي لروسيا القيصرية، والطائفة العامة المتّبعة للكنيسة الرسمية. خلق هذا الوضع حالة من النزاع بين الطرفين وأتباعهما، مع استثناءات بسيطة حدث فيها التحالف لمواجهة الكاثوليك أو البروتستانت، وصولاً لتفرّق طائفة المؤمنين القدامى في (17) دولة حول العالم.
تقدّم الدراسة شرحًا وافيًا للدوافع خلف هذا الانقسام، وعلى رأسه الجانب السياسي، والأبعاد القومية لرافضي الطقوس الجديدة، وما تسمّيه عملية «التضحية» بالطقوس الروسية القومية لصالح الطقوس اليونانية العالمية، لنيل روسيا مكانة الزعامة الأرثوذكسية. امتدّ هذا النزاع إلى ما هو أبعد من الدين ليشكّل الهوية السياسية لأهم فريقين ما زالا متصارعيْن حتى الآن في الداخل الروسي، وهو ما توضّحه الدراسة في نهايتها.
في ظلّ محاولة قبول الآخر، ورصد فشل الإصلاحات في دفعه، وتبنيه، تناول المؤرخ الروسي ڤلاديمير بولداكوڤ (Владимир Прохорович Булдаков) (Vladimir Prokhorovich Buldakov) علاقة الكنيسة باليهود خلال الفترة الممتدة بين سنتي (1721-1917). إذ تُعدّ سنة 1721 سنة التحولات الكبرى في التاريخ الروسي، حيث شهدت إعلان بطرس الأكبر، أول أباطرة روسيا، قيام الإمبراطورية الروسية، وتحوّل روسيا القيصرية إلى روسيا الإمبراطورية، وإنهاء منصب بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وتحويلها إلى الكنيسة الأرثوذكسية للإمبراطورية الروسية. أدّى هذا التحول، من ضمن مسائل أخرى، إلى أن تصبح الكنيسة تحت سلطة الدولة بشكل كامل، وتبنّيها مواقف دينية غير معهودة في تاريخها، ومن ضمنها الموقف السلبي تجاه اليهود، ودور هذه السياسة في صدور مرسوم التسامح الديني لسنة 1905. تاريخيًّا، لم يكن لدى الروس بعد اعتناقهم المسيحية المشكلة نفسها، الموجودة في أوروبا مع اليهود، لكنّ هذا الوضع تغيّر بدءًا من منتصف القرن السادس عشر، مع تفاقم الاضطهاد في الإمبراطورية الروسية. بعد ثورة 1917، استخدم طرفا النزاع على السلطة: البيض الموالون للإمبراطورية والحمر البلاشفة، هذا الإرث للطعن في الآخر، واتهامه باليهودية أو الانقياد لرغبات اليهود.
تناولت الباحثة الروسية وعميدة كلية التاريخ في جامعة تفير الحكومية، تاتيانا ليونتييفا (Tatiana Leontieva) (Татьяна Леонтьева) العلاقة بين الدولة والكنيسة في الإمبراطورية الروسية، وانعكاس ذلك على الطوائف المسيحية الأخرى، بعد الانشقاق العظيم سنة 1054، والرؤية الروسية حول استخدام العامل الديني من قبل الغرب، لخدمة أغراض سياسية، تهدف إلى إضعاف روسيا، وتدلّل على ذلك بعدد من المواقف التاريخية، وتقارنها بالسياسة الروسية، التي كانت ردّ فعلها -بحسب الباحثة- على هذه المحاولات أكثر من كونها أداة فعل مبادِرة.
ألقت الباحثة الضوء على علاقة الدولة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية بالكاثوليك والبروتستانت خلال الحقبة الإمبراطورية. وأوضحت أن العلاقات كانت متوترة بسبب الانشقاق بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية سنة 1054، وأن روسيا اتّبعت سياسة طائفية تجاه الأقليات الدينية تماشت مع الاتجاهات الأوروبية. وأن سياسة روسيا الطائفية شهدت تغيرات بين التسامح والتمييز حسب الظروف السياسية والاجتماعية. وتعرض الكاثوليك للضغوط بعد انضمام بولندا لروسيا بسبب دعم الكهنة للحركة البولندية المناهضة لروسيا. أما اللوثريون الروس فلم يواجهوا مشاكل كبيرة قبل الحرب العالمية الأولى؛ حيث تعرضوا للقمع باعتبارهم مؤيدين لألمانيا. ساهمت الكنيسة الأرثوذكسية في الدعاية ضد اللوثريين واعتبارهم أعداء للشعب الروسي. بعد ثورة 1905 وإعلان حرية الأديان، تحسّنت أوضاع الكاثوليك واللوثريين لكن دون المساواة التامة مع الأرثوذكس. وبعد سقوط الحكم المطلق سنة 1917 تخفف الضغط عليهم برغم استمرار عدم الثقة الشعبية بهم.
أما وجه النجاح، فكان في تعميم سردية دينية عميقة؛ قابلة لشحذ الإيمان، تناولها الباحث الروسي باڤل كوزينكوڤ (Павел Кузенков) (Pavel Kuzenkov) في دراسته المعنونة «موسكو- روسيا.. خليفة البيزنطية ونشأة معقل الأرثوذكسية الجديد»، تطرّق فيها لعلاقة الكنيسة مع الإمبراطورية، التي نشأت بين الطرفين منذ تبنّي الإمبراطورية الرومانية، وعاصمتها روما، المسيحية، ووريثتها الإمبراطورية الرومانية الشرقية «بيزنطة»، وعاصمتها القسطنطينية، ومركزية فكرة الإمبراطورية الراعية للدين والكنيسة في الفكر المسيحي، وانتقاله إلى روسيا، بعد سقوط القسطنطينية، والذي أدّى لظهور مصطلح «موسكو – روما الثالثة» بوصفها وريثًا شرعيًا ووحيدًا لهذا التتابع الإمبراطوري، والدولة العالمية الأخيرة التي ستشهد المجيء الثاني للمسيح.
استغلت النظرية، انتشار فكرة نهاية العالم بعد (6000) سنة من الخليقة حسب تقويم الترجمة السبعينية للكتاب المقدس، وستكون متزامنة مع عودة المسيح الثانية؛ حسبما شاع في القرن الخامس الميلادي. ربما كان هذا الاعتقاد مستمدًا من ربط فترة الـ(6000) سنة بفترة الستة أيام الخلق في سفر التكوين، وارتبط هذا بما اعتبره بعض اللاهوتيين من أن الإمبراطور الروماني هو «الكاتيخون» أو الحاجز الذي يمنع ظهور؛ الدّجال.
ساد هذا الاعتقاد بشكل خاص بعد سقوط القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية سنة 1453 على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، مما جعل موسكو تصبح المركز الرئيس للمسيحية الأرثوذكسية، خصوصًا بعد استقلال الكنيسة الروسية عن بطريركية القسطنطينية سنة 1448 باختيار الميتروبوليت الروسي يونا. وفي 1492، العام 7000 حسب التقويم البيزنطي، كتب الراهب الروسي فيلوفي رسالة وصف فيها موسكو بأنها «روما الثالثة» بعد روما وقسطنطين، المحافظة على المسيحية الأرثوذكسية وقيمها الأخلاقية بعد أن فقدت روما وقسطنطين دورهما.
على الرغم من أن هذه الفكرة لم تكن رسمية في البداية، فإن البطريرك القسطنطيني إريميا الثاني أقرها سنة 1589 عند تنصيبه لأول بطريرك روسي، ناظرًا إلى روسيا كحامية روحية للمسيحية الأرثوذكسية، متوجة بذلك جهود حكامها الأقوياء مثل إيفان الثالث وفاسيلي الثالث في توحيد البلاد تحت لواء موسكو وآبائها الكنسيين البارزين أمثال أوغسطينوس، ويوحنا الذهبي الفم، لكن دون المطالبة بأي حقوق سياسية على أراضي الإمبراطورية البيزنطية السابقة.
في الختام، يتوجّه مركز المسبار للدراسات والبحوث بالشكر للباحثين المشاركين في الكتاب والعاملين على إخراجه للنور، والشكر موصول للزميل رشيد الخيون صاحب فكرة هذا العدد، وللزميل أحمد لطفي دهشان الذي نسقه، ونأمل أن يسدّ هذا الكتاب ثغرة في المكتبة العربية.
رئيس التحرير
عمر البشير الترابي
يناير (كانون الثاني) 2024