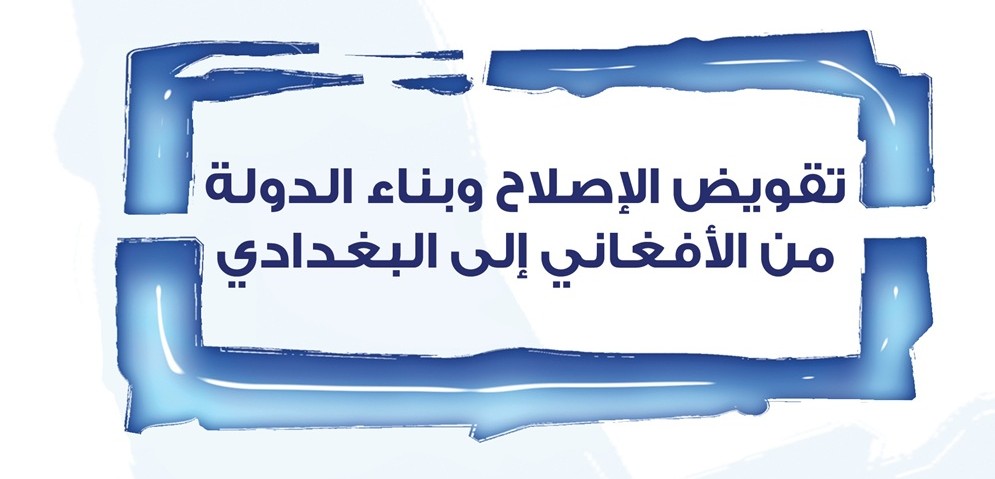بيتر عادل سليمان[1]*
“صلوا بلا انقطاع”[2]، هذه الوصية القصيرة والمشدَدة التي أوصى بها الرسول بولس أهل تسالونيكي، أثرت تأثيرًا حاسمًا على روح الرهبنة الشرقية الأرثوذكسية. فمنذ القرن الرابع فصاعدًا ترسخ في التقليد الرهباني الشرقي، بأن الصلاة ليست مجرد نشاط قاصر على لحظات معينة من اليوم، بل إنها ينبغي أن تستمر بلا انقطاع طوال حياة الراهب أو الراهبة. وهذه النقطة يعبر عنها باختصار أحد “أقوال آباء البرية” (الراهب الذي يصلي فقط حينما يقف للصلاة هو في الحقيقة لا يصلي بالمرة)[3].
والفكرة نفسها يعبر عنها راهب فلسطيني من القرن السابع، (أنطيوخوس من دير القديس سابا)، مقتبسًا كلمات سفر الجامعة ” لكل شيء وقت، ولكل أمر تحت السموات وقت. للولادة وقت، وللموت وقت.. للبكاء وقت، وللضحك وقت.. للسكوت وقت وللتكلم وقت”[4]. ويعلق أنطيوخوس قائلاً: (يوجد وقت مناسب لكل شيء عدا الصلاة: أما الصلاة فالوقت الذي يناسبها هو كل حين)[5]. “صلوا بلا انقطاع”. ولكن كيف نتمم هذه الوصية عمليًا؟
التفسير الحرفي
أحد أنواع الإجابة عن هذا السؤال اقترحته جماعة الـ(Messalians) أي (جماعة المصلين)، وهي حركة نسكية انتشرت في سوريا وغيرها من بلاد الشرق الأدنى قرب نهاية القرنين الرابع والخامس. واللقب (Messalians) (ميساليين) باليونانية (Euchites ) يعني بالضبط “المصلي” ومنها كلمة (أوشية = صلاة)، وجماعة “المصلين” (كما يقول الذين ينتقدونهم) فسروا وصية القديس بولس الرسول تفسيرًا حرفيًا تمامًا. فالصلاة بالنسبة لهم، يبدو أنها تعني أساسًا، الصلاة الصوتية. فقد تصوروا الصلاة على أنها نشاط يتم بوعي وعن إرادة وقصد، وأنها تستبعد كل الأنشطة الأخرى. و”أن تصلي” هو أن “تردد الصلوات” وعلى أساس هذه المبادئ “الميسالية” فلكي يصلي الناس بلا انقطاع، من المستحيل أن يقوموا بأي عمل اَخر من أي نوع، سواء كان عملاً يدويًا أو ذهنيًا. فهم لن يعملوا في الحديقة، أو يطهوا أو يغسلوا، أو ينظفوا حجراتهم أو يكتبوا خطابات… إلخ. إنهم سيصلون فقط ولن يعملوا شيئًا اَخر. فالحركة الميساليانية كان فيها “صفوة روحانية”، وهم “الذين يصلون” أي الرجال والنساء الذين عملهم الوحيد هو الصلاة فقط. أما عن حاجاتهم المادية فيزودهم بها المؤمنون العاديون. (يدعون أيضًا ميساليين لأنهم ينادون بالصلاة ويهملون العمل).
مثل هذا الفهم، أو بالحري سوء الفهم للصلاة الدائمة، دانته الكنيسة عامة بسرعة وبقوة، لأسباب يسهل فهمها. فالجواب الميسالياني أو ما اعتبره الآخرون أنه الجواب الميسالياني، هو مثار اعتراض من الناحيتين الاجتماعية والروحية. فمن الناحية الاجتماعية، يجعل الحياة الرهبانية حياة طفيلية تمامًا، تعتمد على إحسانات الآخرين. بينما كان التقليد الرهباني في تياره الغالب يصر دائمًا على أن الراهب، سواء كان متوحدًا أو يعيش في شركة (مجمع)، ينبغي أن يعتمد على نفسه في إعالة نفسه، وليس فقط يعول نفسه، بل أن يعطي لغيره أيضًا. نحن نعرف أن الرهبنة في الشرق المسيحي كانت على وجه الإجمال، أقل اهتمامًا مما في الغرب بالأنشطة المنظمة، مثل إنشاء إدارة المدارس، والمستشفيات، وملاجئ الأيتام[6]. ولكن على مستوى أقل تنظيمًا وبمستوى شخصي أكثر.
لقد كان للرهبان الشرقيين وعي قوي بمسؤوليتهم عن “القرب” في العالم، وهي مسؤولية ليست قاصرة على الأمور الروحية، بل تشمل الأمور المادية أيضًا. ونجد في الكتابات الأولى لآباء البرية، بل وفي الكتابات المتأخرة أيضاً، تكرارًا مرة بعد مرة، بل وإصرارًا على أن الراهب يجب أن يعمل بيديه لأجل إعاشة نفسه، ولأجل العطاء لمن هم في حاجة، أي للفقراء والمرضى، وللأيتام والأرامل. “طوبى للرحماء لأنهم يُرحمون”[7]. هذه كلمات تنطبق على المسيحيين. إن كان الاتجاه “الميسالياني” مثار اعتراض اجتماعيًا، فهو أيضًا مثار اعتراض من ناحية حياة الراهب الروحية الشخصية. فهناك قليلون -إن وجدوا- الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا آخر سوى أن يرددوا الصلوات، بدون أي شكل من أشكال التنوع في أنشطتهم الخارجية.
فأول قصة في “أقوال اَباء البرية” تصر بوضوح على هذه الحاجة إلى التوازن والتنوع في برنامج الحياة اليومية للراهب، والحاجة إلى تتابع منظم لمهام مختلفة، تقول القصة:
(كان القديس الأنبا أنطونيوس جالسًا في إحدى المرات في الصحراء، ولما أصابته حالة من الحزن وظلام الأفكار، قال لله: “يا رب، إني أريد أن أخلص ولكن أفكاري لا تسمح لي بذلك، فماذا أفعل في كربتي؟ كيف أخلص؟” وعندما قام أنطونيوس وخرج قليلاً إلى خارج قلايته رأى شخصًا ما يشبهه تمامًا جالسًا وهو يعمل، ثم ينهض هذا الشخص من العمل ويصلي، ثم يجلس مرة أخرى ويضفر حبلاً طويلاً، ثم ينهض مرة أخرى للصلاة. لقد كان هذا الشخص هو ملاك الرب، أُرسل ليصحح أفكار أنطونيوس ويحفظه في أمان. وسمع الملاك يقول: “افعل هكذا وأنت تخلص”. وحينما سمع هذا الكلام امتلأ بفرح وثقة عظيمين، وفعل كما أخبره الملاك وهكذا خلص)[8].
ووصلتنا قصة أخرى عن القديس أنطونيوس تقدم الفكرة نفسها، لا يستطيع أحد أن يظل في الاختبار الروحي العالي بدون انقطاع، يلزم أن يحدث استرخاء لبعض الوقت، تقول القصة:
(كان هناك صياد وحوش يجول في الصحراء، ثم جاء إلى الأنبا أنطونيوس بينما كان يمازح بعض الإخوة بلطافة، فأعثر مما رآه. أما الأب فأراد أن يؤكد أنه ينبغي علينا أن نتلاطف أحيانًا مع الإخوة، فقال له: ضع سهمًا في قوسك وشده، فشده، فقال له ثانية: شده أيضًا بقوة، فشده. ثم قال له ثالثة: شده أيضًا. فقال الصياد: إذا شددته أكثر من اللازم فإنه ينكسر. قال الأب: هكذا الحال تمامًا في عمل الله، إذا شددنا على الإخوة فوق القياس فإنهم ينكسرون. إذاً ينبغي علينا أن نلاطفهم أحيانًا. فلما سمع الصياد هذا الكلام تأثر جدًا ومضى منتفعًا جدًا مما قاله الشيخ. والإخوة أيضًا تشددوا كثيرًا ومضوا إلى أماكنهم)[9].
ولأن جماعة (الميساليين) المصلين لم يكن عندهم القابلية التي كانت للأنبا أنطونيوس، فإنهم شدوا القوس بقوة أكثر من اللازم. وفكرتهم عن الصلاة، التي تستبعد كل الأفكار الأخرى عن الصلاة، تؤدي -على الأغلب- إلى الجنون من القداسة.
جواب أنبا لوكيوس:
والاعتراض الثالث على تفسير “الميساليين” لقول الرسول “صلوا بلا انقطاع“[10]، هو أنه يجعل وصية الرسول مستحيلة التحقيق. فإذا افترضنا أن “الصلاة” هي “ترديد الصلوات” فعندئذ حتى إن كان الشخص يردد الصلوات في كل لحظة من لحظات اليقظة، سيأتى وقت حينما يلزمه أن ينام، حتى لو كان نومًا لوقت قصير، وعندئذ ماذا يكون مصير محاولته أن “يصلي بلا انقطاع”؟ هذا بالضبط هو اعتراض الأنبا لوكيوس على “الميساليين” وهو في الوقت نفسه يقترح تفسيرًا آخر “للصلاة الدائمة” وهو تفسير أفضل بكثير من السابق. ولاحظ كيف أن الأنبا لوكيوس، مثل غيره من اَباء البرية، كان يهتم كثيرًا بالفقراء:
(جاء إلى لوكيوس بعض الذين يدعون “المصلين” فسألهم الأب لوكيوس: ما هو عملكم اليدوي؟ فقالوا: نحن لا نعمل إنما اتباعًا لقول الرسول بولس فإننا نصلي بلا انقطاع. قال لهم الأب لوكيوس: ألا تأكلون؟ قالوا: نعم. قال لهم: عندما تأكلون من يصلي عنكم؟ ثم قال لهم: ألا تنامون؟ فلم يجدوا ما يجيبونه به. فقال لهم: سامحوني يا إخوتى، إنكم لا تفعلون ما تقولون. أما أنا فأثبت لكم أني بعملي أصلي بلا انقطاع. أجلس للعمل بمعونة الله أجدل الخوص وأنا أردد “ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك امْحُ إثمي” ثم قال لهم: أليست هذه صلاة؟ قالوا: نعم. قال لهم: إذن عندما أعمل وأصلي أربح فوق عملي وصلاتي ستة عشر درهمًا، أتصدق باثنين منها وأعيش بالباقي. والذي أتصدق عليه يصلي من أجلي. وعندما اَكل وأنام فبنعمة الله في الوصية “صلوا بلا انقطاع”).
هذا هو حل الأب لوكيوس: صلاة مستمرة تقدم بالتعاون والمشاركة. وهذا الحل نفسه تبناه بصورة أكثر تطورًا الدير المشهور في القسطنطينية الملقب بـ”دير الذين لا ينامون”. كان الرهبان في هذا الدير يمارسون خدمة الصلاة بنظام المناوبة. فبمجرد أن تنتهي مجموعة من الصلاة تقوم بخدمة الصلاة المجموعة التي تليها، وهكذا، حتى إن الصلاة كانت تُقدم بلا انقطاع طوال الـ(24) ساعة يوميًا بواسطة قسم من مجموع رهبان الدير.
فكرة الأنبا لوكيوس عن الصلاة بالتعاون، على الرغم مما يبدو عليها من سذاجة، فإنها تؤكد نقطة ذات أهمية حاسمة. فالصلاة ليست نشاطًا فرديًا، بل هي أساسًا نشاط جماعي. فنحن نصلي كأعضاء بعضنا لبعض في جسد المسيح. حتى الناسك المتوحد في أبعد ركن في البرية، لا يقف أمام الله أبدًا بمفرده، بل يصلي دائمًا كأحد أفراد عائلة كبيرة. وبقية الكنيسة كلها تصلي معه، وحينما لا يستطيع أن يصلي، فإن صلوات الآخرين لا تزال مستمرة.
يقول أفاغريوس البنطي: “المتوحد هو ذلك الشخص المنفصل عن الكل والمتحد بالكل”[11]. وتوجد أيضًا نقطة أخرى أكثر تشويقًا نلاحظها في جواب الأنبا لوكيوس على “الميساليين”. فالصلاة، عنده لا تلغي العمل اليدوي. وبخلاف “الميساليين” هو يصلي أثناء العمل، وهو يستعمل صلاة قصيرة يكررها باستمرار. وبهذه الطريقة فإن وقت الصلاة عنده ليس قاصرًا على اللحظات التي فيها “يقف للصلاة”، بل هو يستطيع أن “يحتفظ” بصلاته أثناء تتميمه لقانونه في العمل.
صلاة لوكيوس من مزمور (50) و(51)، هي فقط واحدة من بين صيغ كثيرة لصلوات الترديد المستمر. “فالقديس يوحنا كاسيان” الذي استلم تدريبه الرهباني في مصر، يوصي باَية أخرى من المزامير “اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني” (مز69 س (70): 1)[12]. والأنبا أبوللو إذ كان قد أخطأ خطيئة فظيعة في حياته المبكرة. فإنه يستعمل مثل لوكيوس عبارة توبة “قد أخطأت كإنسان، فارحم كإله”[13]. وفي بعض الأحيان فإن صيغة الصلاة يمكن أن تكون أبسط من ذلك؛ إذ يعلم القديس “مقاريوس المصري (الكبير)”: ]لا توجد حاجة إلي الكلام الكثير، بل ارفع يديك وقل: “يا رب، كما تريد وكما تعرف أنه الأفضل، ارحمني”. وإذا اشتدت الحرب، فقل “يا رب أعني” وهو يعرف ما هو الأفضل لنا وهو رحوم بنا[[14]. ولكن من بين كل الصيغ القصيرة التي تستعمل لصلاة الترديد المتواصل، فإن أغناها في المعنى وأكثرها استعمالاً طوال القرون هي بلا شك “صلاة يسوع”: “يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني”. وقد أضيفت إليها في الممارسة الأرثوذكسية الحديثة عبارة “أنا الخاطي”.
أمامنا الآن إذن، طريقة لتتمة وصية “صلوا بلا انقطاع” مع تحاشي تطرف “الميساليانية”. فالصلاة يمكن أن تقترن بالعمل. فالراهب يختار عبارة قصيرة. إما “صلاة يسوع” أو غيرها، بحسب رغبته وبإرشاد أبيه الروحي. ويحاول أن يردد هذه العبارة في كل مكان وأيًا كان العمل الذي يعمله. (أو ربما يرددها فقط في أوقات محددة، إذا كان هذا هو توجيه أبيه الروحي). وبهذه الطريقة فهو يسعى أن يحمل صلاته معه خلال كل مهامه اليومية، وهو بذلك يقيم في عالمين في الوقت نفسه، العالم الخارجي والعالم الداخلي. وكما يعبر عن ذلك القديس “ثيوفان الناسك”: ]اليدان تعملان، والذهن والقلب مع الله[[15]. إذن فالراهب له نوعان من “النشاط” هما: عمله المنظور سواء كان يدويًا أو عقليًا، وهذا ينبغي أن يقوم به على أفضل ما يستطيع لأجل مجد الله، والعمل الآخر، هو “نشاطه الداخلي”. يقول اَباء البرية: إن “الشخص ينبغي أن يكون له نشاط في داخله”[16]. هذا النشاط الداخلي يُسمى أيضًا “الهذيذ الداخلي” أو بكل بساطة “تذكر الله”.
وبكلمات عظات القديس مقاريوس الكبير:
“المسيحي ينبغي أن يذكر الله في كل الأوقات… فينبغي أن يحب الرب ليس حين يذهب إلى مكان العبادة فقط، بل في السير والكلام والأكل يحتفظ بذكر الله ويحبه بكل قلبه”[17]. مثل هذه الأفكار ليست قاصرة طبعًا على الشرق المسيحي، والمثال الغربي الواضح لهذا هو الأخ لورانس في “ممارسته الوجود في حضرة الله” وسط واجباته في المطبخ.
الصلاة الدائمة كحالة داخلية
ومهما كانت إجابتنا عن “الميساليين” (جماعة المصلين) فهي ليست إجابة كاملة تمامًا بعد. فالأب لوكيوس يدرك بصواب أنه من الممكن ممارسة العمل والصلاة في الوقت نفسه، وأكثر من ذلك، فهو يقترح طريقة عملية يمكن بها الاستمرار في هذا النشاط المزدوج. وأعني بها التكرار المستمر لصلاة قصيرة وبسيطة جدًا. ولكن الفهم لطبيعة الصلاة هو محدود جدًا. فهو لا يزال يفكر أساسًا في الصلاة على أنها صلاة صوتية فقط: فهو مثل “الميساليين” يقول: إنه “أن تصلي” تعني “أن تقول صلوات بالفم”. ويمكن أن يثار اعتراض على هذا الفهم. وهنا نأتي إلى الحل الحقيقي لمشكلة الصلاة الدائمة. إن الصلاة، عندما نفهمها كما ينبغي، هي في أعمق معنى لها ليست نشاطاً بقدر ما هي حالة. فلكي تكون في حالة صلاه دائمة، ليس من الضروري أن تكرر عددًا لا حصر له من الصلوات، لأنه يوجد ما يمكن أن نسميه “صلاة دائمة داخلية” بالتأكيد، إن التكرار المتواصل لصلاة قصيرة، كما يوصي لوكيوس، هي طريقة ممتازة سعيًا للوصول إلى هذه الحالة الداخلية. ولكن يمكن أن يكون هناك وقت حينما تستمر حالة الصلاة الدائمة، على الرغم من أن تكرار كلمات الصلاة لا يستمر، أي حينما تتغلغل الصلاة وتدخل إلى نسيج كياننا ذاته، بدلاً من أن تكون كلمات يجب أن نقولها باستمرار، وهكذا تكون الصلاة موجودة دائمًا هناك حتى حينما لا تُقال بالفم. وبهذا المعنى، إذن، فهناك أشخاص يصلون حتى وهم نيام، لأنهم يصلون أساسًا ليس بسبب أي شيء يقولونه أو يفكرون فيه، بل بالحري بفضل ما هم عليه بكيانهم. ومادام “كيانهم” هكذا باستمرار، فيمكن أن يُقال: إنهم “قد وصلوا بأكمل معنى ممكن إلى الصلاة الدائمة”.
والقديس “باسيليوس الكبير” يقترح أيضًا أفكارًا مثل هذه في عظته على “الشهيدة يوليتا”: (الصلاة هي سؤال ما هو صالح، ويقدمها الأتقياء إلى الله. ولكننا لا نحصر هذه “الصلاة” فقط في حدود ما نذكره بالكلمات.. فلا ينبغي أن نعبّر عن صلاتنا بواسطة مقاطع الكلام فقط، بل ينبغي أن نُعبّر عنها بالموقف الأخلاقي والروحي لنفسنا، وبالأعمال الفاضلة التي تمتد خلال حياتنا كلها.. هذه هي الطريقة التي تصلي بها بلا انقطاع. ليس بأن تقدم الصلاة بالكلام، بل بأن توحد نفسك بالله خلال كل مسيرتك في الحياة، حتى تصير حياتك صلاة واحدة متواصلة وبلا توقف[18].
“لا ينبغي أن نعبّر عن صلاتنا بواسطة مقاطع الكلام فقط…”، ولكن من الواضح تمامًا أننا جميعًا ينبغي أن نبدأ بواسطة صلاة الكلام.
وفي التعليم الروحي السائد في الكنيسة الأرثوذكسية، فإن الصلاة عادة تقُسّم إلى ثلاث مراحل كبيرة وهي:
+ صلاة الشفتين.
+ صلاة العقل أو الذهن (Nous).
+ صلاة القلب (أو بدقة أكثر “صلاة الذهن في القلب”).
لنفرض أن صلاتنا التي نكررها باستمرار هي العدد الأول من (مز 50) “ارحمني يا الله كعظيم رحمتك..” بحسب طريقة الأب لوكيوس، أو قد تكون صلاة يسوع “يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني…”، هذه الصلاة تبدأ كصلاة الشفتين، نرددها بجهد واعٍ. في هذه المرحلة فإن انتباهنا يتشتت مرة بعد أخرى، وأيضًا مرة بعد مرة يلزم أن نعيد انتباهنا، بحزم ولكن بدون عنف، إلى معنى الكلام الذي نردده في الصلاة. وبعد ذلك فإن الصلاة تنمو بالتدريج لتصير داخلية أكثر فأكثر. فتصير الصلاة مقدمة بالذهن وبالشفتين معًا. وربما تصير مقدمة بالذهن وحده، بدون أي صياغة لكلمات بالفم، وبعد ذلك تأتي مرحلة أعمق إذ تنزل الصلاة من الذهن إلى القلب، ويتحد الذهن والقلب معًا في عمل الصلاة.
والمقصود “بالقلب” هنا -كما سبق أن رأينا-[19] ليس ببساطة موضع العواطف والانفعالات، بل المقصود كما في الكتاب المقدس أنه العضو الرئيس لشخصيتنا الإنسانية، ومركز كياننا كله. فحينما تصير صلاتنا هي “صلاة القلب” بالمعنى الكامل، فإننا نكون قد اقتربنا فعلاً من بداية “الصلاة بلا انقطاع” أي “الصلاة الداخلية” الدائمة التي ذكرناها.
صلاة القلب الحقيقية لا تعود فيما بعد مجرد شيء نردده، بل تكون جزءًا من ذواتنا، مثلما أن التنفس أو ضربات قلبنا هي جزء من ذواتنا. وهكذا فإنه بنعمة الله تصير الصلاة لا شيئًا ينبغي على الشخص أن يقوله، بل تصير شيئًا يتكلم من ذاته في داخله: وبتعبيرات القديس ثيوفان الناسك، فإنها تكف عن أن تكون “شاقة وعسيرة” وتصبح “مدفوعة ذاتيًا”.
فالصلاة التي بدأت كنشاط عرضي تثير الآن حالة مستمرة بدون انقطاع وهذا ما قصده توماس سيلانو ( Thomas Celano ) حينما قال عن القديس فرنسيس الأسيزي: “لقد كان في كل كيانه ليس شخصًا يقول صلوات، بل بالأحرى تحول هو نفسه إلى صلاة”[20].
والقديس مار إسحق السرياني يرى أن صلاة القلب بلا انقطاع ليست “صلاتنا” نحن بقدر ما هي صلاة الروح القدس في داخلنا:
التلميذ: ما هي نهاية كل أتعاب النسك، التي عندما يصل إليها الشخص يعرف أنها قمة مسيرته؟
المعلم: هذا يحدث حينما يُحسب أهلاً للصلاة الدائمة. فحينما يصل إلى هذه اليقظة، فإنه يكون قد بلغ الغاية من كل الفضائل، ومن الآن فصاعدًا يكون له مسكن في الروح القدس. إن أي شخص لم يحصل بكل تأكيد على موهبة المعزي، لا يمكنه أن يتمم الصلاة الدائمة في السكون. حينما يجعل الروح القدس مكان سكناه في إنسان ما، فإن هذا الإنسان لا يكف عن الصلاة؛ لأن الروح سيصلي فيه باستمرار. حينئذ فإن الصلاة لا تنقطع من نفسه حينما ينام ولا حينما يكون مستيقظًا، بل إن روائح الصلاة سوف تسري في قلبه تلقائيًا حينما يأكل وحينما يشرب، حينما يرقد أو عندما يقوم بأي عمل، بل حتى حينما يكون مستغرقًا في النوم. فمنذ ذلك الوقت فصاعدًا لن تكون صلاته في أوقات محدودة، بل تكون في كل الأوقات، فحتى ذلك الوقت تُعطَى له الصلاة بطريقة سرية. لأنه كما قال إنسان لابس للمسيح: “صمت الهادئين هو صلاة، لأن أفكارهم ذاتها هي نبضات إلهية. حركات الذهن النقي هي أصوات هادئة، تنشد تسابيح بطريقة سرية لذاك الذي هو غير منظور”[21].
“صمت الهادئين صلاة” حتى صمت القديسين، استرخاؤهم وعدم نشاطهم، هو ذاته صلاة لله، لأن صلاتهم صارت جزءًا جوهريًا من أنفسهم.
هذا هو المعنى الذي وصل إليه التقليد الروحاني الأرثوذكسي من كلمات القديس بولس الرسول “صلوا بلا انقطاع” لا ينبغي أن نتصور ولا للحظة واحدة أن الحالة التي يصفها مار إسحق هنا من السهل الوصول إليها. وفي الحقيقة فإن كلماته توضح تمامًا، أن هذه الحالة ليست شيئًا يُكتسب بمجهوداتنا الذاتية، بل هي عطية من الله: وبما أنها هكذا فهو يمنحها حيثما يشاء ولمن يشاء، دون اعتبار لأية قواعد أو مبادئ يمكن أن نختارها نحن أو نضعها.
مارس القديس سلوانس بجبل أثوس صلاة يسوع لمدة ثلاثة أسابيع فقط حينما نزلت الصلاة إلى قلبه وصارت صلاة بلا انقطاع[22]، ولكن هذا أمر استثنائي تمامًا. الأب أغابي أحد الشيوخ الروحيين لدير فالامو ( Valamo ) يعطي الانطباع أن صلاة الذهن في القلب يمكن أن تُقتنى بسرعة نسبية:
“من بين ثلاثة أشخاص أعرفهم فإن هذه الصلاة دخلت في قلب واحد منهم في خلال ساعة واحدة منذ أن عرف بها؛ والآخر صارت له في خلال ستة شهور، والثالث بعد عشرة شهور، بينما في حالة شيخ روحاني كبير فإنها أتته فقط بعد سنتين. أما لماذا يحدث هذا هكذا، فإن الله وحده يعرف”[23].
وكتاب “السائح الروحي على دروب الرب” يقول: إن مثل هذه الصلاة تُكتسب في فترة قصيرة نسبيًا، غالبًا بطريقة ميكانيكية وأتوماتيكية. والآن، فإنه أمر أكيد أن هذا يمكن أن يحدث في بعض الحالات. ولكن الأمر يحتاج أن نقول بتأكيد شديد: إن هذا لا يحدث دائمًا بشكل ثابت، بل إن هذا ليس هو الوضع العادى. بل بالعكس، فهناك رجال ونساء لهم حياة روحية عميقة وقد صلوا “صلاة يسوع” بتواضع وإخلاص لسنوات عديدة، ومع ذلك لم يحدث أبدًا أن أُعطيت لهم نعمة الصلاة الدائمة.
قال راهب روسي الأب أنطونيوس من دير مار سابا بالقرب من أورشليم. قال: إنه يعرف عددًا من الرهبان في برية اليهودية الذين جاهدوا مصلين لكي ينالوا هذه الموهبة، وقد أكد أنها لم تُمنح لأي واحد منهم. وأضاف: ربما أن الله لم يشأ أن تُمنح هذه الموهبة الخاصة لجيلنا الحاضر. وعلى الرغم من أن الأب الراهب لم يشر مباشرة إلى نفسه، ولكن هو كان واحدًا من الذين جاهدوا لينالوا موهبة الصلاة هذه. وقد كان راهبًا صادقًا ويتمتع بفهم عميق ويملك مواهب وقدرات “الستارتز” (الشيخ الروحاني).
وفي هذا الصدد، فإن مار إسحق السرياني يطلق صوت تحذير نافعاً إذ يقول: “كما أنه يندر أن يوجد واحد بين عشرة آلاف، قد أكمل الوصايا والناموس بدرجة كبيرة، وقد حُسب أهلاً لسكون النفس، هكذا أيضًا يُوجد واحد بين كثيرين، قد حُسب أهلاً بسبب سهره الشاق للبلوغ إلى الصلاة النقية. ولا يوجد كثيرون يُحسبون أهلاً للصلاة النقية، بل فقط قليلون جدًا. أما من جهة السر الذي يكمن وراء الصلاة النقية، فبالكاد يوجد شخص واحد فقط في كل جيل قد اقترب إلى هذه المعرفة الخاصة بنعمة الله”[24].
لكن مثل هذه الأقوال لا ينبغي أن تثبط همتنا كلية. فيمكن أن يكون صحيحًا أنه أثناء هذه الحياة الحاضرة، فإن قليلين جدًا يبلغون إلى القمم العليا للجبل. واحد من عشرة آلاف، أو واحد في الجيل بأكمله، ولكن طريق الصعود يظل مفتوحًا للجميع، وكل واحد يمكنه أن يتقدم إلى مسافة معينة، على أية حال، على الطريق. ليست هناك صفوة تتمتع بامتياز خاص هي وحدها مدعوة لهذه النعمة. فليس هناك أحد بالمرة مستعبدًا بالضرورة.
“ليس أحد مستعبدًا بالضرورة”: إن كنا نتحدث حتى الآن بشكل أولى عن التقليد الرهباني، فإن طريق الصلاة الذي وصفناه هنا ليس منحصرًا في الرهبان والراهبات. وكما يقول الشيخ نيقوديموس من جبل أثوس: ]لا يظن أحد منكم، يا إخوتى المسيحيين، أن الكهنة والرهبان فقط هم الذين يحتاجون أن يصلوا بلا انقطاع، وأن المؤمنين من الشعب ليسوا كذلك لا، لا: فإن كل مسيحي بدون استثناء ينبغي أن ينشغل دائمًا بالصلاة. فإن القديس “غريغوريوس الناطق بالإلهيات” يعلم كل المسيحيين أن اسم الله ينبغي أن يُذكر بالصلاة بعدد مرات التنفس…
فحينما أوصانا الرسول بولس: “صلوا بلا انقطاع” قصد أننا ينبغي أن نصلي بذهننا داخليًا: وهذا يمكننا أن نفعله دائمًا. لأننا حينما نقوم بعمل يدوي وحينما نمشي أو نجلس، حينما نأكل ونشرب، يمكننا دائمًا أن نصلي بذهننا ونمارس الصلاة الداخلية، الصلاة الحقيقية، المرضية لله. فلنعمل بجسدنا وأيضًا نصلي بروحنا. فلتقم ذاتنا الخارجية بالعمل الجسدي، ولتكن ذاتنا الداخلية مكرسة كلية وبالتمام لخدمة الله ولا تكل أبدًا في العمل الروحي، عمل الصلاة الداخلية][25].
بالتأكيد، فمن ناحية المبدأ أنه سهل على المتوحد، الذي يعيش في سكون الصحراء، ويمارس عملاً يدوياً بسيطاً مثل الأب لوكيوس، يقدر أن ينجح في “ملازمة” صلاته وسط مشاغله اليومية. وبالنسبة للراهب -أو الراهبة- الذي يقوم بخدمة في العالم كالتعليم في مدرسة، مثلاً أو خدمة التمريض في مستشفى، فإن مهمة “ملازمة الصلاة” هي أصعب بالضرورة: أصعب ولكنها ليست مستحيلة. وبالنسبة للمؤمن العادي الذي ينقصه الإطار المنظم للجماعة الرهبانية، فإن المهمة قد تكون أكثر صعوبة. ومع ذلك فإن التقليد الروحي الأرثوذكسي يؤمن إيمانًا راسخًا بأن هؤلاء جميعًا، يمكنهم برحمة الله أن يشتركوا في نعمة الصلاة الداخلية. فحتى إن كان قليلون سواء في الصحراء أو المدينة يتمتعون بالصلاة الدائمة بالمعنى الكامل، فإن كل واحد يمكنه أن ينجح بواسطة صلاة يسوع أو غيرها من الصلوات في الصلاة، بينما هو -أو هي- يقوم بعمله. وفي الحقيقة، فإن صلاة يسوع، بسبب قصرها وبساطتها، هي مناسبة تمامًا بصورة ملحوظة لأولئك الذين يعيشون تحت التوتر والضغط الخارجي، الذين تكون جميع الصلوات الأكثر تعقيدًا غير مناسبة لهم.
ليس هناك ظرف خارجي، مهما كان يسبب التشتت، هو في حد ذاته متعارض مع صلاة القلب الداخلية.
تقول عظات القديس مقاريوس: “ويحدث أحيانًا أن قديسي الله يجلسون في المرصد وينظرون ضلال العالم وخدعه: فبحسب الإنسان الباطن هم يتخاطبون مع الله، ولكن بحسب الإنسان الخارجي فإنهم يظهرون للناس كأنهم يتأملون ما يحدث في العالم”[26].
ليس هناك سوى أشكال قليلة من الحياة أكثر قسوة، وتستلزم تركيزًا كبيرًا على اهتمامات هذا العالم، مثل عمل الطبيب. ومع ذلك فقد قالت لنا “أقوال آباء البرية”: إن طبيبًا بالإسكندرية “ونحن لم نُفد باسمه” كان معادلاً روحيًا للقديس أنطونيوس، أعظم النساك المسيحيين: “لقد كُشف للأنبا أنطونيوس في الصحراء أنه يوجد في المدينة واحد مثلك، ومهنته طبيب، وهو يعطي لمن هم في احتياج كل ما يستطيع أن يستغني عنه، وطوال اليوم هو يسبح تسبحة الثلاث تقديسات مع الملائكة”[27].
الخاتمة
أي واحد منا، يستطيع بمعونة الروح القدس، أن يفعل مثل هذا الطبيب. ملكوت السموات هو في داخلنا. وبكل بساطة، فأن نصلي يعني أننا ندخل إلى هذا الملكوت الداخلي في قلبنا، وهناك (في القلب) نقف أمام الله. وأن “نصلي بلا انقطاع” هو أن نفعل هذا بشكل ثابت. وعلى الرغم من أن المجد الكامل لهذا الملكوت ينكشف لقليلين في هذا العالم الحاضر، فإنه يمكننا جميعًا أن نكتشف على أي حال، بعضاً من غنى هذا المجد. فالباب أمامنا والمفتاح في أيدينا.
[1]* باحث مصري.
[2]– تسالونيكي 17:5
[3]– أقوال آباء البرية ((A.P.A.C 104.
[4]– الجامعة 1:3-7
[5]– Pandect, Homily 91 (PG 89:1712B).
[6]– ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات المهمة في هذا المجال. ففي القرن الرابع، مثلاً، أسس القديس باسيليوس الكبير مركزاً ضخمًا لأعمال المحبة الخيرية وكان يسمى “باسيليادوس” نسبة إلى اسم مؤسسه، وكان مكاناً شاسعاً لدرجة أنه سُمي بـ”المدينة الجديدة” وكان يدير هذا المركز مجموعة من الرهبان والراهبات. انظر:
Philip Rousseau, Basil of Caesarea Berkely. Univ of Calif. Press 1994 139-144.
[7]– متى 7:5.
[8]– مجموعة من أقوال اَباء البرية أبجديًا A.P. Antony 1.
[9]– أقوال آباء البرية A.P. alphabetical collection, Antony 13 .
[10]– تسالونيكي، 17:5.
[11]– On Prayer 124, Philokalia, 1:69.
[12]– Conferences 10.10.
[13]– A.P Apollo 2.
[14]– A.P, alphabetical collection, Macarius the great 19.
[15]– Igamen Chariton, The Art of Prayer, 92.
[16]– AP anonymous collection 241.
[17]– عظات القديس مقاريوس الكبير عظة (3:43)، ترجمة: نصحي، عبدالشهيد، طبعة ثالثة، 2001، والطبعة الرابعة للعظات نفسها يناير (كانون الثاني) 2005.
[18]– Homily on the Martyr Julitta 3-4 (P.G. 31: 244A, 244D).
[19]– مقال “العبادة الأرثوذكسية” للأسقف كاليستوس (وير) ص11.
[20]– Legend 2.61.
[21]– Homily 35 (37): tr. Wensinck, 174.
[22]– القديس سلوانس الأثوسي للأرشمندريت صفروني (ساخاروف)، ٢٣.
[23]– Quoted in Igumen Chariton, The Art of Paper, 277.
[24]– Homily 22: Tr. Winsinck, 113.
القديس مار إسحق يتحدث هنا عن الصلاة “النقية” لا عن الصلاة “الدائمة” ولكن ملحوظته هنا تنطبق بالتأكيد على الصلاة “الدائمة” أيضًا.
[25]– Philokalia in Greek Vol.5: 107, (Athens, Aster. 1963).
[26]– عظات القديس مقاريوس، عظة ٨:١٥ ترجمة: نصحي عبدالشهيد، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الطبعة الرابعة، يناير (كانون الثاني) 2005.
[27]– A.P, alphabetical collection, Antony24 (84B).