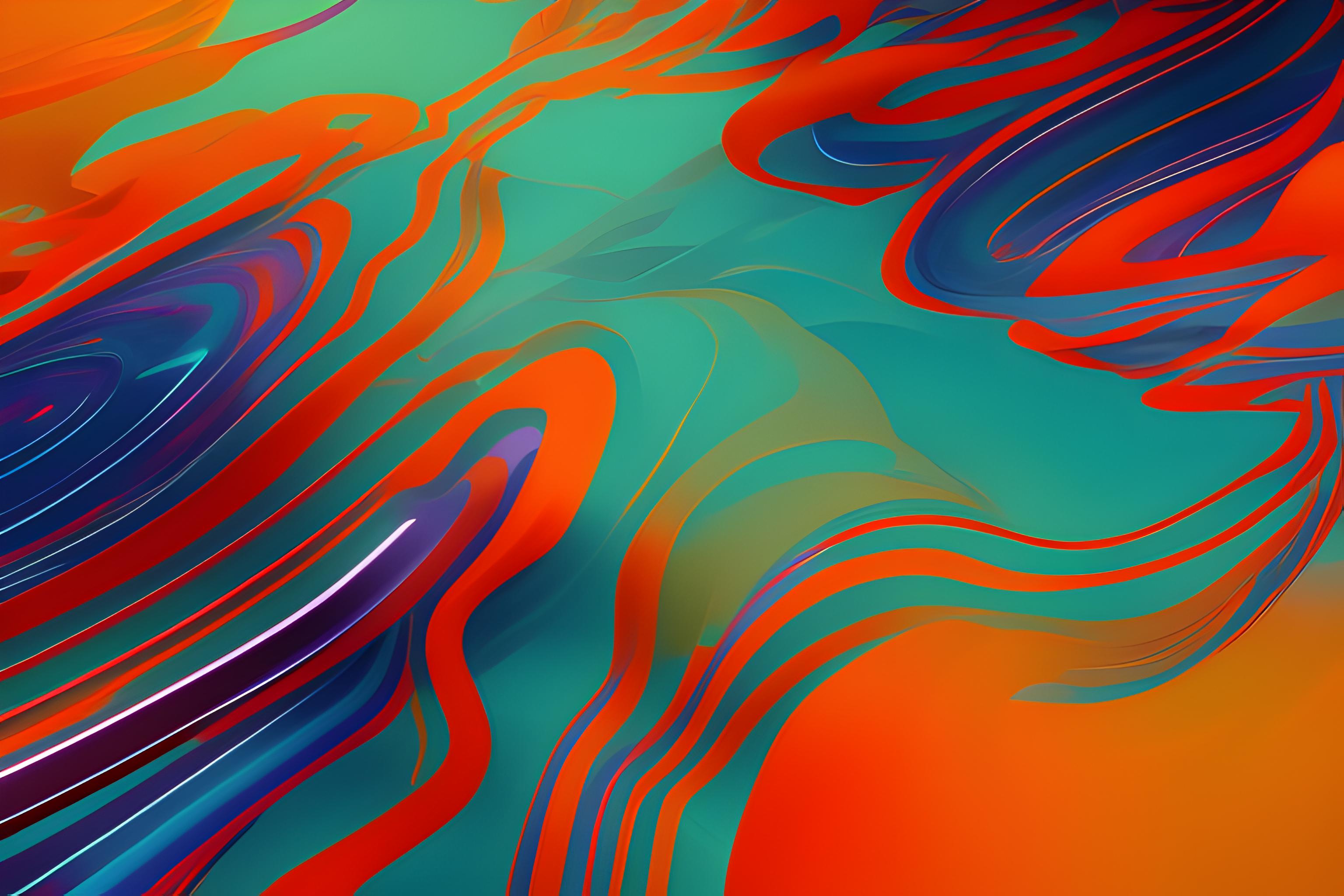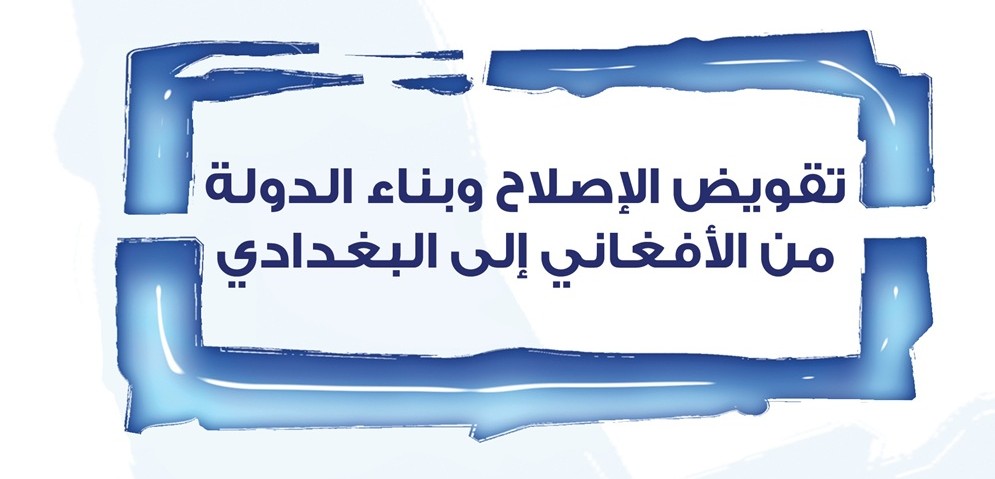كانت جميع المؤشرات تشير إلى أن الوضع السياسي في تونس لا يمكن أن يتواصل بالحالة التي كان عليها قبل يوم 25 يوليو (تموز)، عندما أعلن الرئيس قيس سعيد عن تحول جذري مفاجئ أخرج الإسلاميين من المشهد بعد أكثر من عشر سنوات من الحضور في السلطة، والذين أنضجوا خلالها ظرفاً موضوعياً وذاتياً دفع الرئيس سعيد إلى تحركه “الإنقاذي”. وبالرغم من أن جميع المراقبين كانوا يتوقعون ما حدث، فإن سياسة المكابرة التي تميز بها إسلاميو تونس خلال السنوات الماضية، جعلت موقفهم مما حدث لا يخرج عن خطاب ”إلقاء المسؤولية على الغير” المعتاد والتلويح بوجود “مؤامرة ما” ضدهم دون التراجع قليلاً ومراجعة أخطاء وخطايا المرحلة السابقة، والتي أعطاهم الشعب خلالها فرصة كبيرة وممتدة زمنياً كي يثبتوا صحة الشعارات الشعبوية التي كانوا يرفعونها عندما كانوا في المعارضة، إلا أن الفرصة الثمينة تحولت إلى سلسلة متلاحقة من خيبات الأمل والفشل السياسي والتنموي، وانتهت عشية 25 من يوليو (تموز)، حيث أعرض أنصار الحركة الإسلاموية وجمهورها حتى عن النزول إلى الشوارع لدعمها في حركة رمزية توحي بأن السمكة قد فقدت ماءها. لكن السؤال: كيف وصل الإسلاميون إلى هذا الوضع؟
***
عام 2011 عادت الحركة الإسلاموية التونسية إلى البلاد بعد عقدين من الغياب محملة بخطاب المظلومية، وقد نجحت من خلال ذلك في كسب تعاطف قطاعات واسعة من الشعب التونسي، لكن الحركة التي خرجت من المشهد عام 1991 بعد معركة قاسية مع نظام زين العابدين بن علي ومغالبة غير متوازنة، عادت إلى النشاط بالأخطاء نفسها. حيث كانت أسباب صراعها مع ابن علي الرئيسة هي شهوة الهيمنة التي كانت تحكم سلوكها السياسي والتعطش إلى “التمكين”. بعد 2011 لم توفر الحركة جهداً في العودة بقوة إلى “التمكين”، وكانت تعتقد أن الطريق أصبح مفتوحاً متجاهلة عمق الثقافة المعلمنة في تونس والنخب غير الإسلاموية الماسكة بمفاصل الدولة وأجهزتها الأيديولوجية، وهو سوء التقدير نفسه الذي وقعت فيها أغلب تجارب الحكم التي خاضها الإسلاميون في المنطقة العربية.
وخلال أكثر من عقدين من المنفى لم تُجرِ حركة النهضة تغيرات جذرية على أدبياتها ووثائقها الفكرية. فبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، عادت الحركة للنشاط العلني داخل البلاد، وطبّعت علاقتها بمؤسسات الدولة، حيث حصلت للمرة الأولى في تاريخها على ترخيص العمل القانوني كحزب سياسي. لكنها في المقابل حافظت على قانونها الداخلي المُصاغ منذ عام 1984 والمُسمى “الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي”، والذي يكشف عن جماعة دينية هدفها إقامة الدولة الإسلامية، وليس عن حزب سياسي يريد المشاركة في الحياة السياسية لدولة مدنية، تمنع في قوانينها قيام الأحزاب على أساس ديني. كانت تلك الفترة مرحلة الحماس الثوري في تونس، لذلك كانت الدولة في أضعف مراحلها منذ الاستقلال وخضعت لإكراهات عديدة.
نجحت الحركة الإسلامية في الوصول إلى السلطة في أعقاب انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011. لتدخل مرحلة جديدة في علاقتها بالدولة والمجتمع. كانت النهضة تدرك جيداً أن حصولها على التفويض الشعبي في الانتخابات لا يُمكّنها تماماً من السلطة. فموازين القوى داخل النخب الحاكمة ومراكز القوى ما زالت مختلة ضدها. يقول الغنوشي: “لا الوضع الإقليمي ولا الدولي يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية -على نحو عامّ- ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أم لا. كنت دائما أقول لإخواني: لا يمكنكم أن تحكموا مجتمعا رغمًا عن نخبته (…) لا يمكننا أن نصنع نخبة موالية لنا عبر اللجوء إلى القمع والرعب. والدليل على ذلك أنّ النظام البورقيبي، ومن بعده ابن علي، لم يستطيعا أن يطوّعا النخبة على نحو ما يريدان. إنّ مسألة موازين القوى هي فكرة أساسية في الثقافة السياسية للحركة. ويجب أن تكون الأغلبية مدعومة بنخبة فاعلة، بمعنى أنّ الكمّ وحده غير كافٍ. لا بد من توافر الحد الأدنى من الكيف إلى جانبه. دائمًا ما كنّا نأخذ مثال الجزائر لتأكيد هذه الفكرة؛ فالجبهة الإسلامية للإنقاذ حصلت على (80%) في أول انتخابات تشريعية نزيهة تُجرى في هذا البلد الشقيق، أواخر سنة 1991. وبالمنطق الكمّي الحسابي الديمقراطي، يمكن القول: إنّ الجبهة حصلت على شرعية عالية جداً. ولكن، ماذا فعلت بها؟ ميزان القوى هو الذي قال كلمته، ولم ينفعها كثيراً المنطق الكمّي. ماذا تفعل بهذه الجموع التي حشدتها حولك في حين أنّ النخب جميعاً (الجيش، والشرطة، والإدارة، والآداب، والإعلام، والمال، والفنون، فضلاً عن العلاقات الدولية) ليست إلى جانبك، ولا تعمل لفائدة الإسلاميين؟. ماذا تفعل بهذه الجموع التي حشدتَها حولك؟ لن تفعل بها شيئاً، بل على العكس يمكن أن تقودها إلى محرقة”[1].
ومع هذا الوعي بوجود فقر نخبوي داخل الحركة الإسلامية التونسية، فشلت النهضة في إدارة الحكم والدولة، لأنها بقيت أسيرة نظرة قديمة معادية للدولة، وكذلك لأنها دخلت بنفس هدام، يريد أن يستأنف برنامج الهدم لما هو قائم، وهو البرنامج القديم للحركة مذ كانت تسمى الجماعة الإسلامية في نسختها الإخوانية. فقط ما تغير هو موقع الحركة. فالحركة التي كانت تريد هدم الدولة الوطنية وإقامة الدولة الإسلامية من موقع المعارضة الجذرية المنبوذة والملاحقة، أصبحت اليوم داخل الدولة كسلطة، وأصبحت أكثر قدرة على هدمها من الداخل، وإعادة بنائها من جديد وفقاً لأفكارها الطوباوية، في سيناريو شبيه بما حدث في سودان التسعينيات. لكن الحركة كانت تعول في ذلك على قاعدتها الجماهيرية العريضة، فيما كانت النخب الفكرية والمالية والإدارية في المعسكر المقابل، بل كانت هذه النخب هدفاً للتكفير والتخوين من طرف الحركة وأنصارها. وتشير اللائحة التقييمية التي نشرتها الحركة في مؤتمرها الأخير عام 2016 إلى ذلك بوضوح بالقول: “ظل المنهج الذي اعتمدته الحركة يركز أكثر على الفئات الشعبية، وعلى اعتماد خطاب يناسبها استقطابا وتعبئة، والتوجه خاصة إلى الشباب التلمذي والطلابي ورواد المساجد. إلا أنها لم تسع في الآن نفسه للوصول إلى النخب (مثقفون، جامعيون، إعلاميون، نقابيون، رجال أعمال…) والتواصل معهم بخطاب ومضمون مناسبين. والحقيقة أن وعي الحركة لا يزال ضعيفا بأهمية النخب الماسكة بعملية التوجيه في البلاد وحجم تأثيرها في القرار داخل السلطة، وبدورها الخطير في صناعة وتشكيل الرأي العام”[2].
لذلك سعت حركة النهضة إلى إعادة بناء شبكات نخبوية جديدة تساعدها في مشروع التمكين، وقد نجحت نسبياً في ذلك خاصة في قطاع القضاء والإعلام والمجتمع المدني والإدارة والأوساط المالية والاقتصادية، لكنها عجزت عن تحقيق تقدم في هذا الاتجاه داخل المؤسسات الصلبة للدولة، مثل الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش والقوى الشعبية الأكثر نفوذاً مثل النقابات، لا سيما داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. ومسفيدةً من وجودها في السلطة استعملت الحركة وسائل الدولة، كسلطة العزل والتعيين والترقيات والرفع في الرواتب والامتيازات في تقريب بعض النخب وعزل الأخرى، إلا أن هذا المشروع التمكيني بالرغم من قوته المالية والتنظيمية والدعم الخارجي الذي يتلقاه، بقي قاصراً على مدى عشر سنوات عن تحقيق أهدافه في إخضاع الدولة والمجتمع لسلطة الحركة الإسلاموية، بسبب عجزه عن إخضاع أجهزة العنف الشرعي للدولة، بالرغم من شروع الحركة في بناء أجهزة موازية كــ”الجهاز السري” و”روابط حماية الثورة”، والتي تورطت في أعمال عنف، وكذلك توظيف الجماعات السلفية في استخدام العنف ضد الخصوم السياسيين. حيث لم ينته هذا الهجوم الإسلاموي على الدولة والمجتمع (2011- 2013) إلا بعد حركة 30 يونيو (حزيران) 2013 المصرية، والتي جعلت الإسلاميين في تونس يتراجعون تكتيكياً في انحناءة أمام العاصمة خوفاً من المصير نفسه الذي انتهت إليه تجربة الجماعة الأم في القاهرة.
***
لكن التراجع السياسي الذي سجلته حركة النهضة بعد 2013 لم يوقف مشروعها التمكيني بل غير في مسار تنفيذه، فبدلاً من الحضور المباشر في السلطة توجهت الحركة للمشاركة مع حركة نداء تونس، وبدلاً من الخطاب الإسلاموي المباشر، المثقل بالأيديولوجيا الإخوانية، اتجهت نحو الإعلان عن “الفصل بين العمل الدعوي والسياسي”، في تحول اُعتُبِر نوعياً في وقته، لكن الأيام ما لبثت أن كشفت أن الفصل لم يكن إلا شعاراً سطحياً لا يتجاوز التسويق للحركة باعتبارها “حزباً ديمقراطياً” خاصة في الدوائر الغربية.
لكن القصور الحاصل من طرف حركة النهضة في توضيح عملية الفصل بين الدعوي والسياسي، لا ينفي وجود تحولات شهدتها الحركة في مستوى التنظيم والمشروع. فالحركة التي انطلقت منذ السبعينيات في مشروع تقويض الدولة القائمة واستبدال الدولة الإسلامية بها، وصولاً إلى الاستيعاب الكامل لمشروع الدولة القُطرية الوطنية، من جماعة دينية سياسية كامتداد لتيار إخواني إلى حزب سياسي ذي هموم محلية، ومن جماعة مغلقة تعتمد على النقاء الأيديولوجي إلى حزب مفتوح يبحث عن مكاسب انتخابية[3].
فالدرس الذي تعلمته حركة النهضة بعد عودتها إلى النشاط ودخولها إلى كواليس السلطة، كي لا يقع لها ما وقع في الماضي من إقصاء وملاحقة، هو انخراطها ضمن المصالح المشتركة للطبقة الحاكمة، بدلاً من محاولة إنهاء أو إلغاء هذه الطبقة والحلول مكانها، كما كانت تفكر في سنوات التأسيس وما بعدها. فقد تحول مشروع الحركة من «محاربة الدولة» إلى «التمتع بها» والاستفادة من مروحة عريضة من الامتيازات والمصالح. الأمر الذي جعلها تعدل من برنامجها. فبعد عقد التسعينيات انهارت المشاريع الكبرى للحركة الإسلامية عالمياً. لم تعد مشاريع كالخلافة أو الشريعة أو المجتمع المسلم مهمة، كأهمية اندراج الإسلاميين ضمن نسيج الطبقة الحاكمة، عبر تجذير الوجود الاقتصادي للحركة في المجتمع. لقد استفاد الإسلاميون من نمو القطاع الخدمي في مقابل أزمة الفلاحة والصناعة، في بناء شبكة أنشطة اقتصادية مرنة واستفادوا أكثر من الرساميل الخارجية التي تدفقت وما زالت من “أصدقائهم وحلفائهم في الخارج” ومشاريعهم السابقة في الخارج. لم يكن توافق عام 2014 مع حركة نداء تونس، التي تمثل في جزء منها الطبقة الحاكمة التقليدية التونسية، إلا جزءاً من مشروع الحركة الإسلامية للاندماج في شبكة المصالح المشتركة للطبقة الحاكمة. حيث لم يعد ارتباطها بهذه الطبقة مجرد تحالف سياسي، بل مروحة واسعة من التحالفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيروقراطية العميقة[4].
فخلال خمس سنوات من نظام “التوافقية السياسية” مع حركة نداء تونس والباجي قائد السبسي، نجحت حركة النهضة في بناء شبكة مصالح اقتصادية واسعة وعميقة. كما أن طبقة من البرجوازية الإسلامية في طور التشكل، أو تشكلت، وتسيطر على مجال نفوذ كبير داخل الحركة. بالتوازي مع إعلانها فصل الديني عن السياسي تُمتن الحركة الروابط بين الديني والاقتصادي. إن نهاية الإسلام السياسي الذي بدأ في تونس احتجاجياً منذ نهاية الستينيات، لا تعني أبداً، نهاية السياسي، بل إعادة تسييس الديني على أسس نيو ليبرالية أو ما يسميه باتريك هاني بإسلام السوق[5]. فلم يعد همّ الإسلامي التونسي أن يقدم نفسه كورع بقدر ما يهمه كثيراً أن يقدم نفسه كناجح، حيث يموت وهم “الخلاص الإسلامي” ويتوارى بعيداً أمام صعود “نفعية إسلامية” جامحة.
بيد أن هذه النفعية الصاعدة والتحولات التي شهدتها الحركة الإسلاموية خلال عشر سنوات من حكمها البلاد لم تغير من حقيقة أن الحركة فشلت في الحكم، من حيث مؤشرات التنمية والوضع الاقتصادي والاجتماعي، قياساً بالشعارات التي كانت ترفعها قبل عام 2010 مقارنة بالآمال التي وضعها عليها أنصارها وقطاع واسع من الشعب خلال الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الثورة. بل إن الوضع في البلاد قد تدهور أكثر مما كان عليه قبل الثورة، وبدأ تيار واسع من التونسيين ينجرفون بالحنين إلى نظام ابن علي، وقد تجلى ذلك في الصعود القوي للحزب الحر الدستوري وريث حزب التجمع الحاكم. وفيما كان كل شيء ينهار في البلاد، كانت قيادات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي يلوحون بوجود المؤامرات الخارجية دون الالتفات قليلاً إلى الوضع الداخلي. وبموازاة ذلك كانت الحركة الإسلامية تعاني داخلياً من حالة من الانهيار التنظيمي المديد من خلال سيل جارف من الاستقالات في قيادة الصف الأول والثاني، في مقابل سيطرة دائرة ضيقة من عائلة الغنوشي على سلطة القرار.
فقد أكدت الحركة طيلة السنوات الماضية أنها لا تصلح للحكم، تبعا لفقرها من البرامج، مما جعلها تعيد إنتاج مناويل التنمية التي انتفض ضدها الشعب عام 2011. لا تصلح الحركة للحكم لأنها تعرف الديمقراطية بوصفها نتائج اقتراع ومنافع حكم، وتعرف الشرعية على أنها مناصب ومنطلق تمكين، وتركن دائما إلى تبرير فشلها بالمؤامرات والمكائد الداخلية والإقليمية والدولية، وعندما استوفت كل مبرراتها وقفت وحيدة أمام الشعب الذي يركل كل من يدير ظهره لانتظاراته.
***
أخيراً، يبدو أن آثار ما حدث في 25 يوليو (تموز) من تحول جذري للأوضاع في تونس نحو عزل حركة النهضة عن السلطة من خلال تجميد المجلس النيابي وإقالة الحكومة، ستكون له تداعيات عميقة على الحركة الإسلاموية التونسية، التي لن تستطيع العودة إلى مستوى القوة الذي كانت عليه قبل ذلك التاريخ في المدى القريب والمتوسط، حيث خسرت الكثير من نفوذها داخل الدولة وداخل المجتمع، وقد بدا واضحاً أن عشر سنوات من الحكم قد أفقدت الحركة قاعدتها الشعبية، حتى إن الغنوشي عندما أطلق نداءً لأنصاره كي ينزلوا للشارع ويعتصموا أمام البرلمان ضد قرار الرئيس قيس سعيد لم يستجب له أحد، واضطر في النهاية إلى الدعوة إلى التهدئة والانسحاب من محيط مجلس النواب. فالسويعات الفاصلة بين وقوف الغنوشي على أسوار البرلمان، وبين إعلانه الانسحاب ورفع الاعتصام المزمع تنفيذه، كانت سويعات كثيفة بالدلالات. كانت تعني أولا أن الحركة الإخوانية أصبحت عاجزة عن التحشيد والتعبئة، وتعني أيضا أن النهضة التي حاولت -جاهدة- استدرار خطاب المظلومية ودور الضحية، وكان الشيخ وصحبه وقناة الجزيرة يراهنون على عنف أمني أو عسكري يوجه ضدهم، بما يتيح لهم صنع مشهد يسوّغُ التضليل السياسي والفكري الذي مارسوه طيلة اليوم السابق، ومفاده أن ما حصل يوم 25 يوليو (تموز) كان “انقلابا”. المفارقة أن العنف لم يصدر عن الجيش أو عن الأمن، بل صدر من الشعب. صورة زادت من تجسيد عزلة النهضة عن الشعب التونسي، وهي صورة بدأت من احتجاجات الأحد التي صوبت عنفها رأسا نحو مقرات النهضة -وفي ذلك أن الشعب اعتبر أن النهضة تختصر المنظومة الحاكمة- وازدادت وضوحا من الاحتفالات التي انطلقت بعد إعلان سعيد قراراته.
[1] – راشد الغنوشي، تونس من الثورة إلى الدستور، مقابلة أجراها معه صلاح الدين الجورشي، مجلة سياسات عربية، العدد (18)، يناير (كانون الثاني) 2016.
[2] – اللائحة التقييمية لحركة النهضة الصادرة في المؤتمر العاشر 20 -23 مايو (أيار) 2016.
[3] – أحمد نظيف، مراجعات النهضة التونسية؛ تحول مبدئي أم التفاف على مصاعب المرحلة؟
[4] – أحمد نظيف، الإسلاميون ومنافاة الدولة، الكتاب (156)، مركز المسبار للدراسات ، ديسمبر (كانون الأول) 2019.
[5] – باتريك هاني، إسلام السوق، ترجمة: عومرية سلطاني، مركز مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، 2015.